سأتخلّى عن سمّاعاتي: مُذكّرات جنس أطرش
"زْزْزْزْزْتْ"... هذا هو صوت الآلتين في أذنيّ. عادة لا تصفّران بشكل متوازٍ، أي تصفّر إحداهما وتهدأ الأخرى. تصفّر سمّاعاتي كلّما لامست شفتان شحمتي أذنيّ، أو مرّر أحدهم يدَهُ على الجهة الجانبية من شعري.
"ززززت"، هذا صَفير سمّاعاتي المُزعج. في كلّ مرّة يقطع انسجامنا، حتّى صار تماهينا في لحظة ساكنة واحدة أمرًا مُستحيلا. رُبّما يُذكّركُم هذا الصوت بتلك اللّحظات على
أنا امرأة في الثامنة والعشرين من عمري، فقدت أكثر من ثمانين بالمائة من حاسّة السمع حين كنتُ في الثالثة عشر. كنت فتاة حادّة السمع، فطنة، شديدة الفضول، كثيرة الحديث، رشيقة الحركة. كنت أزاول دروس بيانو أسبوعية في معهد الموسيقى، وأغنّي كلّما أتيحت لي الفرصة، تحت الدوش، ومع الأصدقاء، وفي الحفلات العائلية، وفي الطريق إلى المدرسة. لم تستطع أمّي تقبّل طرشي الذي منعني من مواصلة دروس الموسيقى، وإلى اليوم وبعد سنوات من التردّد على عيادات كبار الأطبّاء وفي جميع الاختصاصات، تعتبر ما أصابني لعنة خارقة من لعنات الشرّ أو فعلا من أفعال السحر الأسود. كانت تبكي بحرقة في كلّ مرّة نزور فيها طبيبًا أو روحانيًّا. قرّرتُ أن أضع حدًّا لنوبات نحيبها الهستيريّ ولخوفها المرضيّ عليّ بالتسجيل بكليّة بعيدة جدًّا عن مقرّ إقامتنا.
"زْزْزْزْزْتْ"... هذا هو صوت الآلتين في أذنيّ. عادة لا تصفّران بشكل متوازٍ، أي تصفّر إحداهما وتهدأ الأخرى. تصفّر سمّاعاتي كلّما لامست شفتان شحمة أذني، أو مرّر أحدهم يدَهُ على الجهة الجانبية من شعري. مثلُ هذه الحركات الرومانسيّة لا تناسبني، قد تعبّر عن مشاعر صادقة أو رغبة جامحة، لكنّها تتحوّل معي إلى لحظات سمجة وغير مريحة. يعرفني الناس كشخص أخرق، كثير الحركة لا يعرف الهدوء. لكنّ الحقيقة عكس ذلك تمامًا. هذه صفات اكتسبتها بسبب إعاقتي السمعيّة. أفقد التركيز بسرعة في المجالس المزدحمة، أتكلّم كثيرًا، أقاطع حديث الآخرين، وأشعر بالتعب مع أشخاص لم أتعوّد على أصواتهم أو أسلوبهم في التعبير. أغلب مواعيدي الأولى لا تكون ناجحة، فإمّا أقاطع الحديث عندما أعجز عن التركيز أو أثرثر. لنقل إنّ أفضل مواعيدي الغرامية، أو بالأحرى، أكثرها راحة هي تلك التي أسرف فيها في الشرب. الخمر طريقنا السريع والمختصر نحو السرير.
تحوّلت تفسيراتي التقنيّة الجافّة عن سمّاعاتي إلى فقرة قارّة خلال لقاءاتي الحميميّة. "آمل ألاّ يكون قد أزعجك هذا الصوت"، مع وجه متفاجئ. "حاول ألاّ تلمس أذنيّ باستمرار حتى تتفادى هذا الصوت"، مع وجه معتذر. "هذا الصوت ينبّه بخطر محدّق"، مع ضحكة شيطنة مفتعلة لتجاوز الإحراج. لا يعني هذا أنّي لم أصادف أحبّة متفهّمين للموضوع. لكن الأمر لم يتعلّق بتاتًا لا بالتفهّم ولا باللطف ولا بالشفقة على وجه الخصوص، ولم أظن يومًا أن شخصًا غيري يُمكن أن يفهمني ويفكّ شيفرات لمساتي وحركاتي. كلّ ما أحاول فعله من خلال هذه الأسطر هو أن أسرد، بعفوية مطلقة، تمثّلاتي الخاصّة لصفير السمّاعات في ساعات الليل الأكثر حميمية. فأنا التي تتعايش مع هذه الإعاقة منذ سنين، رافقت خلالها سمّاعاتي كلّ ذكرياتي، تُسجّلان تنهّداتي وصراخي وأزيز الفراش وأنّات آلام الحيض وتأوّهات النشوة وخيباتي المُتكرّرة.
صارحني بعض أصدقائي إثر ظهور تلفزي قصير لي مؤخّرًا بأنّي أكثرت من تحريك يديّ، لم أخبرهم أني أفعل ذلك دون هوادة، في الفراش أيضًا. فلا تستغربوا قولي أني أؤمن يقينًا بأنّ للأيدي لغتها الخاصّة، نستعملها أثناء الجنس أيضًا. أهتمّ كثيرًا للطريقة التي يعبّر بها شريكي بيديه. في السرير، أميل على جانبي، أضع خدّي الأيمن فوق يده اليسرى، إذ يمنعه ذلك من تحريكها فأتسلّم زمام الأمور. أمّرر أصابعي على وجهه في حركات مستديرة. أتحسس برفق شديد حاجبيه وأنفه وأخفض رأسي نحو شفتيه. أتوقّف قليلا، ثمّ أرفع يديّ لأقول كل ما يعجز لساني عن قوله. لا أجزم أنّ هذا حكرٌ على ذوي الإعاقة. كلّ ما أحاول الوصول إليه هو أنّ الإعاقة تطوّر لدى أصحابها أشكالا خاصّة للتواصل. وهي استثنائية ومرهفة، أو هذا ما أعتقده على الأقلّ.
أذكر كلّ المواقف المُحرجة التي مررت بها ولكنّ أكثرها حدّة كان منذ أشهر قليلة، عندما اتّصلت بي والدتي في الخامسة فجرًا. نوبة هلع روتينيّة أرّقتها وزاد الشيطان من وسوسته فاتّصلت بي باكية، صوتها مُختنق وسألتني إن كان بجانبي أحد. لم أكن أنا بالتأكيد من تفطّن لرنين الهاتف. ينام بجانبي شريكي الذي أيقظني مذعورًا، فرفعت سمّاعة الهاتف دون تفكير. حينها بادرت أمّي بالسؤال: "كيف تمكّنت من سماع الهاتف في هذا الوقت المتأخّر؟ من معك؟". كشفت هذه الحادثة رغم تفاهتها الحكاية برمّتها. تعرف أمّي جيّدًا أني أضع سمّاعاتي جانبا أثناء النوم، وأنّه لا يُمكنني سماع شيء دونها. أفكّر دائمًا في الطفل الذي قد أنجبه يوما ما، كيف سأسمع بكاءه عندما يجوع أواخر الليل أو في ساعات الفجر الأولى.
"هل أنت بخير؟"، أسأل هذا السؤال كلّما وصل شريكي إلى ذروة النشوة الجنسيّة. سماع إجابته بصوت واضح يُطمئنُني. لا أستطيع أن أمارس الجنس دون سمّاعاتي لأنّي أحبّ أن أسيطر على كلّ شيء. أحتاج أن أميّز صوت جسده وهو يحتكّ بجسدي، وصوت أنفاسه المُتدرّجة، وصوت يدي تتخلّل شعره وصوت يدي الأخرى تحفر بأظافرها على الجانب الخلفي من كتفه. أراقب بهوس صوت السرير حتى لا نزعج غيرنا، وصوت الهاتف حين يهتزّ على كلّ مستجدّات الفايسبوك، وصوت الجيران الصاخبين من بعيد، وحتى صوت قطرات الماء المعلّقة بصنبور المرحاض.
المرّة الوحيدة التي تخلّصت فيها من سمّاعاتي كانت مع حبيبي. نعم، حبيبي الذي سمحت لي التجربة بأن أذهب معه بعيدًا بمشاعري. ففي أحد الأيّام، ودون أي سبب جلل يُذكر، قرّرت نزعهما والتخلّص من هوسي بالتحكّم في الأمور. كان شعورًا رائعًا. لم تسيطر عليّ الأصوات الصاخبة من حولي، ولم يفقدني أزيز السرير تركيزي ولم أنفعل لعدم تصاعد صوت أنفاسه بقدر تصاعد صوت أنفاسي، كما لم أعقّب على كلّ حركة زائدة. استسلمت كليًّا إلى الصمت الذي أحرِم نفسي منه.
إنّه الانعتاق الذي يمنحنا مساحات أرحب للمتعة والحبّ. إنّه الانعتاق من سطوة الأصوات وعناق أبديّ للهدوء.






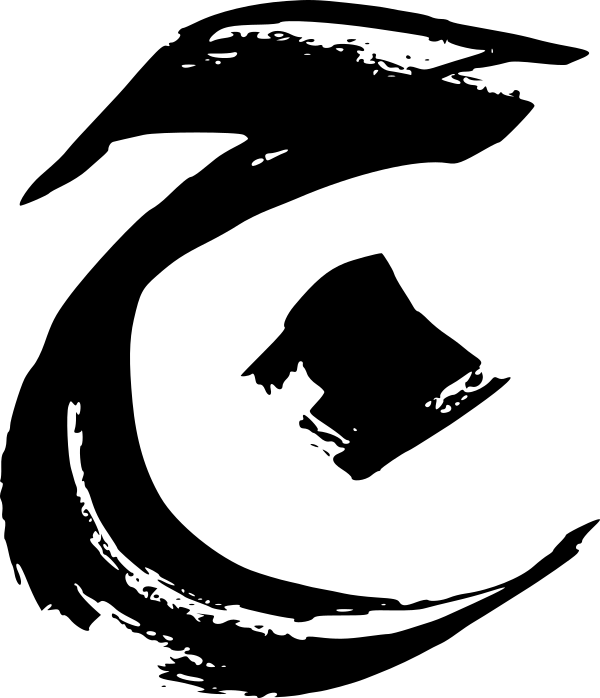


Kommentare