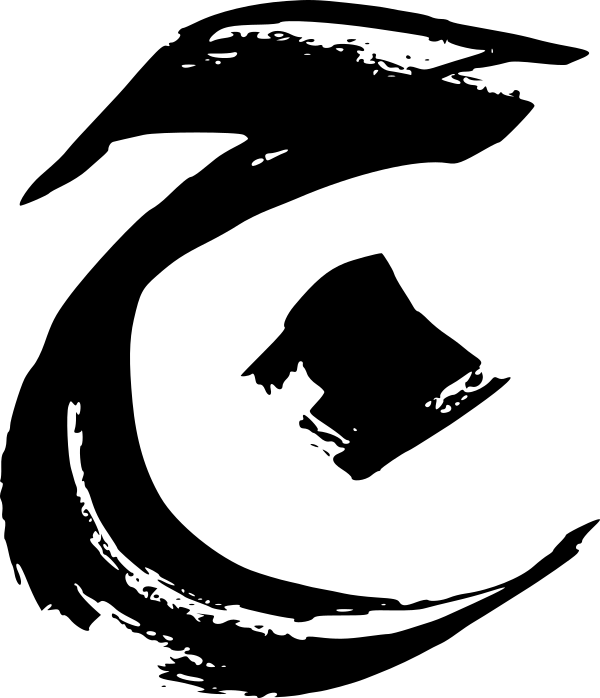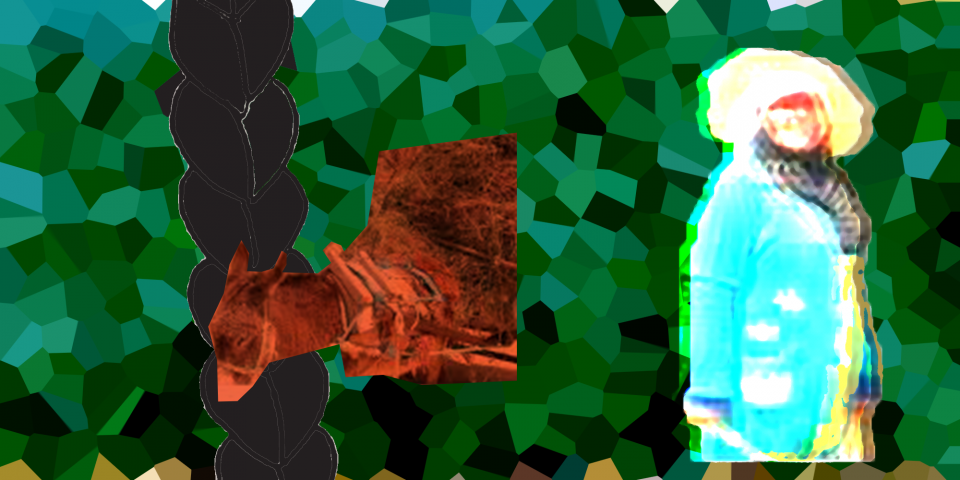
الريف التونسي: عالم تَحرسه الضفائر في زمن الهجرة الرجالية!
في زمن هجرة رجاليّة مكثّفة نحو الحواضر والوظائف المُريحة، تتجلّى المرأة الريفية كآلهة قديمة، تحمِل الريف على أكتافها وتَهِبه الحياة والخصوبة على حساب كرامتها ومصالحها الخاصة.
في عصر تدفق موجات الهجرة من الهوامش الريفية إلى المراكز الحضرية بحثًا عن العمل والمال، يُواجه الريف التونسي محنة الفراغ والتخلي، ويبحث عن خصوبته بعد أن تعاقبت عليه مواسم النسيان ورحيل الأجيال الجديدة. هذا العالم الذي يحضر دائمًا في المِخيال المَدِيني، كاستمرارية رمزية للسكينة والبساطة والأخلاق العتيقة، تعيش قواه الاجتماعية تشظّيًا وتحوّلا في الأدوار والمواقع، ويخوض معركته الخاصة من أجل البقاء على وقع كفاحيّة نسائيّة ذات دلالات عميقة ومؤلمة في ذات الوقت.
في زمن هجرة رجاليّة مكثّفة نحو الحواضر والوظائف المُريحة، تتجلّى المرأة الريفية كآلهة قديمة، تحمِل الريف على أكتافها وتَهِبه الحياة والخصوبة على حساب كرامتها ومصالحها الخاصة. لقد باتت قوة العمل الريفية في تونس متشكلة أساسًا من العاملات الريفيات، إذ تشير إحصائية تابعة للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري إلى ارتفاع نسبة الفلاحين المتخلين عن ممارسة النشاط الفلاحي، حيث بلغ عددهم 12 ألف فلاح سنة 2018 1. هذا الانهيار المستمر لقوى الإنتاج الريفية تتحمّله عاملات الريف، رغم ما يتضمنه من إدامة لمقوّمات التهميش والحرمان والهيمنة الذكورية.
في السنوات الأخيرة اتّخذ هذا العبء الاجتماعي الجديد شكلا تراجيديًا، جسّدته مشاهد الموت المؤلمة لعاملات فلاحيات وهنّ في طريقهن إلى الحقول والمزارع، وقد شهد شهر
الأرض ومحنة الاغتراب
العاملات الفلاحيات هنّ في نهاية المطاف جزء من تلك الفئة التي نطلق عليها "الفلاحين الفقراء"، أولئك الذين لا يملكون أرضًا فلاحيّة تؤمّن لهم معاشهم اليومي في بلد يستأثر فيه المستثمرون وكبار الملّاكين العقاريّين بمعظم الأراضي الفلاحية، في حين أن "80 بالمائة من الفلاحين لا يملكون سوى 960 ألف هكتار بمعدل مساحة لا تتجاوز 2.5 هكتار للفلاح الواحد"2. هذا التوزيع اللاّعادل للأرض ليس حقيقة قدَرية مرتبطة بتاريخ الملكية الخاصة في تونس، وإنما واقع اجتماعي ساهمت في تكريسه السلطة منذ فترة ما بعد-الاستعمار من خلال الإقطاعات الفلاحية والأراضي الخصبة التي منحتها للمُوالين والمُقربين، ثم شروعها منذ بداية السبعينات إلى اليوم في مشروع الخوصصة الفلاحية عبر إسناد الأراضي الدولية (ملكيات تابعة للدولة التونسية) إلى شركات الاستثمار الخاصة3.
هذا الواقع أحَالَ الكثير من الفلاحين الصغار إلى أُجراء لدى المالكين الجدد، وإزاء استقرار منظومة الهيمنة الربحية الخاصة وارتباطها هيكليًا بمؤسسات الحكم والدولة عجز الكثير منهم عن مقاومة هذه الآلة، إما بسبب موسمية العمل الفلاحي أو بسبب عجزهم عن تأمين الحياة لملكياتهم الصغيرة نظرًا إلى اختلال شروط المنافسة. وشيئا فشيئا تحوّل جزء كبير من صغار الفلاحين إلى جيش احتياط للعمل في المدينة، ومن هنا برزت العاملة الفلاحية كفاعل جديد ومكافح من أجل تأمين لقمة العيش في ظل غياب الرجل، وقد وفّر حضورها الملفت للانتباه فرصة ثمينة للمستثمرين وكبار الملّاكين من أجل تأمين أرباح إضافية، عبر الاستفادة من يد عاملة نسائية متوفرة و"رخيصة" في ذات الوقت.
استغلال مُقنّع بوهم "التفوق الفيزيولوجي" للرجل
كان حضور المرأة الريفية العاملة في الفترة السابقة (على الأقل إلى حدود الثمانينيات) مرتبطًا بدورها المساعد للرجل، سواء في الفلاحة العائلية المَعاشية أو مرافقته في مواسم الجني والحصاد، وعادة ما تُسند إليها أعمال "وضيعة" مثل تنظيف مرابض الحيوانات أو إجهاد النفس في التقاط بقايا الثمار التي يخلّفها الرجال (على غرار موسم جني الزيتون). ولكن يبدو أن مياهًا كثيرة جرت تحت الجسر كما يقال، فقد أصبحت المرأة عاملة أجيرة تُقدّم بنفسها خدمات فلاحية متنوعة، تضاهي وتفُوق في الكثير من الأحيان ما كان يقوم به الرجال. وفي هذا السياق تشير دراسة أنجزتها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات سنة 2014 حول ظروف العمل الفلاحي للنساء في الوسط الريفي إلى أن العاملات الفلاحيات المستجوَبات في الدراسة يمتهنّ أعمالا شاقة ومتنوعة من بينها؛ الجني، والبذر، واقتلاع الطفيليات، وحمل المحصول والحرث في بعض الأحيان4.
هذا التحول في التقسيم الجنسي للعمل لم يُوازيه تحوّل على مستوى التمثّلات الاجتماعية والثقافية، فقد ظلت النظرة الدونية للمرأة مُتحكمة في العلاقات الشغلية والاجتماعية بشكل عام، إذ تفيد الدراسة المشار إليها أعلاه أن 89 بالمائة من النساء المستجوَبات يتقاضين أجورًا تتراوح بين 10 و15 دينار تونسي (تقريبًا بين 3 و4.6 يورو) وهو أجر متدنٍّ مقارنة بالجهود المبذولة لأكثر من 8 ساعات في اليوم ومقارنة بما يتقاضاه نظرائهنّ من الرجال. هذا المَيز المهني ينهل مبرراته الثقافية من تصوّر ذكوري قديم ودائم الفعالية، يسعى إلى تجذير الهيمنة باسم تفوق أصليّ وجوهرانيّ للرجل على المرأة على مستوى البنية الجسدية. يصف عالم الاجتماع الفرنسي بيار بورديو هذه النظرة قائلا "إن القوة الخاصة لتبرير النظام الاجتماعي الذكوري إنما تأتيه من أنه يراكم ويكثف عمليتين: إنه يشرعن علاقة هيمنة من خلال تأصيلها في طبيعة بيولوجية هي نفسها بناء اجتماعي مُطبّع"5. هذا التمثل الثقافي الهيمَني التقطته آلة الاستثمار الفلاحي لتبرير مصالحها وأرباحها، منتجة بذلك شبكة من الوسطاء والسماسرة الذين يشكلون حلقة الربط بين العاملات والمستثمرين وكبار الملّاكين، وتتحكم هذه الحلقة في طريقة سداد الأجور وتفصل من تريد فصله وتُهين من تريد إهانته، مكرّسة بذلك وضعية "تعاقد لا قانوني" ولا إنساني بين العاملات الفلاحيات ومُشغّليهن المباشرين، وقد أكدت الكثير من المُستجوبات في الدراسة التي أجرتها الجمعية التونسيات للنساء الديمقراطيات أنهنّ يتعرضن للعنف اللفظي والتحرش والابتزاز من قبل الوسطاء والناقلين في الكثير من الأحيان.
العاملة الريفية و"هامش الهامش"
يعتبر الريف التونسي فضاءً هامشيَّا رغم ما يكتنزه من موارد طبيعية وما تبذله قواه المُنتِجة من تضحيات مادية ومعنوية. وهذا الهامش المَسلوب والمستنزَف من قبل مراكز النفوذ يُنتج أيضًا مُهمّشيه وضحاياه. طيلة رحلة حياة يطبعها الشقاء والمهالك، لا ترث العاملة الريفية سوى أمراضها وخدوشها وأوجاع الزمان، "آلام في الساقين والظهر" و"حروق" و"روماتيزم" و"سكري" و"مشاكل في التنفس والنظر" و"إجهاض" و"تعب مُزمن" وسلسلة طويلة من الآلام المكتومة والمدسوسة مثل الأسرار، حتى لا يغضب المُشغّلون والأزواج. في المُحصّلة تقع حياة العاملة الريفية على "هامش الهامش"، تحضر في الخطاب الرسمي من خلال تصوّر "ضحياتي" موسمي، يكرّس واقع التهميش والحيف ولا يُزِيحه، لأن بنية السلطة في حد ذاتها تنتج اللاّعدالة واللاّمساواة من خلال تمثيلها السياسي لمصالح أقلية اجتماعية تحتكر الأرض والثروة، ولعل الإجراء الحكومي الأخير الذي دعا العاملات الفلاحيات إلى الانخراط الطوعي في منظومة الضمان الاجتماعي عبر تطبيقة "احميني" -كردة فعل تسكينية على الوفاة المؤلمة لعاملات فلاحيات- يعكس هذا الانحياز السلطوي، لأنه يُخلي مسؤولية المُشغِّلين ولا يُلزِمهم بتوفير أجور محترمة وضمان عقود مهنيّة تتوفر على التأمين من حوادث الشغل والحماية الصحية.
أما التمثّل الثقافي المركزي، بما يحمله من معياريّة اجتماعية وأخلاقية وجمالية، ظل ينظر إلى العاملة الريفية كرمز للقوة الجسدية والمحافظة والخجل البدائي، وطالما أنها تنتمي لجمالية إنسانية مُغايرة لجمالية السّوق والتسوق، تحضر المرأة الريفية في المخيال الاجتماعي المهيمِن عبر تشبيهات ورموز ذكورية، فهي امرأة "ﭬَدْعَة" (قوية البنية) و"خِير مِن زُوزْ رْجَالْ" (أفضل من رجلين)، وغيرها من الاستعارات التي تسحق فرادَتَها وأصالتها كامرأة قبل كل شيء. ورغم الانفتاح الحقوقي والسياسي الذي أصبح يميز الحياة العامة في تونس فإن المرأة الريفية بشكل عام ظلت خارج أفضِيَة الفعل السياسي، رغم خطابات المناصرة والتأييد التي تتبناها بعض المنظمات الحقوقية والنسوية، ويحكم هذا التأييد رؤية سياسية مركزية لا تشتغل في أفق التفكير في مشاريع ثقافية وسياسية تجعل من الطاقة النسائية الريفية قُوّة تنظّم ومقاومة جديدة لمنظومة الهيمنة السائدة. وفي الأثناء يُشير الواقع إلى انبثاق حركة نسوية آتية من الهوامش، جنينية ومتعثرة ومُحاصَرة ولكنها تحمل دلالات عميقة نحو المستقبل، على غرار "حركة مانيش ساكتة" (لن أصمت) التي انطلقت منذ سنة 2017، من منطقة منزل بوزيان التابعة لولاية سيدي بوزيد -المنطقة التي انطلقت منها الثورة التونسية-، ورغم أن هذه الحركة تضم في صفوفها صاحبات شهادات عليا إلا أنها نجحت في الانفتاح على محيطها المحلي والتعبير عن تطلعات العاملات الفلاحيات على قاعدة المطالبة بالكرامة والشغل اللائق والمشاركة في الحياة العامة. ورغم التشويه والعنف السلطوي الذي طال هذه الحركة فإنها عكست في نهاية المطاف حركية نسائية داخل مجتمع هامشي "يتميز بالعطوبة الاقتصادية والاجتماعية وبهيمنة البُنى الثقافية التقليدية"6.
رغم كل مقوّمات التهميش الثقافي والسياسي والاقتصادي المذكور، فإن العاملة الريفية تقف صامدة في مناطق الغُبار والوَحل، تهِب بريقها ونضارتها للشمس والزمان. تقف بين طرفي الإعياء والانتصار؛ أعيتها أزمنة الهيمنة واللاّاعتراف، ولكنها انتصرت على أسطورة التفوّق البيولوجي للرجل وأثبتت تَماثلها الكفاحي مع الأرض والطبيعة. ورغم انسداد بدائل التغيير وضبابيتها فإن العاملة الريفية باتت جزءًا من المعادلة الاقتصادية ولم يعد بالإمكان تجاهلها، لأنها المنتجة الحقيقية للغذاء إلى جانب عدد من صغار ومتوسطي الفلاحين الذين لم يتخلوّا عن أراضيهم، ويكافحون ضد منظومة الاستنزاف العشوائي لمقدّرات الريف وموارده.
- 1. دراسة لمجموعة العمل من أجل السيادة الغذائية: غذاؤنا، فلاحتنا، سيادتنا (تحليل للسياسات الفلاحية التونسية على ضوء مفهوم السيادة الغذائية)، تونس، جوان/يونيو 2019.
- 2. دراسة لمجموعة العمل من أجل السيادة الغذائية: غذاؤنا، فلاحتنا، سيادتنا (تحليل للسياسات الفلاحية التونسية على ضوء مفهوم السيادة الغذائية)، تونس، جوان/يونيو 2019.
- 3. ياسين النابلي. ملف الأراضي الدولية: الدولة تمنح الأرض لمن ينهبها، تونس، موقع نواة، سبتمبر 2016.
- 4. الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات. دراسة حول ظروف العمل الفلاحي للنساء في الوسط الريفي، تونس، 2014.
- 5. بيار، بورديو. الهيمنة الذكورية (ترجمة سلمان قعفراني)، ط1، بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2009.
- 6. شيماء همامي. النضال النسوي في الهامش: حركة "مانيش ساكتة" أنموذجا (ضمن مؤلف جماعي: في سوسيولوجيا الاحتجاج والتنظم السياسي لدى الشباب التونسي)، منظمة راج تونس، سبتمبر 2018.