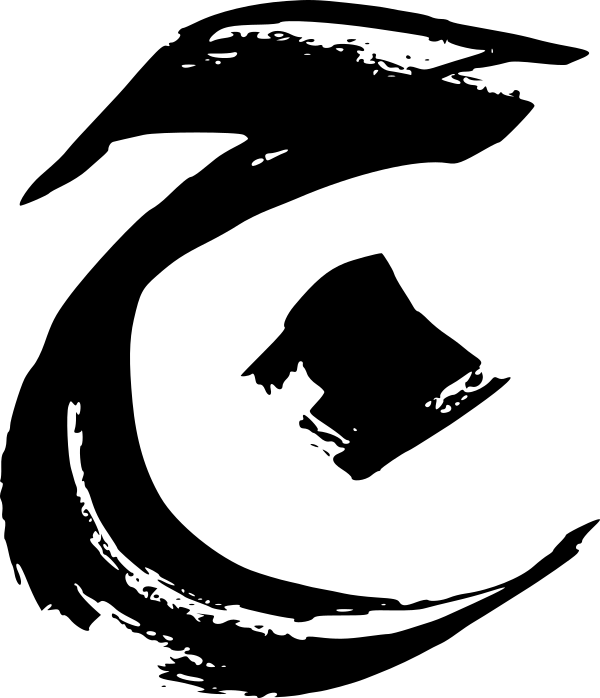جنسيتي الممنوعة عني: العنصرية في "المجاملة" و"الاسترحام"
قضيتُ مؤخرًا أسبوعًا كاملًا في اسطنبول في عطلةٍ مع عائلة أمي. عند ركوبي أوّل حافلة، تكلّمَت خالتي باللغة العربية بصوتٍ مسموعٍ وبثقةٍ تامة. خفتُ من أن يتعرّض لنا أحد الركاب لأنّ العربية غير مستحبّةٍ في تركيا.
خبّأتُ رأسي في السمّاعتَين الكبيرتَين اللتَين أضعهما على أذنيّ معظم الوقت من دون أن أشغّل أي صوت، لمجرّد أنهما تمسكان برأسي وتُشعرانني بالأمان، إذ تحميانني من أي تدخّلٍ خارجي.
طول المسافات في هذه المدينة يتيح لك فرصة التفكير بأيّ أمرٍ كان. رحتُ أسأل نفسي: "متى كانت آخر مرةٍ تكلّمتُ فيها في المواصلات بصوتٍ مسموع؟ متى كانت آخر مرةٍ أجبتُ على هاتفي في الزحام؟ لماذا تتكلم خالتي بالعربية بكلّ هذه الثقة؟ هل حياتها المحميّة بالقوانين في كندا أعطَتها هذا الصوت المرتفع؟"
من انتزع صوتي مني؟ ومتى انتُزع مني؟
انفصال والدَيّ في صغري جعل السفر إلى لبنان مرتَين في السنة أمرًا لا بد منه لقضاء الوقت مع والدتي اللبنانية وعائلتها. أذكر أنني كنتُ أطلب من والدتي أن "تعطيني أوراقها"، فكانت تجيب دائمًا: "ما فيني. ما بيطلعلكن الجنسية هون. القانون ما بيسمح" ("لا أستطيع. لا تستطيعون الحصول على الجنسية هنا. القانون لا يسمح لنا".) في الحقيقة، كنتُ أعتقد الأمر تخاذلًا من والدتي لأنها لا تريد الغوص في معمعة المعاملات الرسمية. لم يستطع عقلي فهم جملة "القانون لا يسمح لنا"، في وقت كانت هويتي السورية من جهة أبي مصدرًا للعار والرعب. ففي لبنان، لطالما توجّه الناس إليّ بالحديث: "إنتو السوريّين قتلتونا".
ما هذا العبء الذي تحمله طفلةٌ صغيرةٌ لم تكن قد وُلدَت بعد آنذاك؟
منذ صغري، كنتُ أكره لبنان وأرفضه، في ردّ فعلٍ على معاملتي دومًا كغريبة. كنتُ أحمي نفسي من خلال رفضه، وأنا أعرف في قرارة نفسي أنه لم يقبل وجودي يومًا… إلى أن جاء تفجير مرفأ بيروت في 4 آب 2020. أذكر يومها غضبي ودموعي وأنا أتابع الأخبار وارتفاع عدد الضحايا، شعورٌ ألفتُه منذ مجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية.1 في 4 آب 2020، عرفتُ أنّ لبنان جزءٌ مني بالرغم من أنه لا يعترف بي قانونيًا، ولا أملك من أوراقه سوى إقامة مجاملة،2 تلك الورقة التي تُمنح من باب "المسايرة"، لِمَن لا حق له أو لها. لكن كيف يمكن "المجاملة" بالحقّ؟ الحق بالجنسية أحد حقوق الإنسان الأساسية.
***************
على شباك الأمن العام في مطار رفيق الحريري في بيروت، يبدأ حواري المعهود مع عنصر الأمن.
- شو يا سارة؟ جايه لعنّا؟ ليكي طلعِت أمك لبنانية، بس مبيّن عليكي شكلِك مش سوري . مبيّن فيكي شلش من عنا.
أبتسم ابتسامتي البلهاء. أتساءل: كيف يكون شكل السوري؟ هل له يدٌ ثالثةٌ في منتصف رأسه مثلًا؟
يقاطع عنصر الأمن تخيّلاتي:
- تذكّري يا سارة، إلك حق تتخطي مدّة الإقامة بس 15 يوم. لهيك، روحي جدّدي إقامتك خلال هالفترة. بس عالأغلب ما رح تلحقي لأنه في عطلة عيد الفطر. إنتي وحظك.
- طيب، وإذا ما لحّقت؟
- هون يا سارة بصير عليكي منع دخولٍ لسنة، وبصير لازم أمك تعمل طلب استرحام.
لم أفهم، فشرح لي أنه في حال منعي من دخول البلاد، يتوجّب على والدتي تقديم طلب استرحامٍ كي تراني، فيُعفى عني كي أستطيع دخول بلدها وزيارتها.
في الاسترحام هذا، لا أرى إلّا الذل والإهانة. لماذا يجب على أمّي أن تطلب الرحمة؟ ما هو الذنب الذي ارتكبَته؟ هل يطلب الرجل اللبناني المتزوج من امرأةٍ غير لبنانيةٍ استرحامًا في حالةٍ مماثلة؟ لا طبعًا، لأنّه يستطيع منح الجنسية لزوجته وأولاده.
لا أذكر عدد المرّات التي تلاسنتُ فيها مع ضباط الأمن العام في المطار وأخبرتهم بأنّ والدتي لبنانية، وليس من حقهم منعي من دخول البلد ومغادرته. ولا أذكر عدد المرات التي طليتُ بها وجهي بكل أنواع المكياج، وارتديتُ الثياب الفاخرة ظنًا مني أنّي قد أتجنبُ التشبّه بالصورة النمطية للفتاة السورية في ذهن ضباط أمن المطار، والمخاطر التي قد أتعرض لها لمجرّد أنني سورية. كما لا أذكر عدد المرات التي تجادلتُ فيها مع الضباط وأنا أسألهم بكل ما أملك من لامبالاة: "طيّب ليه ما بتجنّسونا وبترتاحوا وبتريّحونا من هالوراق والقوانين؟" ("لماذا لا تمنحوننا الجنسية فترتاحون وتريحوننا من هذه الأوراق والقوانين؟")
في المرة الأخيرة التي طرحتُ فيها هذا السؤال، حملق ضباط الأمن الثلاثة بعضهم ببعضٍ باستغرابٍ ثم أجابني أحدهم باستهزاء: "ما فينا نحنا. والله كرمال يحتفظ الفلسطيني بحقّ العودة ويظلّ عم يقاوم وما ينسى بلده". (لا نستطيع ذلك، كي لا يُجنّس الفلسطينيّون فيخسرون حق العودة وينسون بلدهم".)
كانت تلك المرة الأولى التي أخرج فيها من مطار بيروت وأنا أبكي وأستشيط غضبًا، لأنّي في تلك الرحلة كنتُ أحاول أن أنقل حياتي إلى لبنان والعيش بالقرب من جدتي بعد مغادرتي سوريا منذ فترةٍ طويلة. لكنّ تلك الحادثة وضعَتني تحت الأمر الواقع مجددًا: لن أنال هذا الحقّ في ظلّ هذا النظام الأبوي العنصري.
*************
في خلال الانتخابات البرلمانية في أيار 2022 في لبنان، كنتُ سعيدةً بوجودي في لبنان، وكنتُ أترقّب النتائج بحماس. بالنسبة لي، كانت مشاركة مرشحاتٍ ومرشّحين جددٍ من قلب الشارع في الانتخابات ضربًا من ضروب الخيال، لكنها أعادَت إلى قلبي الشعور بالأمل والانتماء. أيقنتُ أنّنا جميعًا - سوريات/ون ولبنانيات/ون - في خندقٍ واحدٍ ضد أنظمةٍ قمعيةٍ لا تسمح لِمَن أعطَتني الحياة بأن تمنحَني جنسيّتها.
لكنّ جميع اللبنانيّين واللبنانيات ممّن ألتقي بهم/ن يردّدون: "شو بدّك بهالجنسية؟ نحنا يلّي معنا ياها إذا طلع بإيدنا منتنازل عنها" (ما حاجتك إلى هذه الجنسية؟ لو استطعنا، لكنّا تنازلنا عنها".)
أريدها، سواء كانت مفيدةً أم لا. أريدها لأن فيها بعض من أماني وسلامتي . أريدها لأنّها مفتاح بيتٍ أفتقده، وبطاقة وصولٍ الى عائلةٍ أشتاقها. أريدها لأنها حقّي. ولأن قضايانا كنساءٍ مؤجلةٌ دائمًا بحجّة ما هو "أهمّ". أعلم أن أصواتنا تزعج الأنظمة الأبوية، وأنا أريد أن أتكلم بصوتٍ عالٍ من جديد، حتى لا تُجبَر أيّ طفلةٍ أخرى على خفض صوتها لتحميَ نفسها من عنف العنصرية بعد اليوم.
- 1. نفّذ المجزرة نظام بشار الأسد في الغوطة في شرق دمشق يوم 21 آب/أغسطس 2013، وراح ضحيتها أكثر من 1400 مدنيةٍ ومدني من سكان المنطقة بعد استنشاقهم غازاتٍ سامةٍ ناتجةٍ عن هجومٍ بغاز الأعصاب.
- 2. وفقًا للمراسيم اللبنانية، تُمنح إقامة مجاملةٍ لمدة 3 سنواتٍ قابلةٍ للتجديد للفئات الآتي ذكرها: العربي/ة أو الأجنبي/ة من والدةٍ لبنانيةٍ إذا كان/ت لا تعمل/يعمل، وزوجة اللبناني العربية أو الأجنبية إذا كانت لا تعمل.