كبُرت الكاتبة في مجتمع أبوي جعلها تعرف الجمال والحب بعين الخوف. لكن الخوف الذي عرّفها والدها عليه، وحذره من القوة والجمال والحب ترجمته الحياة لها بدروسٍ صعبةٍ ومثيرةٍ للتأمل.
في صغري، كنت أتظاهر بالنوم كلّما دخل أبي الغرفة لیلًا. السهر أمام التلفزيون ممنوعٌ في لیالي المدارس، لأن ذلك سيجعل إيقاظنا صعبًا على أمي في الصباح. وبما أن أبي يحتاج نصف ساعة في الحمام قبل الذهاب لعمله، فلن نستطيع الدخول للحمام قبل السابعة والنصف إن تأخرنا في الاستيقاظ، ولن نلحق أتوبیس المدرسة. لذلك من الأفضل التظاهر بالنوم.
في تلك اللیلة سمعت أبي یقول لأمي: "أنا خایف على إسراء. البنت جمیلة جدًا، وهیبقى حوالیها ناس كتیر، وممكن یتضحك علیها لما تكبر". قالت له أمي: "بس هي كمان ذكیة وشاطرة، وما یتخافش علیها". كنت في السابعة من عمري وقتها، وكانت هذه المرة الأولى التي أسمع فیها أنني جمیلة، وربما الاعتراف الوحید الصریح من أهلي عن نظرتهم لي. هي أیضًا اللحظة التي خفت فیها أن أعبر من فتاةٍ لإمرأة. عرفت الجمال بعين الخوف قبل أن أعرفه بعين المتعة، واحتفظت بهذا السرّ الصغير إلى أن صرت شابة، أسمع كلمات غزلٍ من هنا وهناك.
الحب في عائلتنا غیر محكيّ، یظهر في أوقات المرض والفقد، ویصلح دائمًا مبررًا للاختیارات الغبیة واحتمالات الألم والإيذاء.
اعتدت أن یصفني أبي بـ"الشطارة" من باب التعنیف، كأن یقول لي إنه لا یُسمح لشخص بذكائي أن یقوم بأغلاطٍ محرجة، أو أن تقلّ علاماتي في المدرسة تحت أيّ ظرفٍ عن توقعاته، وطبعًا "الشطارة" مقترنة عنده أيضًا بمهارت الطبخ والغسيل والتنظيف، لأن التفوق ليس مبررًا للتعالي على الأعمال المنزلیّة.
الحب أیضًا بابٌ مفتوحٌ للخوف. والدي أبٌ لأربع فتیات وُلدنَ لأمّ
الجمال في عائلتنا أمرٌ مُحیّر، لأننا نسعى إلیه جمیعًا، لكنه في نفس الوقت یُشوّش على حياتنا وشخصيّاتنا وكينونتنا. یُفترض أن تكون الفتاة جمیلة، لكن "لوو بروفایل"، يعني جمیلة بالقدر الكافي لتوفير شركاء مناسبین، وغیر جمیلة لدرجة لفت الأنظار بشكل حادّ. ابنة خالي أجمل بنت عرفتها في حیاتي وقتها، شقراء بملامح أجنبیة، عیناها عسلیتان، تكشف الشمس خضارهما، وشعرها بندقيٌّ طویلٌ وثقیل، ترفض أمها تصفیفه أمام الغرباء، خوفًا من الحسد.
ارتدت ابنة خالي الحجاب سريعًا في المدرسة، ورفض أبوها التحاقها بسوق العمل، على عكس أختها، كي لا تستخدم المواصلات العامة وتتعامل مع زملاء ومديرين مستغلّين. أذكر أنني قلت لخالي: "طيب وصّلها أو هاتلها عربية، وتابعها"، فأشاح برأسه: "توء". هكذا، دون حجّةٍ أو انفعال. تأملت طويلًا البساطة التي مرّ بها الموضوع، وأنا أنظر لابنة خالي التي تكبرني بعدّة أعوام وهي تتغيّر. كان حرمانها من المستقبل الوظيفي أقلّ كلفةً لأبيها من مواجهة خوفه. فيما بعد، تزوّجت وارتدت النقاب خوفًا من الفتنة.
أدهشني كيف يتحرر الإنسان بعد انتزاع اعترافه بذاته
كانت هذه مقدمةً مناسبةً لما قد أواجهه في مجتمعٍ مثل الذي نشأتُ فيه. ربطُ الجمال بالقابلية للاستغلال، بالحب الزائف، بالمنحة التي توسّع خياراتك في الشركاء، والمحنة التي قد تعطيك شريكاً عينه زائغة، يرميك ما أن يرحل عنك جمالك وصحتك بتقدّم العمر أو الولادة. علينا أن ننكره ونتجاهله إذن، ونعمل على ما يمكننا الاستثمار فيه: العقل والشخصية، وقلب
في المقابل، اعتادت أمي أن تحمينا من الغرور بامتداح الآخرين، ورثاء جمالها القديم، حتى ظنّنا أنها لا تحبنا، فكان تمرّدي وتمرّد أخواتي من بعدي إقرارًا بحبنا لبعضنا، وقدرتنا على مدح جمالنا. أظن أنني بعد محاولات الفهم والتصالح مع الطريقة التي تربينا فيها، كنت أوّل من أخبر أختي بجمالها. كانت مصارحةً ثقيلةً وغريبة، أعني، كنت أشبه مراهقًا يغازل فتاةً للمرة الأولى في حياته، مرتبكةً ومحرجةً، لكن، بدافع الحماية أيضًا، عازمةً على أن تعرف تلك الحقيقة مني، لا من رجل، وأن ندين بتلك المعرفة لبعضنا، لا لأحدٍ يمكنه سلبها منا أو المطالبة بمقابل اكتشافها. قلته لها كتحليلٍ منطقي عن الجينات، عليها الإيمان به دون مغالاة. استقبلت أختي كلامي بقدرٍ هائلٍ من الخجل والسعادة وعدم التصديق. أدهشني كيف يتحرر الإنسان بعد انتزاع اعترافه بذاته، وتعاهدنا، دون كلام، على أن تعيش أختانا الثانيتان على دراية دائمةٍ بجمالهما أيضًا.
حين صرت في سنّ الزواج، لاحظت أن أبي، على عكس جميع الآباء حولي، لا يسعى لتزويجي. تقدّم لخطبتي عريسٌ قبل أن أدخل للكليّة وبدلًا من السيناريو الذي هيأت نفسي له، بأن أغضب وأتشاجر مع أبي فُوجئت بموقفه. أخبرني بأسى أنه لن يمانع إن وافقت، ولكنه يخشى ألا "يدعني" العريس أكمل دراستي. وجدت نفسي أطمئن أبي، بدلًا من الاحتداد عليه: "لا تقلق يا بابا، لا أفكر في الزواج عامة، ولن أختار رجلًا بهذه العقلية". كنت بشكلٍ ما واثقةً من اختياراتي المستقبلية، وكنت محقةً لدرجةٍ كبيرةٍ، فلم تكن صراعاتي مع الرجال فيما بعد بهذا التدني.
أبي رجلٌ ذكي، ومتمرّدٌ قديمٌ على مجتمعه. غيّر مساره التعليمي ومهنته وتزوج أمي بعد صراعاتٍ طويلة، فكان محقًا في نبوءاته إلى حدٍّ بعيد. بالفعل أحاط بي رجالٌ كثيرون بينما أكبر، حاول عددٌ منهم استغلالي. بالفعل أحبني رجالٌ كثيرون، لم يستطيعوا احتمالي. وبالفعل لم تنته صراعاتي باستسلام أبي لها.
اتّبع أبي أسلوبين متناقضين في تربيتي، الأول هو السماح لي بهامشٍ للنقاش والصراع على مكتسباتٍ أدرك الآن أنها ليست بالبساطة التي تصورتها، كلها على أرضية كوني إنسان ولست امرأة، والثاني هو إرهابنا من الرجال، ومن أنه لا يوجد رجلٌ يتسامح مع ما أصارع أبي عليه؛ الرجال لا يستطيعون التعامل مع امرأةٍ لسانها طويل وعيناها غير مكسورتين. وعلى عكس خالي، تعامل أبي مع حِمل تربية البنات بتحقير كلّ ما من شأنه التحريض على الوعي بأنوثتنا. مستحضرات التجميل، الوقت الطويل أمام المرآة تجهيزًا للخروج، الصور الشخصية، الأغاني العاطفية، الشعر والأدب، الألوان الملفتة في الملابس، وحتى أحاديث الزواج، كانت كلها أشياءٌ تسبب إرباكًا ملحوظًا لأبي يتبعها لومٌ على تضييع الوقت في التفاهات و"ثقافة الاستعراض".
الخوف الذي عرّفني أبي عليه رأيت جذوره فيمن تعاملت معهم. وحذره من القوة والجمال والحب ترجمته الحياة لي بدروسٍ صعبةٍ ومثيرةٍ للتأمل.
يخشى الرجال بعضهم البعض. لم أعرف رجلًا واحدًا في حياتي لم يحذرني من الرجال "الآخرين" بطريقةٍ أو بأخرى. الرجل ذئبٌ لأخيه الرجل. كيف يترجم علماء النفس ذلك؟ لا أظن أنها فقط نزعة تملك، بقدر ما هي عدم تقديرٍ للذات، بوصفه ذكرًا ضمن جمعٍ من الذكور، وخبرة حقيقية متناقلة.
يُسحر الرجال بالجمال والقوة، لكنهم يجدون مشقةً عاليةً في التعامل السويّ معهما، أو تركهما في حالهما. كأنكِ الندّاهة، يخشونك ولا يكفّون عن السعي إليكِ والضياع فيكِ. وخاصةً في دوائر الساعين للثقافة والتحرر القيمي، يحب الرجل المرأة الدسمة المشاكسة للحياة، لأن ذلك إعلان انتصارٍ ذاتي وأيدولوجي كبير، لكنه لا يستطيع التعامل معها سوى خالية من الدسم والصراع.
أعني، سيحبك كثيرون جدًا إن كنت امرأةً صعبة ذات معايير عالية، لكن سيصحب هذا الحب دومًا محاولات ترويضك، وستصلين لنتيجة أو اثنتين: إما أن تعيدي تقليم أظافرك وتخفيف دسمك بنفسك لأجل الحب، أو تصبحين أمًا مربية لمن تحبين، فتقومين بالاهتمام والتعليم والخناق على قضايا المساواة والمسؤوليات النفسية، مع عدم المساس بصورة الشريك عن نفسه، لأن الرجال يهربون حين يُحصرون في الزاوية. وقبل أن تصيحي "الباب يفوّت جمل"، فصور ذاك الهروب ليست بالضرورة إنهاء العلاقة، بل التهرب من مسؤولياتها، التوجه لنساء أخريات، وصور العنف المصغرة التي لا تستطيعين الإمساك بها دون أن تصيري مجنونةً ونكدية. ستدفعين الثمن باختصار.
الدهاء هو الأداة المتاحة للنساء، يسمح لهن بالحزن والانكسار ولا يُسمح لهنّ بالغضب
قال لي رجلٌ حكيمٌ مرّةً في نصيحته لي بأن أكون ليّنة لأنّ "الست الشاطرة هي التي تجعل شريكها يفعل ما تريد، وهو يظن أن هذا ما يريده هو". هذه الحكمة الشعبية هي مفتاح علاقات القوة. ما لا يؤخذ بالعدل يؤخذ بالحيلة،
هذه الحكمة أيضًا هي منشأ منطق مسامحة الرجل على عنفه، ومعايرته على إبداء ضعفه وارتباكه وخوفه.
العلاقات العاطفية ليست ساحة صراع، أعلم، لكن دخولها بمبدأ الحيلة والمحايلة أمرٌ غير مقبولٍ بالنسبة لي. ليس فقط لتصوراتي عن نفسي، وإنما أيضًا لأنه مبدأٌ يفترض أن الرجال أطفالٌ صغار بكبرياء هشٍ وسامٍّ، يجب مجاراتهم اتقاءً لشرهم. لا أظن أنني أستطيع دخول علاقةٍ لا أحترم فيها الطرف الآخر، ولا أفترض فيها النديّة.
لا أعرف امرأةً لم تُشهَر في وجهها نظرية "وش القفص"1 عند الشكوى، فقد فزتِ برجلٍ وفيٍّ لا يؤذيكِ، لا تضطرين معه لنقاشاتٍ بدائية في الحق في التعليم والعمل وسلامة الجسد. في عالمٍ نناقش فيه قضايا العنف الأسري وجرائم الشرف والاغتصاب الزوجي وأحقية تمرير النساء للجنسية، يصبح الحديث عن معايير الارتباط شيئًا من الترف أحيانًا. لا يأخذ المرء كل شيء، وعليكِ القيام ببعض التنازلات كي تسير المركب.
في الحب لا تنقصني الشجاعة، ينقصني الاستحقاق. ألّا أضبط نفسي متلبسةً بالمشي على قشر بيض كي لا أُتّهم بالافتراء والقسوة. ألّا أُجبر على أن أكون على الدوام نسخةً مخففةً مني، معادلةٌ أُخيّر فيها بين نفسي وبين الحب، شروط تعاقد أخسر فيها في كل الأحوال. أراد أبي ألا يدللني حتّى لا أصطدم بالعالم بعده، لكن عندما عرّفته أمي على شاب وعريسٍ محتمل، قال هذه المرّة أمامي: "مهمّة صعبة عليه، لن ينجح في ترويض النَمِرة".
- 1وش (وجه) القفص هو أفضل ما فيه. جاء التشبيه قديمًا من الفلاحين المصريين، حيث كانوا يعرضون أجمل ما في الفاكهة والخضار على "وش" الأقفاص ويرفضون أحيانًا بيعها كي تظل تروج لبضاعتهم وتجلب لهم الحرفاء والحريفات.
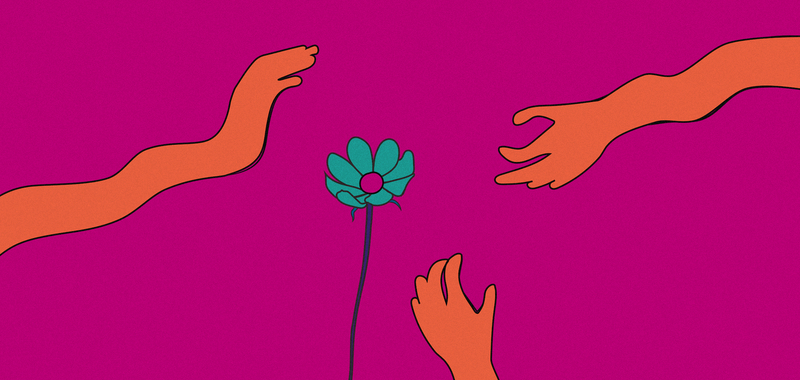

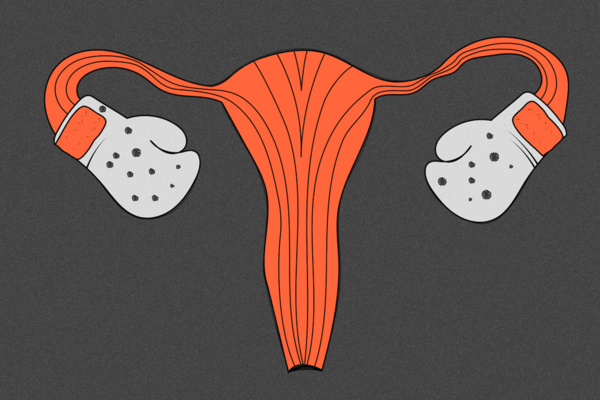
Add new comment