
التربية الجنسية في مصر.. مُحرّمة في مجتمع منشغل بالجنس
ربما كان أبهظ ثمنٍ دفعته لقاء مشاركة المعرفة في المرحلة الإعدادية، في التسعينيات من القرن الماضي، حين كنت طالبة في مدرسة شهيرة وذات تاريخ عريق في تعليم وتمكين النساء. في غياب أيّ نوع من التثقيف الجنسي من المدرسة ذاتها كنت أسمع أشياءً من البنات في الفصلين الأول والثاني الإعدادي - المقابلان للصفوف الحادي والثاني عشر- من قبيل أن القبلات تتسبب في الحمل، أو أن الدورة الشهرية نزفٌ نتيجة عدم الزواج، وأنها ستظلّ تتكرر حتى نتزوج وتنتهي. كانت الخرافات والمفاهيم المغلوطة في كلّ مكان حولي في المدرسة وعلى كلّ لسان.
أذكر أنّ أمي تحدثت معي عن الدورة الشهرية والعملية الجنسية (بمعنى التكاثر طبعًا) في تلك المرحلة وعندها قرّرت مشاركة هذه المعلومات مع زميلات الصف في مهمة توعويّة نبيلة، لأتعرّض بعدها لأسوأ حملة تنمّرٍ في حياتي. كانت البنات تأتين لسماع المعلومات منّي في الوقت بين الحصص، ويسألنني عن التفاصيل، ومن أين أعرف هذه المعلومات، وعندما كنت أخبرهن ببساطة "أمي"، كانت أعينهن تتسع غير مصدّقة، ويتسابقن بعدها في نعتي وسبّي فيما بينهن، إلى أن تطوّعت إحدى الصديقات وأخبرتني بما يقولونه عليّ.
أطلقن عليّ ألقابًا مختلفة: "شرموطة"، "تربية وسخة"، وما إلى ذلك من نعوت أخلاقية سلبية، فقط لأنني كنت أمتلك معلوماتٍ موثوقةً عن العملية الجنسية وكيفية حدوث الحمل، أخبرتني بها والدتي. لم يكن لديّ أي معلوماتٍ أكثر وقتها، بالعكس، لم أكن حتى أستطيع تمييز التحرّش الجنسي والملامسات غير المقبولة، وكان وضع الطالبات الأخريات أسوأ مني، وبالطبع كان لدينا مدرس متحرّش بالجميع في المدرسة.
كان هذا ثمنًا باهظًا لحصولي على ومشاركتي معرفة بسيطة، وأنا ما زلت أتأرجح بين الطفولة والمراهقة. وبالطبع لم تكن الأمور أسهل بعدها حيث تصاعد التنمّر في المدرسة إلى حد إجباري على ارتداء الصدريّة مبكرًا، حيث بدأ الأمر بالملاحقة و"تلقيح" الكلام كما نقول في العاميّة المصرية، ثمّ جاءت إحدى المدرسات للتحدّث إليّ وأخبرتني مباشرة أن أطلب من أمي أن تشتري لي صدريّة. عدت يومها إلى المنزل وفي رأسي ألف سؤال عن أهمية إخفاء الصدر – أورثتني هذه التجربة محاولةً دائمة لإخفائه بكتفيّ - وبدأت أتجرأ على السؤال أكثر مع والدتي بعد هذه الواقعة، وفي القراءة بعدها بسنواتٍ قليلة على الإنترنت، واكتشفت متأخرًا هذا العار الملاحق للحديث عن الجسد والجنس أو أي شيء قد يؤدي لمعرفةٍ تخصّهما.
تذكرت أكثر من موقفٍ مشابهٍ في حياتي، وأنا أشاهد المسلسل الإنجليزي "Sex Education" أو "تربية جنسية" إنتاج سنة 2019، حيث تتحدث مجموعة من المراهقات والمراهقين عن علاقاتهم الجنسية والعاطفية بانفتاح ويسعون للتعلّم حول أجسادهن. تتنوع العلاقات والميول والهويات الجنسية في المسلسل دون وصم، وتدور أحاديث في الحلقات عن أهمية المتعة. المسلسل عبارة عن نقاش ذكي حول التربية الجنسية بشكل منفتح ومتحرّر من الأحكام الأخلاقية، تمامًا بعكس التجارب التي مررت بها في سنوات الدراسة وربّما أيضًا بعد ذلك.
دفن الرؤوس في الرمال كالعادة
بالتناقض تمامًا مع هذه الإطلالة الحالمة ومدى تطوّرها، أعيش الآن في مجتمع ينظر شبابه إلى قضايا المساواة على أنها شيءٌ دخيل علينا، فوفقًا لاستبيان "آراء الشباب المصري في 2014" لمجلس تعداد السكّان تنظر النسبة الغالبة من الشباب إلى تشويه الأعضاء التناسلية للنساء على أنه ضروري، وإلى التحرش الجنسي على أنه مسؤولية النساء في الشوارع، ويقبل طيف واسع من المجتمع العنف ضد النساء لأسباب تافهة – مثل التحدث إلى رجل آخر! - وما زال يناقش وجود المرأة في سوق العمل، بل يرى أنه يجب على المرأة أن تأخذ إذنًا من زوجها قبل قيامها بأيّ نشاط.
ينظر المجتمع المصري إلى التربية الجنسية على أنها شيءٌ مُحرّم بشكلٍ عام. تتنوّع الآراء وأساليب التعامل مع الموضوع بين الطبقات الاجتماعية مثلما تشير د. مها حسين في كتابها "العذرية والثقافة - دراسة في أنثروبولوجيا الجسد" الصادر عن منشورات الرعاة للدراسات والنشر سنة 2010، حيث تجد أن هناك نقاشًا من الأبناء والبنات في بعض عائلات الطبقات الميسورة ماديًا وأن هناك مساحة في بعض المدارس الدولية لمبادرات فردية من مدرّسين أو مدرّسات تُجِبن على أسئلة الطلاب، ولكن الطبقات المتوسطة والطبقات الأدنى تعتبر أن أسئلة الأطفال - حتى عن من أين أتوا أو كيف ولدوا - سبب لتوتر يضرب المنزل، ويستدعي إجاباتٍ غير واقعية أو رافضة حتى للتعاطي مع الأسئلة لدواعي أخلاقية من نوعية: "اشتريناك من عند الدكتور"، "عيب تسألي في الحاجات دي"،" لما تكبر هتعرف"، وحتى إجابات مدمّرة من نوع: "لقيناك على باب الجامع".
يمتد هذا التحرّج بل حتى المنع إلى المستوى الرسمي. فقد قامت وزارة التربية والتعليم المصرية نفسها سنة 2010 بإلغاء الدروس البسيطة التي كانت تشرح الأعضاء التناسلية والأمراض الجنسية المُعدية في الصف الثالث الإعدادي والمرحلة الثانوية في منهج العلوم الحكومي وتركت الأمر مقتصرًا على نقاش غالبًا لا يحدث في الحصص الدراسية، مؤجلّةً الأمر لمنهج الأحياء السطحي جدًا في المرحلة الثانوية الذي يشرح التكاثر في الكائنات الحية وأجهزتها التناسلية ومن ضمنها الإنسان. جدير بالذكر أن الوزارة لم تعلن عن أسباب هذا القرار، واتُخذت هذه الخطوة وسط رفضٍ من الخبراء التربويين وواضعي المناهج أنفسهم وبعض المعنيين من كتّاب الرأي.
لا يختلف الوضع كثيرًا في المدارس الدولية ذات التكاليف الباهظة والمناهج الخارجية، حيث تفتقر هي الأخرى لمناهج للتثقيف الجنسي وكلّ ما هنالك هو دروس الأحياء في المرحلة العاشرة التي تعادل الصف الأول الثانوي في المدارس الحكومية. لكن هناك، بلا شك، فجوة معرفية وتعطشًا لدى الطلبة والطالبات لفهم أجسادهن والتغيرات التي تطرأ عليها. وفي غياب منهاجٍ دراسي منظّم يجيب على أسئلتهم، تجد المعلمات والمعلمون أنفسهم في فوّهة المدفع. صديقتي معلمة في مدرسة دولية شهيرة تخبرني أنها تتلقى الكثير من الأسئلة من الأولاد والبنات على حدّ سواء، ولأن الموضوع يتكرر كثيرًا فقد اضطرت لإبلاغ إدارة المدرسة أنها تجيب على هذه الأسئلة. لم تمانع الإدارة ولكنها بالمقابل أبقت الموضوع تحت الرادار خوفًا من ردود فعل سلبية من الأهالي في حال الاعتراف المعلن بوجود مساحة للحديث عن التربية الجنسية.
يصل التجهيل والتعتيم على المعرفة إلى حد عدم تعريف الأطفال بأسماء الأعضاء التناسلية الحقيقية مثل بقية أعضاء الجسم
يصل التجهيل والتعتيم على المعرفة إلى حد عدم تعريف الأطفال بأسماء الأعضاء التناسلية الحقيقية مثل بقية أعضاء الجسم. لم أعرف أنا اسم عضوي إلا في سنٍّ كبيرة، ربما الرابعة عشر. وفي سنة 2018، وأثناء مشاركتي في ورشة لتدريب العاملين في المجال الإعلامي على مبادئ تغطية قضايا الجنسانية مع منتدى الجنسانية (والذي عُقد للمصادفة في تونس، أول دولة عربية تقرّ مناهج التربية الجنسية في المدارس)، اكتشفت أن هذه ظاهرة عربية عامة!
كنّا مشاركين رجال ونساء وذوي هويات جنسية مختلفة من جنسيات عربية مختلفة، وسألتنا المدربة صفاء طميش: "كيف كان الأهل يعلّمونكم أسماء الأعضاء التناسلية الخاصة بكم؟". انطلقت الإجابات الكاريكاتيرية، كل المشاركين تقريبًا قالوا أسماءً من نوعية: "بلبل"، "حمامة"، "بتاعي"، "تاعي"، "تبعو"، وطبعًا أخذت الأعضاء التناسلية الأنثوية المرتبة الأولى في التهميش لعدم وجود اسم طفولي لهذه المنطقة المحرمة في الثقافة العربية، فقط: "سوسو" أو "هنا" مع إشارة بالإصبع أو "اللي تحت".
كان الهدف من هذا السؤال هو أن نتعرّف أكثر إلى أنفسنا، وأن نكون أكثر استعدادًا لتقبّل الأسئلة عن الأمور الأكثر حميمية والتعامل معها وفك التشابكات التي بدأت من لحظة لم نعرف فيها اسم عضونا التناسلي حتى عرفناه من زملاء وزميلات المدرسة أو درس العلوم في الصف الثالث الإعدادي، تمهيدًا لأن نكون قادرات على العمل الميداني وتلقّي الأسئلة من الأهل والمهنيين، بالطبع كان لدى الرجال فرصة أفضل للمعرفة مبكرًا وإن كانت ذات تأثيرٍ أسوأ في المستقبل: الأفلام الإباحية أو كما يطلق عليها في الثقافة الشعبية عندنا "
ماهي التربية الجنسية ولماذا نخاف منها؟
هناك مفهومان يُتداولان عند الحديث عن هذا الموضوع: الصحة الإنجابية والتربية الجنسية. ترى صفاء طميش – مؤسسة المنتدى العربي لجنسانية الفرد والأسرة (منتدى الجنسانية)– أن مفهوم التربية الجنسية أشمل وأهم من الصحة الإنجابية، ففي حين أن الأخيرة تهتم فقط بالتغييرات الجسدية التي تحدث للجسم في سن المراهقة وعملية الإنجاب، تهتم التربية الجنسية بالمنظور الحقوقي كما تُعرّفها منظمة الصحة العالمية، وتركّز على ما وراء التغييرات الجسدية والنفسية والتصور الذاتي والنظرة للجنسانية والأدوار الاجتماعية والهوية والميول الجنسية. كما أن التربية الجنسية تشمل العلاقات بشكل إنساني وأكثر شمولية ويتناول كل الأصعدة الفسيولوجية والاجتماعية والنفسية. التربية الجنسية السليمة قائمة على حق الطفل والطفلة في المعرفة بمعزل عن القيمة الأخلاقية المعلقة بها، فمن حقهما أن يفهما العلاقة الجنسية بغض النظر عن شعور أهلهما تجاهها وأن يحدث هذا بشكلٍ يحترم عقل الطفل والطفلة في كل مرحلة عمرية وإعطائهما الفرصة لينتقيا الخيارات المناسبة لهما.
ربما يخيف هذا القدر من حريّة الاختيار الآباء والأمهات الذين تربّوا على تقاليد صارمة، لكن موقف الأهل لا يُوجد في فراغ، فللمجتمع ككلّ النصيب الأكبر من التأثير. مثلًا، عندما ترى مؤسسات دينية راسخة كالأزهر الشريف في مناهج التربية الجنسية العالمية بما فيها من اعتراف بالميول والهويات الجنسانية المختلفة اتباعًا للنمط الغربي ومخالفة للشريعة الإسلامية، وعندما تلغي الدولة المناهج الدراسية المتعلّقة بالثقافة الجنسية، ويدعم أطباء ومهنيون التمييز الجندري في تربية الفتيات، لا بدّ أن يتشكّل أو يترسّخ موقف الأهل تباعًا لهذه المؤثرات.
أحدُ الأمثلة على التأثير السلبي لبعض هذه الآراء "الخبيرة"، يورد مركزٌ مصري يُعنى بنفسية الأطفال، ولديه مليون وربع متابع/ة على الفايسبوك، ملصقات ونصائح مفادها بأن يجري تعليم البنت من عمر سنتين أنها ليست "ولد"، أي ليس لديها قضيب، ولذلك عليها أن تتبع عددًا من "النصائح" من نوعية "ضمي رجليك"، "لا تلعبي مع الأقارب الذكور"، وغيرها ممّا لا يعلم للأولاد الذكور! كما تعلم البنت أنها مصدر فتنة يجب أن يكون مراقبًا دائمًا وفي حماية الآخرين. كل هذه المؤثرات تلعب دورها في تشكيل موقف الأهل من التربية الجنسية، لا سيما وأن الخوف الأعظم في مجتمع مثل المجتمع المصري هو ممارسة الأبناء وخصيصًا البنات لعلاقات جنسية خارج إطار الزواج، كما أن هاجس العذرية يلعب دورًا رئيسيًا في التعتيم على الجنس وتقييد أجساد البنات. في المقابل تعتبر مناهج التربية الجنسية ذات المرجعية العلمية والحقوقية، أن البنت كائنٌ كامل، لديها نفس حقوق وحرية الولد، ولها حقّ التصرف في جسدها وتقرير مصيرها بنفسها مثله تمامًا.
مشاركة المعلومات الجنسية تُترجم فورًا على أنها تعزيز لقدرتهم\ن على ممارسة "الجنس"، وبالتالي من حق الذكور أن يعرفوها أولاً
في هذا السياق يتولّد لدى بعض الأهالي رعبٌ من وصول أولادهم وبناتهم لسنّ البلوغ بسبب الضغوط التي قد يشعرون بها من ناحية مواجهة أسئلتهم عن أجسادهم والجنس، ومن ناحية "إدارة الأزمة" والتحكم بتصرفات البنات خصوصًا، ففي مجموعة دعم على فيسبوك، شاركت إحدى الأمهات رعبها مستخدمة تعبير "الخضّة"، قائلة: "النهارده تاني مره السنه دي اتخض وافتكر إن بنتي بلغت، حاسه إن بقي عندي فوبيا إن بنت من بناتي تبلغ، مش عارفه السبب ومش قادره اخد خطوة اني اتكلم معاهم عن جسمهم، هما لسه ثالثه ورابعه ابتدائي وجسمهم قليل". شاركت أخريات خوفًا مشابهًا، وأضافت إحداهن أن تربية الأولاد الذكور أفضل لأنها لا تضطر إلى إخبارهم بالمعلومات الجنسية كالبنات "همّا بيعرفوا لوحدهم"، مما يحمل في طيّاته مجموعة من المفاهيم المغلوطة عن التربية الجنسية، بل والتمييز بين الأبناء والبنات حتى في حقّ الحصول على المعلومة من الأهل، فمشاركة المعلومات الجنسية تُترجم فورًا على أنها تعزيز لقدرتهم\ن على ممارسة "الجنس"، وبالتالي من حق الذكور أن يعرفوها أولاً أو من الخارج، بينما الرعب المقيم أن تعرف البنات كيف يحدث الجنس والتهديد الأكبر هو مواجهة عواقب ما يعتقد الأهل أنه "انفتاح" و"مفاهيم حرية غربية" و"ليس ما تربيّنا عليه"- مع أن "ما تربينا عليه" كما نعرف جميعًا ما هو إلا تعتيم ومفاهيم مغلوطة تقودنا إلى واقع مظلم كواقعنا اليوم.
منظّمات المجتمع المدني: ما بين أهمية التعاون مع الدولة والخوف منها
ربما يظلّ هناك أملٌ أخير في مؤسسات المجتمع المدني أو ما تبقى منها، لكن حين يتعلق الأمر بالتربية الجنسية فإن جهود هذه المؤسسات لا تكفي في ظل انعدام الإرادة السياسية لدعمها. فالحملات المجتمعية لمؤسسات محلية ودولية في نوفمبر من كل سنة للحد من العنف ضد المرأة في العشر سنوات الأخيرة، والتركيز على أهمية التربية الجنسية في سياق منع التحرش الجنسي والتوعية ضد الأمراض وتنمية حس الخصوصية الجسدية لدى الأطفال والنشء في العديد من المؤتمرات والدراسات والمقالات عن الموضوع، كل هذا لا يكفي وحده لسد الفجوة المعرفية وتعميم التربية الجنسية.
لا توجد حملات توعوية مجتمعية في القرى والمحافظات، ولا توجد إحصائيات مُعلنة حول معدل الإصابات بمتلازمة نقص المناعة المكتسبة HIV، كما لا توجد معلومات عن الأمراض المنقولة جنسيًا ولا توعية عن طرق الإصابة بها، ولا الحمل المبكر، ولا الإجهاض (مجرّم في مصر)، كذلك لا توجد أدلّة موثّقة ومُعلنة وحديثة عن آثار غياب التربية الجنسية السليمة خصوصًا فيما يتعلق بالصحة العامة1. فبدلاً من استغلال مناهج التربية الجنسية الموحدة في المدارس لمعالجة الظواهر السلبية التي يعاني منها مجتمعنا، مثل حصار العنف الجندري مثلاً أو تقليل قبول تشويه الأعضاء التناسلية للنساء منذ عمر صغير، يخاف بعض الفاعلون المدنيون من التطرّق إلى أيّ من هذه المواضيع أثناء عملهم.
أثناء كتابتي لهذا المقال، حاولت التواصل مع إحدى المؤسسات الشهيرة التي تعمل في التربية الجنسية في مصر وتقدّم دورات تعليمية للأهل عن كيفية توعية أطفالهم والحديث معهم عن خصوصية أجسادهم، لكنني لمست لديهم خوفًا لا يخفى من الحديث عن عملهم ونشره في ظل الرقابة الشديدة من الوزارات المعنية على المحتوى الذي يقدّمونه، وأن المدخل الوحيد الممكن للحديث عن أهمية التربية الجنسية -وهنا يُستخدم مصطلح "التربية الإنجابية"- هو منع التحرش الجنسي بالأطفال وتعليمهم كيفية التعامل مع محاولاته.
ينتشر هذا الخوف في منطقتنا العربية، سواء من السلطة أو من ردود فعل الأهل - سلطة أخرى - ولهذا كانت أولى خطوات تجربة منتدى الجنسانية الطويلة في مجال التربية الجنسية، هي إشراك الأهل في دورات التثقيف الجنسي لضمان النجاح، ففي سياق أحد المشاريع قام المنتدى بتدريب المعلمات والمعلمين على التعاطي مع مسألة التثقيف الجنسي، لكن لخوف المدارس من ردود أفعال الأهالي اتُّخذ القرار بإدماجهم، وذلك بعد أن أظهرت نتائج استبيان بسيط للطالبات والطلاب أن لديهم الكثير من المعلومات المسبقة الخاطئة عن الجنس. تحكي صفاء طميش: "فوجئنا بأولاد الصفوف الابتدائية يتحدثون عن البورنو، في المخيمات والجولان والمدن والقرى! فقمنا بعمل اجتماع للأهالي بموافقة المدرسة، لمشاركة نتائج الاستبيان، ويفاجئ الأهل بأنه أولادهم معنيين بالجنسانية، ومن ثم يتغير الوضع فورًا لكيف نتعامل معهم؟ ماذا نقول لهم؟ ومن هنا تبدأ رحلة التعلّم المشتركة، مع الحفاظ على حق الجميع في حرية المشاركة من عدمها".
قام المنتدى في السنوات الأخيرة بعمل عدّة ورشات تدريبية إقليمية عن الجنسانية والنوع الاجتماعي لأطباء ومهنيين.ات من عدة دول عربية بما فيها مصر في محاولات لزرع بذور مهنية لنقل المعرفة. وقد خلقت هذه الورشات مجتمعات توعويّة بين طلاب كليّات الطب بشكل عام، وشجّعت آخرين على نشاط توعوي خارج الأطُر التقليدية، في محاولات للاشتباك مع المجتمع بطرق أخرى غير المدارس المغلقة في وجه مؤسسات المجتمع المدني.
أما محاولات الاشتباك الأخرى خارج منظمات المجتمع المدني فهي فريدة وغير منظّمة. مثلاً تحاول دكتورة هنا أبو الغار أستاذة طب الأطفال بجامعة القاهرة، أن تشتبك في مقالاتها عن التربية الإيجابية مع التربية الجنسية للأطفال، ومثلها الكثير من الخبيرات والخبراء الذين يحاولون زيادة الوعي والتعاطي مع هذه المواضيع. تركز د.هنا في كتاباتها على وضع غياب التربية الجنسية في سياق أعم وتوضيح تبعاته، فتقول أن سبب عدم الرضا عن العلاقة الزوجية ومعدلات الطلاق المرتفعة في مصر، عائد إلى أن الطرفين لا يعرفون شيئًا عن جسديهما منذ الطفولة وحتى الزواج نفسه، وتؤكد أن التربية الجنسية لا تقتصر فقط على حماية الأطفال من التحرش الجنسي وإن كان هذا جانبًا مهمًا منها، بل تمتد إلى تعليم الطفل أن جسده ملكية خاصة له، وأنه يتمتع بخصوصية لا يستطيع حتى الأهل اختراقها، حيث يجب أن تفهم الطفلة أن الاستئذان والرضا جوانب أساسية في علاقتها بهم، وأن تُدعم أحسن صورة لذات الطفلة وأهدافها وميولها الخاصة.
وبخصوص معدلات قبول العنف في أوساط الشباب التي سبقت الإشارة إليها، تفسرها د.هنا: "هذه المعدلات الرهيبة عائدة على التربية، فالطفلة التي تعرف أن أهلها يحبونها لأنهم يقولون لها (نحن نحبك ولهذا نضربك) ستكبر ولديها قبول أن الشريك الحميم يضربها لأنه يحبها، وسيقبل الرجل التنمُّر والذل والإهانة في العمل وغيره لأنهم يعرفون مصلحته أكثر منه"، وبالمثل للتعنيف النفسي والجنسي، كما أن هذهِ التنشئة تؤثر جندريًا بشكل مختلف. وتضيف د.هنا أنه في ظل غياب تربية جنسية سليمة في المنزل وتعميق للأدوار النمطية "يفقد الأطفال احترامهم لأنفسهم بدرجات وطُرق متفاوتة، فالبنت تكبر ليصبح لديها خوف وهوس الحفاظ على العذرية، وخوف من الجنس والحميمية بسبب صدمة تشويه الأعضاء التناسلية، أما الولد فيربط الذكورة بفرض الإرادة والقوة وأنه صياد يسعى لاصطياد فريسة، ولو كان ولدًا لا توجد به هذه الصفات فيُطحن ويُدمَّر اجتماعيًا". ينطبع هذا على العلاقات مع الغير بكل تأكيد لا سيّما وأن مصادر المعلومات الغائبة من المدرسة والبيت قد تكون أفلامًا إباحية تصوّر النساء كمفعول بهن دائمًا، لا يعرفن شيئًا عن رغباتهن ولا يعبرن عنها، وتصور الرجال على أنهم يشبعون رغباتهم كيفما اتفق وينظرون إلى الأمر نظرة دونية، وهذه السلبيات تتضاعف طبعًا إن كان الولد أو البنت لديهما تساؤلات عن جنسانيتهما.
وعلى ذكر الرسائل التي تتسرّب في مرحلة الطفولة سواء بتأثير المجتمع أو المنزل ومن ثم تترسّب في عقولنا وتنطبع على علاقاتنا، تنبّهت إلى أنني أنا شخصيًا لا أذكر نقاشًا مع أبي بشأن أي شيءٍ يخص تربيتي بشكل عام أو معلوماتي عن جسدي وبالطبع عن الحب والعلاقات العاطفية! أما الجنس، فهو طبعًا خارج الطرح من الأصل. حتى علاقته بأمي مثلاً لم يحكِ عنها بوضوح إلا وأنا في المرحلة الجامعية، كان دوره "التقليدي" بالطبع متركزًا على العمل وجلب الأموال والتدخل بالقدر الذي يكفل تمييزًا بين الذكور والإناث، في حين كان دور أمي يمتد لإدارة شؤون المنزل، وتربية الأولاد ومتابعة دراستهم وإدارة كل أنواع النقاشات في جميع المراحل. سألت د.هنا أبو الغار عن الوضع الآن، فقالت: "لم يختلف كثيرًا، بالعكس، ربما كان الأهل يتحدثون مع أولادهم أكثر في زمن ما قبل الإنترنت، لكننا نحاول الآن أن يكون الوالدين معًا على ظهر السفينة، مسؤولين معًا عن التربية ومسؤولين معًا عن تمويل وإدارة شؤون المنزل، وهذه هي أولى رسائل التربية الجنسية السليمة لأطفالنا: الكُلّ متساوٍ بغضّ النظر عن جنسه".
- 1. وهنا ينبغي التنويه أن الخطاب النسوي ينادي بأهمية إدراج المتعة وليس فقط "الحماية" و"الصحة" على سلم أولويات التربية الجنسية.






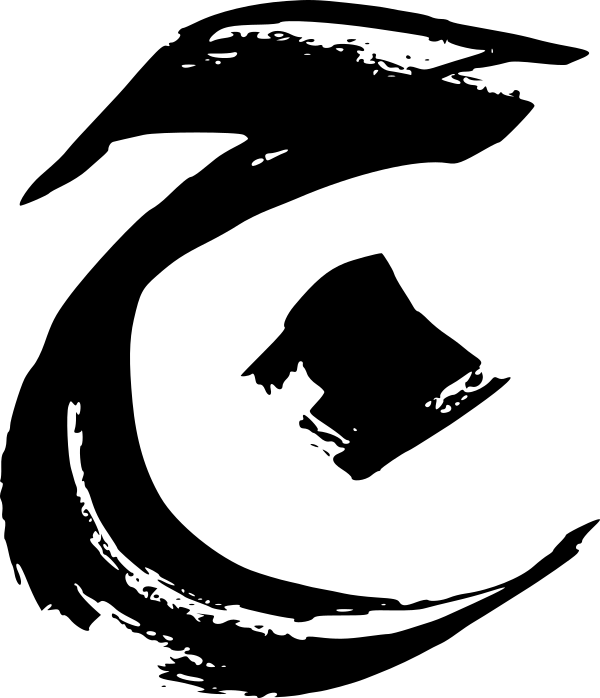

Comments