كيف ينمو القلق في حياتنا ويكبر إلى حدّ التحكّم بنا وبقراراتنا؟ هل من مهرب منه، خاصة أننا نعيش في عصر السرعة؟ آلاء حسانين تشاركنا تجربة معايشة القلق منذ طفولتها إلى يومنا هذا.
تقول الكاتبة الأميركيّة سوزان سونتاغ في مذكراتها: "تحت الكآبة، عثرت على القلق". دفعتني هذه العبارة للتفكير في السنوات الطويلة التي قضيتها رفيقة الاكتئاب ثمّ القلق. قلق يُلازمني بشكل دائم ولا أعرف كيف أتعامل معه. بعد جهد وعناء يُمكنني القول إنّني قاومت الاكتئاب وتخلّصت منه تدريجيًا لكنّني لم أستطع فعل الشيء نفسه مع القلق.
أسأل نفسي أحيانًا: أيّهما بدأ أوّلًا، الاكتئاب أم القلق؟ تبدو معرفة الإجابة أمرًا صعبًا، لأنّني اختبرت كُلًا من الاكتئاب والقلق في مراحل مبكّرة من حياتي. فقد أُصبت باكتئاب حاد بعد بلوغي السابعة عشرة واستمر خمس سنوات تقريبًا، لم أستطع خلال عامين منها مغادرة الغرفة سوى مرّات نادرة. بعد انتهائي من المرحلة الثانوية، كانت علاقتي بالعالم قد بلغت حدها الأقصى من التعقيد. وعوضًا عن الانتحار، حملت أغراضي القليلة وصعدت إلى غرفة في الدور العلوي في المنزل، كانت تُستخدم كمخزن، وانعزلت عن العالم. كنت غاضبة من كلّ شيء، من الله والمجتمع والبيئة المتديّنة في السعودية ومن عائلتي. لم أكن أحسن التعامل مع نفسي ومع ذواتي المتعددة. استغرق مني الأمر أشهرًا طويلة حتى أخرج من هذا "المخزن" وأستعيد تدريجيًا القدرة على التعامل مع العالم. وخلال تلك الفترة التهمت مئات الكتب، وكتبت الكثير من القصائد، وحاولت الانتحار ثلاث مرّات.
كان الاكتئاب بمثابة غطاء ثقيل يتكوّم فوق جسدي ويمنعني من النهوض، أمّا القلق فهو شيء ينمو تحت الجلد، بهدوء ورويَّة، منتظرًا الفرصة المؤاتية حتى ينقض عليك ويبدأ بالتهامك. قد تبدو الأسباب التي تستفز القلق تافهة للغاية، كأن تتأخرين أو تتأخر عن موعدك لخمس دقائق وعوضًا عن التعامل مع الأمر ببساطة تبدأين أو تبدأ في تخيّل سيناريوهات مخيفة متعلّقة بطردك من العمل وخسارتك لمركزك ومنزلك وعائلتك. وهكذا، يبدأ القلق بتهويل الأمور، وإقفال جميع الأبواب في وجهك، والتحفز ضد الجميع، فتصل أو تصلين إلى عملك، متأخرًا/ة، ومهتاجًا/ة، وقد تتورط أو تتورطين في شجار مع مديرك، لأنه - حسب ما صوّره لك القلق - سيقوم بفصلك.
أذكر مرّة كنت في انتظار صديقتي داخل سيّارتها أمام محلّ لبيع الوجبات السريعة في مصر، انتبهت إلى أنّها لم تغلق الشبّاك، وحينها بدأ القلق في ابتلاعي. تخيّلت المارّين والمارّات بجوار السيّارة يمدّون/يمددن أيديهم/أيديهنّ لخنقي. حاولت التخلّص من هذه الخيالات المرعبة لكنّني لم أستطع فقرّرت أن أنظر بحدّة لكلّ المترجّلين والمترجّلات في محاولة يائسة لإخافتهم/هنّ. وعندما فتحت صديقتي باب السيارة فجأة، صرختُ صرخة مُدوية، وكأن مخاوفي كلها تحقّقت في تلك اللحظة. ثم عندما نظرت إلى وجهها المرتعب، أدركت أن الوحش الساكن في الداخل بدأ بالتغذي علينا.
القلق كما أعرفه هو مزيج من الخوف والتوتّر وفقدان الأمان، هو نقيض للطمأنينة، وهو أيضًا مُشبّع بالحزن القديم
أظن أن خطورة القلق تكمن في أنّه ساكن فتنسين أو تنسى تقريبًا وجوده، لكنه يصبح مع الوقت المحرّك الرئيسي لقراراتك، والموجّه الأوّل لعلاقاتك. يفكّر بالنيابة عنك، يقترب وينفصل عن الآخرين بالنيابة عنك، وأكثر ما يجيده هو أن يترك في المنتصف الأشياء التي تحبينها أو تحبها وسعيت كثيرًا لأجلها.
القلق كما أعرفه هو مزيج من الخوف والتوتّر وفقدان الأمان، هو نقيض للطمأنينة، وهو أيضًا مُشبّع بالحزن القديم. فمعظم القلوقين والقلوقات مثلي والذين تحدّثت معهم/هنّ كانت لديهم/هنّ تجربة قديمة مع الإكتئاب الحاد. واتفقنا أن أكثر ما يخيفنا هو أن يعود الاكتئاب إلينا مجددًا. لذلك فحتى لو ادعينا بأننا شفينا من الاكتئاب، فإننا في أعماقنا لا نزال خائفين من عودته.
أعتقد أن مشاعر القلق بدأت تجتاحني منذ الطفولة وازدادت في سنّ المراهقة عندما أعلنت عن تمرّدي ورفضي للتقاليد والمعايير السائدة. كان القلق خبزي اليوميّ. لم نكن نستمع إلى الموسيقى في السعوديّة بشغف ومتعة بل كان القلق سيّد الموقف. وكيف لا وكُنا نهرّب الأقراص المضغوطة ومشغّلات الـmp3 الصغيرة داخل دورات المياه في المدرسة والجامعة. أشبّه قلقي دائمًا بالكلب الوفيّ الذي يتبعني أينما ذهبت هازًّا ذيله. في البيت والمدرسة والشارع. وأنا أقرأ رواية الإخوة كارامازوف خلسة، وأنا أكتب قصيدة إلى فتاة أعجبتني في الصف المجاور، وأنا أفعل كل ما لا يرضى عنه المجتمع، أو ترضى عنه العائلة.
ورغم أن مسّببات القلق قد زالت تقريبًا بعد مغادرتي للمجتمع الذي نشأت فيه، إلا أن قلقي القديم، كلبي الوفي، قد تبعني إلى حياتي الجديدة. فحين أنام، كنت أشعر به يجلس على طرف السرير مُحدّقًا في وجهي. ثمّ بدأ يأخذ أشكالًا عديدة، لأني وجدت نفسي فجأة في بلد لا أعرفه. في مدينة مثل القاهرة حيث كلّ شيء يتحرّك بسرعة، ولا ترّحب هذه المدينة أو سكانها بالبطء. فكان عليّ أن أتعلّم الركض، وأن أغيّر إيقاعي ليتناسب مع إيقاع المدينة السريع، وأن أودّع كليًّا الحياة الهادئة، والوقت الطويل الذي اعتدت أن أقضيه مع نفسي. ولم أمانع في البداية، حاولت أن أنسجم، وأحيط نفسي بالأصدقاء، وأتماشى مع إيقاع المدينة، غير أن أنواعًا جديدة من القلق بدأت بالظهور. فقد حاولت أن أحقّق - دفعة واحدة - جميع أحلامي التي لم تسمح لي البيئة السعودية بتحقيقها. بدأت أتعلّم الموسيقى، والرقص، والتمثيل، والسينما. فمنعت نفسي من جميع وسائل الراحة، وصرت أحاول أن أشبع نهمي للفن، الذي حرمت منه في ما مضى. لكن فكرة أنني متأخرة عن كل شيء بدأت تسيطر عليّ، ولم أستطع النوم أو التركيز في أيّ شيء. جعل الركض المستمر في دولاب الهامستر هذا قلقي يتضاعف، كما كان عليّ أيضًا أن أتعامل مع نوبات الاكتئاب التي تظهر بين حين وآخر. وعندما لم أستطع احتمالها، كنت أذهب لأطباء نفسيين، ومعظمهم كانوا يخرسونني بكمّيات هائلة من الأدوية، التي كنت أستمرّ عليها حتى أتخدّر تمامًا، ثم أقلع عنها وأبدأ بتعلم الحياة خطوة بخطوة من جديد.
جعلني القلق أغيّر مسكني عديد المرّات. وقبل أن أتعرّف مع الوقت على حيَل القلق، كنت أظنّ أن قرار الانتقال سيجعلني أعثر على السكينة والاستقرار. لكن بعد تجربتين أو ثلاث، أدركت أني أسقط قلقي الداخلي على الأشياء من حولي، وأني لو سكنت شقق العالم جميعها، فإنني سأظل أشعر بالرغبة في المغادرة. لأن الوحش لا يختبئ تحت السرير، بل في داخلي. لذلك ربما كنت من القلة اللواتي شعرن بالراحة أثناء الحجر الصحيّ. فقد كان حُلمًا بالنسبة لي أن أتوقف عن الركض في هذا الماراثون، من دون أن أشعر بأن شيئًا ما سيفوتني. وحتى الحياة الاجتماعية كانت تشكّل عبئًا ثقيلًا عليّ، وجعلني التخفف منها في غاية السعادة.
هذا القلق حصيلة للعالم المتعجل، الذي يحرص على شحننا دائمًا بآخر الأخبار وآخر الصيحات وآخر التطورات
يُقال دائمًا أننا بنات وأبناء عصر السرعة، وأحد أصدقائي الشعراء يصف نفسه بأنه: "قلق ومتعجل". وأظن أن هذا الوصف يمكن أن ينسحب على جيلنا بأكمله. إحدى الفتيات المؤثرات على أنستجرام، والتي لم تتجاوز الواحد والعشرين من عمرها، خرجت ذات مرة في بثّ تقول فيه للمتابعين والمتابعات: "لا يوجد وقت! انهضوا، واعملوا، وطوروا أنفسكم". أدركت أن جملة "لا يوجد وقت" هي أنسب شعار لعصرنا. نعي جيّدًا أن هذا القلق حصيلة للعالم المتعجل، الذي يحرص على شحننا دائمًا بآخر الأخبار وآخر الصيحات وآخر التطورات، وأن العالم الحديث اشترى السكينة مقابل الإنتاج، وأن الكآبة التي يقع فيها معظم بنات وأبناء جيلنا هي نتيجة فكرة أننا لسنا جيّدات وجيّدين كفاية.
لكن كان لا بد من التفكير طويلًا، ومحاولة موازنة الأمور. وجدت شخصيًا بعض الراحة في ترتيب أولوياتي، وتأجيل بعض الأحلام، والتخلّي طوعًا عمّا ليس لي. فكثرة الخيارات ولّدت لدينا إحساسًا بضرورة تجربة كل صنف على المائدة، لكنّي أدركت أن هذا ليس ضروريًا. تخلّيت عن بعض المشاريع للتركيز على مشاريع أخرى، وقلّلت الاستهلاك، وركّزت فقط على ما أحتاج إليه. وهذا ينطبق على كل شيء تقريبًا، حتى على الأحلام والصداقات. أحاول أن أتوازن، وأمنح نفسي وقتًا ضروريًا للراحة، وأحرص على وضعه ضمن جدولي.
لم أعد أمانع التخلي عن سهرة ما فقط لأجل أن أنام، أو أشاهد فيلمًا، كما أنني لم أعد أستهين إطلاقًا بأي إنذار داخلي بالتعب أو الإنهاك. لا أقول إني شفيت من القلق، لكن عندما أدركت أنه يستمد قوته من الماضي أو المستقبل المجهول، حاولت العيش كما لو أنّ الإثنين غير موجودين. فالماضي انتهى، والمستقبل لا يجيء، والحياة هي الآن وحسب، وما دمت بخير الآن، فلا يوجد ما أقلق عليه. أعمل ببطء، لكن بثبات، أعيش اللحظة، وأستمتع، وأنتقي أحلامي وأصدقائي، ولا أفضِّل شيئًا أو شخصًا أو حلمًا على سلامي النفسي. ومع الوقت، تصالحت مع فكرة أنني قد لا أحصل على كلّ ما أرغب فيه، وأن هناك أحلامًا ستفوتني، وأن الخسارة جزء أصيل من هذه الحياة. وأنه لا بأس إذا جاءت حياتي الحلوة إليَّ، ولا بأس إذا لم تأتِ أيضًا.
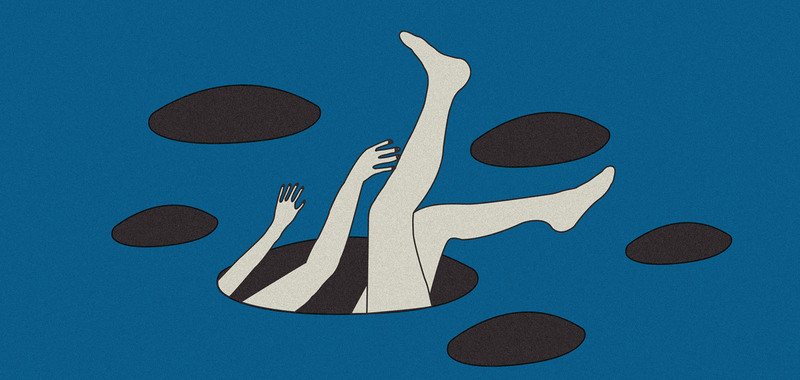


التعليقات
معبر عما يجيش بداخل الكثيرين وأنا منهم، أوجعتني الكلمات وكأنها صوت عقلي الذي يضرب بسوط ليترك علامات لا تزول إلا بالزمن.
رائعة جدا آلاء
إضافة تعليق جديد