لم تخبّئني جدّتي في رحمها بعدما تقلّص. أغمضت عينيها وكأنّما تخاطب الأبد بإذعانٍ، مقبّلةً إياه من بين وجنتيه السّمجتين. أسدلت بياض يديها بتسليمٍ يتوق إلى أيامٍ بعيدةٍ عن مرأى جدّي وشجر التّفّاح في جَلِّه. سلّمت على أمّها دون أن تخاف علوّ فستانها عن ركبتيها الكاملتين في استدارتهما. عانَقَتها بحرارةٍ وأعطتها الرغيف المحشوّ بالبرغل في حقلٍ لا أشواك فيه. لم تعد جدّتي إلى بيتٍ لا يألف شعرها العطر بالتفافه الخنوع. بيتٌ شهد على كدماتها المرقطة ازرقاقًا وأطفالها المجهضين ضربًا.
"فرِدي وِجّك عمتو!"
قبل الدفن بقليل، أحاطتها النساء كأنهن في طواف. جلسن قربها ودعَون لها بدخول الجنة. شعرت بأنني مرغمةٌ على رثائها بطريقتهنّ، كي أنال رضا الأعين المتفحّصة. رأيت نساءً لم أرهنّ من قبل. ادّعين معرفتها وحبها. رأيت بعضهنّ منهمكات في إشعال سيجارةٍ تلو الأخرى. رأيت أمهاتٍ يبحثن عن زوجاتٍ محتملاتٍ لأبنائهن بين الفتيات الحاضرات. سمعت نمائمهنّ وضحكاتهن الخافتة، كما لسعت أذناي أعذارهن المبتذلة للاستئذان. لكنهنّ في النهاية أدّين واجب العزاء.
رمت عمتي الكبرى مسبحةً في كفّي وحثّتني على تحريك حُبيباتها. كما لقّنتني عمّتي الوسطى بعض العبارات الدينية التي تمتمتها بطريقةٍ آلية وأنا أحمل أقراص المعمول المكدّسة فوق بعضها البعض. لم أحضر مجلس عزاءٍ قط ولا أعرف طقوسه. استقمت بين فناجين القهوة خاصّتهن. دُفِنتُ معها تحت ملاءاتٍ بيضاء تغطّي رؤوسهم العارية بخجل. وعيب. لم أُرحم لأنّهم أكثروا من تلاوة آياتهم فوق رأسي. أردتهم أن يتوقّفوا، رجوتهم، انقطع صوتي، لكنّهم رفضوا الاستماع إليّ. قالوا لي: "أتعترضين على حكم الله وأمره؟" أأصدّقهم أم أصدّق الله؟ لم أسبح في بيابي أعينهم الدّامعة، لأنّ السّيل المتدفّق منها نجس. والله لا يحبّ النّجاسة. هكذا قالوا لي. أخذني الله من يدي الرّخوة المنسدلة على فخذي الأيمن، الّذي استكان بدوره على توأمه الأيسر وسحبني بعيدًا عن شهاداتهم. لم يتركني مرميّةً على كراسيهم الباردة وغير المتّزنة، بل جعلني أمسك بيديها وشرايينهما البارزة بإحكامٍ شَرِهٍ وهي تخطو بخوفٍ من السّقوط. لم تكن مندفعةً ووقحةً كالأطفال، كجدّي. "هَدّيني يا ستّي، بدّي طلّ عالصّابونات".
لقد أخرج أبي صناديق الصّابون الّتي لطالما خزّنتها جدّتي ورصفتها بحبٍّ وعنايةٍ. أخرجها لتختبئ في رحم الشّمس لأوّل مرّةٍ بعد رحيلها، كي لا ينهش العفن أسطحها الملساء وأطرافها الملتوية تارةً والمقضومة تارةً أخرى. رأيتها مرصوفةً على درابزين سطحنا الملتصق بجَلّنا المتروك. كانت كعوب معظمها ملوّنةً كقلب بطّيخةٍ غير يانعة. لم أعهدها كذلك. أيمكن أن تكون قد حزنت على فراق الأيدي الّتي كانت تمشّط جسدها وتزيّن محياها؟ لربّما بكت أيضًا، بكاءً صادقًا لا يشوبه العجز. على خلاف نفاقهم المعزّي وقذارته الّتي تهلّل لها الأعين وتصفّق لها الأيدي حتّى الاحمرار. تذكّرتها وهي تفرك شعرها برغوته العاجيّة. كما تخيّلتُها تسكب الماء السّاخن على جسدي الأسمر وشعيراته الملساء بعد تمريرها اللّيفة فوقها مرارًا. يشتاقها جلدي وهو ممدّدٌ فوق رائحة سريرها السّرمديّة، وإن غُسِلت شراشِفهُ بِدأَب. يشتاق رائحة جلدها. يابسةً. دافئةً. كالحطب. كالبيوت. أشتاقها وهي تعتصر قميصها الملطخ بقهوتها الصباحية. لم تشبه مصاحفهم وإن غفت قربها، وفوقها. وإن قبّلتها. وإن استكان رأسها على صفحاتها الّتي لم تفكّ حرفًا منها، بل تمتمتها بصمت. وإن أصمّ العالم ضجيج تكبيرها الخافت ابتهالًا "اللّه أكبر"، فأطال الله شعري الذي نبذني المكان لغرابته، وسرّحني من بنطالي الواسع الّذي ابتلعته المحدّقات بقرف، فقد نسيت بنطالي الضّيق في بيروت يومها. لم أدرِ أنّ جدّتي ستموت وأنّ على موخّرتي أن تبدو ناتئة الجمال في عزائها. فارتديت قميصها الأسود الوحيد، وبكيت. بكيت فيه كثيرًا، ثورةً على طلب عمّتي وهي تعتصر وجنتاي الرّطبتين بكفّها القاحل "فرِدي وجِّك عمتو!".
شمسي الزرقاء
بعد أشهرٍ عدّة وعند خلودي إلى النّوم، أجبرت جسدي المنهك على الخضوع لفراشي الزّهريّ اللّون. اضّجعت بين الشّراشف الباردة كجذع شجرةٍ مغروسٍ بين الأتربة. لم أنم على جانبي تلك اللّيلة، كما لم تداعب برودة الشّراشف أسفل بطني المكشوف عن غير قصد. نمت على ظهري وتركت قدماي حرّتان لتداعب إحداهما الأخرى. لم ألتفّ على نفسي كأفعى، كما يقول أبي. لم تلتصق أجزائي المبعثرة ببعضها البعض. لم تحتمِ برودة أصابع يديّ بحماوة فخذيّ. لم أرتجف. لم أخف من الصّقيع أو المطر. لم ألعن الشّتاء ليلتها. بل اكتفيت بأن أكون أنا، وحدي، في ذاك الفراش الّذي حاول مرارًا أن يكون بيتًا لي. واستكنت إلى لعبتي، الّتي لم تفارق هشاشتي بعد. عندها أمعنت النّظر في الضّوء الوحيد الّذي ينير الغرفة ووجدت جدّتي في زرقته الّتي عانقتني. وجدتها تلوّح لي وتفتح ذراعيها كالشّمس. وجدتها هناك، تحتويني بخشوع آياتٍ لم أتلُها قبل أن أغفو.
ــــــــــــ رسالة إلى تيتا نظيرة
"أحيانًا أجدني أبحث عن مناديلكِ البيضاء في أمكنةٍ منسية لا تنام. أحيانًا أخرى أجدني أشمئز من صوت جدي الجهوري الذي قمع لغتكِ البكماء. كم أودّ أن أمزّق هذا الكتمان عنكِ! أودّ أن أنتشلكِ من هذا الصّمت الكسيح الّذي طالما هدهدكِ في سريركِ الهَرِم. أودّ لو تذهبين معي إلى البحر الذي لم تريه يومًا. زرقته تشبهكِ، تشبهكِ كثيرًا، هامدةٌ ومتقلّبةٌ وبعيدة، مثلكِ. تيتا، ما زلت أسمع ابتهالاتكِ إلى الله بعد كلّ آذان. ما زالت وصاياكِ تتردد على مسمعي: "بدك تضلي متل سبلة المي مع الكل وهيدا صعب، صعب تيتا". ما زلت أرى قهر نساء الأرض فيكِ. ما زلت أغفو قرب وسائدكِ المطرّزة على أيدي أخواتكِ. وأبكي في مواسم الزعتر والزيتون، وبعد افتراش السجاد وإشعال موقدة الحطب. ما زلت أذوب مع رمادها وأمّحي قبل استيقاظكِ عند الفجر لتنظفيها. جدتي، احتفظت بجواز سفركِ الذي لا يحمل تاريخ ميلادٍ محدّدٍ لك. ألهذا كنتِ تمقتين الأعياد؟ أعتذر عن المرة التي نسيت فيها أنكِ أمّيّة – "أهلي ما علمونيش القراية يا حسرة" – وعن تذمري أثناء مكالماتنا الهاتفية. شكرًا لأنكِ لم تحلّي مكان والدتي الغائبة، بل اكتفيتِ بكونكِ جدّتي. رأيتكِ في منامي منذ بضعة أيّام. كنتِ تبتسمين بحرارة أثناء توديعكِ لي: "بدِّك شي منّي يا ستّي؟" عندها رجوتكِ أن تظلّي هنا. جاء جوابكِ مقتضبًا وفرحًا "يا ريت بس أنا ما فيني". أيعقل أنكِ أردتِ الرحيل؟ من التي ستستقبلني الآن وهي تنادي "شمس وشارقة"؟، أذكر صدمتي حين عدتُ مرّةً من بيروت في نهاية الأسبوع لأجدكِ تعوّلين على عكازٍ خشبيٍّ لا يشبهكِ. شعرت يومها باضمحلالكِ أمام عينيّ، شعرت بأنّكِ تتسللين من بين أصابعي إلى نهايةٍ لا قعر لها. وحين مرضتِ أُصبتُ بحالةٍ من النكران الأبله. كيف لقواكِ أن تخور؟ فجدتي لا تعرف الضعف، ولا الموت، تمامًا مثل بيروت. أعتذر لأنّ جدي هو الذي نعاكِ حتى أصمّ دويّ المئذنة بيوت الضيعة وأهلها. أعتذر لأنّ معذّبكِ كان آخر من لفظ اسمكِ. أكتبكِ الآن وأكتب عنكِ لكي أتشارككِ مع العالم. ولأن نساءً مثلي يكتبن عن نساءٍ مثلكِ، لعلّهنّ يتحرّرن من الأكفان التي أُجبرن على الالتفاف داخل شرانقها وهن على قيد الحياء. أكتب إليكِ لأنكِ سُلبتِ حياتكِ وحُرمتِ منها. أكتب إليكِ مع يقيني الكامل بأنكِ لن تقرأي، لكن لعلكِ بذلك تحيين تحت الثرى".

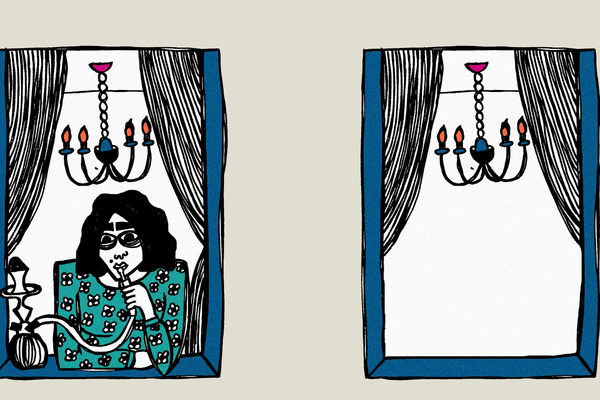
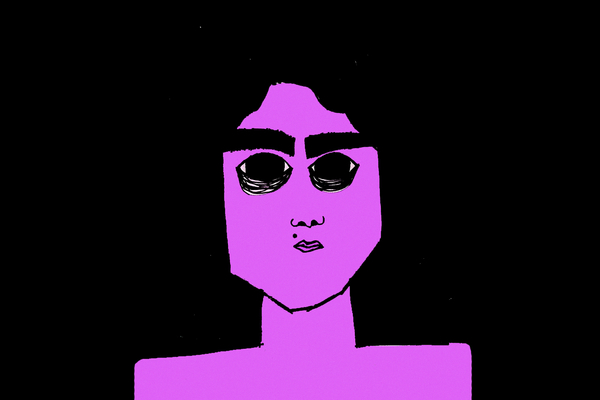
التعليقات
اكثر من رائعه...لقد اعطيت الحق والصوت الحر لروح طيبه كروحك...لروحها السلام ولكل النساء اشباهها...
وصف جميل وسرد متداخل مفعم بالوصف الحي ...رائع عزيزتي
إضافة تعليق جديد