يستكشف في هذا المقال أستاذ الفلسفة والباحث في الدراسات الجندرية، حازم الشيخاوي، علاقة مادة الرياضة في النظام التربوي بالصناعة الجنسانية والجندرية.
السؤال الذي أطرحه كلما شرعتُ في تدريس الأقسام النهائية: هل من الممكن فعلًا أن أفصل بين ما أنا عليه كمناضلٍ نسوي تقاطعيّ مُهتمٍ بالدّراسات الجندرية من جهة، وكمُدرّس الفلسفة الذي تلقى تكوينًا في دار المعلّمين العليا1 من جهةٍ أخرى؟ أين تكون الأولوية للبراديغمات الكلاسيكية والأسئلة المُطلقة؟
السؤال قطعًا لا ينبع من فراغ، بل هناك عودةٌ إلى المسار الذي نحن فيه وتكويننا الفلسفي. لقد ترك ميشال فوكو (Michel Foucault)2 أثرًا كبيرًا في نظرتنا إلى العالم، لاسيما فكرته عن تقاطع البُنى التي تهدف إلى ترويضنا. طبعًا، هذه العودة إلى الفلسفة البنيوية وما بعدها هي دليلٌ على رفضنا التقوقع داخل النسق الكلاسيكي في التفكير، حيث نعتقد أن الفلسفات القديمة لم تنتبه إلى الفرد بما هو قيمةٌ أو مرجع، ما أفضى إلى التفكير في شؤون الجماعة فقط. لكن الانطباعات والشعور والذكريات هي مسائل يجب أن نقوم بأشكَلتِها والبحث فيها.
ما تتيحه الدراسات الجندرية والنضال التقاطعي النسوي-الكويري هو تفكيكٌ للنُظم والبُنى، وإعادة قراءةٍ للمنظومة الأبوية والهيمنة الذكورية، لا في مجال الحيوات العامة فحسب، بل أيضًا داخل البناء الإبستيمولوجي: هيمنة الحقيقة في صيغتها الميتافيزقية. هذه المسألة تُمكّننا من إعادة مداورة إشكالية "طغيان العقل البطريركي" في مجال تكويننا الرمزي (اللغة - العادات - التقاليد) والعمَلي على حدّ السواء.
هل يمكننا، إذًا، أن نقيم تجاوزًا بين هذا وذاك، بين ما كنّا عليه، ما نحن فيه وما نطمح إليه؟
بين المدرسة ونقيضها
التدريس في البداية لم يكن بالنسبة لي منطلقًا للتفكير الفلسفي، بل لعلّه كان ضرورةً لكسب قوت العيش. لكن ما إن انطلقتُ في هذه التجربة حتى تفطنتُ إلى أن الهاجس الفوكوي يرافقني: التدريس هو عمليةٌ تفكيكيةٌ بما هو مجابهةٌ للبُنى الاجتماعية و"ميكروفيزياء السلطة".3 أرى متعلماتٍ (نسبة حضورهنّ مرتفعة جدًا) ومتعلّمين (نسبة حضورهم منخفضة جدًا ويفضّلون المقهى على المعهد) متأثراتٍ ومتأثرين بعادات العائلة، يتعاملون مع العِلم كمطيةٍ للتقدم على سلّم النجاح وافتكاك نوعٍ من الاعتراف الذي لا يملكنَ/يملكون غيره.
أجد نفسي متماهيًا جدًا مع بيار بورديو (Pierre Bourdieu) في قوله: "المدرسة لا تقدّم أي رسالةٍ تربوية، بل كلّ ما هي قادرةٌ على تقديمه يتمثل في إعادة إنتاج الفصل والتمييز الطبقي، وبثّ العنف الرمزي والثقافي في كافة تجلّياته".4
لم يعد المُتعلم/ة اليوم في حوارٍ مباشرٍ مع ميثيةِ أو أسطوريةِ "الرسالة التربوية القومية"، بل هو بالأحرى في حوارٍ يومي مع ألعاب الفيديو، والمسلسلات الأجنبية، والموسيقى الغربية ورسائل المؤثّرات والمؤثّرين على مواقع التواصل الاجتماعي
يبدو هذا التصريح للوهلة الأولى راديكاليًا جدًا، لكنه في الحقيقة، واقعٌ فعلي. لا يمكنني الاقتناع بأنّ المدرسة قادرةٌ على خلق "العقل التونسي". لقد كانت المدرسة عاملًا أساسيًا في بناء دولة ما بعد الاستقلال التي تقهقَرَت في صرامتها تجاه مسألة "التحديث"، وانقلاب 87 الذي أعاد تأسيس جوهر التعليم على قواعد "العودة إلى الهوية العربية الإسلامية" و"النمط التونسي" الهجين المتأثر تارةً بثقافة الأنوار، و تارةً أخرى بمحاولة تجذير "الإسلام النيّر القابل للتأقلم". لكن الأمر الأكثر تعقيدًا هنا، يتمثّل في فشل المدرسة اليوم في أداء دور التنشئة، وعدم قدرتها على مجابهة مخاطر العولَمة.
لم يعد المُتعلم/ة اليوم في حوارٍ مباشرٍ مع ميثيةِ أو أسطوريةِ "الرسالة التربوية القومية"، بل هو بالأحرى في حوارٍ يومي مع ألعاب الفيديو، والمسلسلات الأجنبية، والموسيقى الغربية ورسائل المؤثّرات والمؤثّرين على مواقع التواصل الاجتماعي. هنّ/م في غربةٍ بين واقعهنّ/م وصورة العالم. لكن هل يكفي ذلك لزعزعة هيمنة الجندر الذي أصبح اليوم "شعبيًا" بفضل هذه الوسائل والتقنيات التي تتيح لنا معرفةً غير محدودة؟
الجسد، الفكر والتعليم
المدرسة هي المجال الذي نجتازه جميعًا والذي حتمًا لا يمكن الهروب منه. إنها إحدى أهم ركائز تثبيت التراتبية وإعادة إنتاج طبقات المجتمع، أو إنتاج شيءٍ من رأس المال الثقافي والرمزي في تمظهراتٍ أخرى، كما يقول بيار بورديو.5 في الذهنية العامة، يُقال دائمًا "كاد المُعلّم أن يكون رسولًا"، وربما هنا بالذات يمكن أن نقتفي ضربًا من الطقسية والفاعلية الاجتماعية للمدرسة: فالرّسول يأتي لهداية الناس والإلمام بهم/ن، والمعلّم/ة أو المدرّس/ة يمتهن حرفة صناعة الأفراد [في الحالتين، تنصاع جندَرة المُفردة عند العامّة لغلَبة المُذكر].
هذه الفَبركة فيها شيءٌ من الطابع السياسي أيضًا، إذ لا يمكن أن نتخيل أن للسلطة مركزًا واحدًا، فهي مقسّمةٌ ومبثوثةٌ في كافة البُنى، والمدرسة تهتمّ بتشكيلها ضمن رؤيةٍ جماعية، وتعمل على ترويض الأفراد ضمن محدّداتٍ موجودةٍ مسبقًا. ويتجلّى هذا الفعل التحكّمي-السياسي على صعيدَي الفكر والجسد عبر ترسيخ المبادئ والمعارف المُتفق عليها من جهة (الدين، الوطنية، العلوم الطبيعية-الفيزيائية، الرياضيات والفنون)، وصقل الأجساد من جهةٍ أخرى.
لا يمكن أن نتخيل أن للسلطة مركزًا واحدًا، فهي مقسّمةٌ ومبثوثةٌ في كافة البُنى، والمدرسة تهتمّ بتشكيلها ضمن رؤيةٍ جماعية، وتعمل على ترويض الأفراد ضمن محدّداتٍ موجودةٍ مسبقًا
تفطنتُ إلى هذا الأمر عندما عادت بي الذاكرة إلى سنوات دراسة مادة التربية البدنية. لاحظتُ في البداية أنّ التعامل مع هذه المادة كان تعاملًا فعليًا مع البدن، أي بما هو أعضاءٌ وكتلةٌ من العظم واللحم، أو بما هو طولٌ وامتداد، ولم يكن تعاملًا مع الجسد بما هو حاملٌ للأفكار، ينفعل ويتفاعل. كنّا إذًا في نوعٍ من العلاقة الميكانيكية مع أجسادنا، وكان ذلك غريبًا جدًا بالنسبة لي لأنّي كنتُ دومًا أكثر ميلًا إلى القدرات العقلية، وما زلتُ حتى اليوم لا أستسيغ علاقة التربية بالبدن! ربما هي علاقةٌ على مستوى التحكّم والصناعة فقط.
لقد كان فضاء هذه المادة أيضًا مخالفًا لكافة المواد الأخرى، ويتجسد ذلك بدايةً في التقسيم المعماري، إذ تُدرّس كافة الدروس في جزءٍ من مساحة المدرسة أو المعهد، بينما يُفرد لمادة التربية البدنية مجالٌ مخصّصٌ لها، شبه منفصلٍ عضويًا عن الفضاء المدرسي، كما لو كانت تستأثر بسلطةٍ لوحدها! فالعبور من مادة الرياضيات، أو الآداب أو الفيزياء مثلًا إلى مادة التربية البدنية كان يستدعي نوعًا من الطقسية الجماعية، حيث يتخلى الجميع عن الأدوات الكلاسيكية (أقلام، كراسات، كتب...) والزّي اليومي المُعتاد، وينتقل إلى مرحلة تهيئةٍ تسبق الحصّة، كما لو كانوا جميعًا يتنقّلون بين فضاءاتٍ رمزيةٍ ومعايير مختلفةٍ تمامًا.
إنّ الدخول إلى فضاء مجال التربية البدنية يتطلب بدايةً فصلًا جندريًا، حيث يذهب الفتية إلى حجرة تبديل الملابس المخصّصة لهم، والفتيات إلى حُجرةٍ أخرى خاصةٍ بهنّ. وكانت هذه الغرف بمثابة مساحةٍ لقياس مدى تطوّر فاعلية الذكورة والجنسانية بين التلامذة، لأنها كانت تجمع دومًا أفرادًا من مستوياتٍ وأعمارٍ مختلفة. وكانت ثمّة أسبقيةٌ عُمريةٌ بين الذكور تحدّد الطرفَ المُهيمِن، أي ذلك الذي يستطيع أن يبسط رؤيتَه للذكورة عبر جسده، وتحديدًا عن طريق إعادة إنتاج صورٍ اجتماعيةٍ مستهلكةٍ إعلاميًا (جسدٌ ممتلئ، عضلاتٌ بارزة، بنيةٌ متينةٌ وربما لحيةٌ غير مكتملة).
ما يدهشني عندما أعود إلى تحليل تلك الصور أن المجال الوحيد الذي شهد نوعًا من الثقافة العريانية كان حُجرة تبديل الملابس. لم نكن لنرى جسدًا آخر يختلف عنا إلّا في تلك الغرفة. أشرتُ أعلاه إلى نوعٍ من الطقسية يرافق الاستعداد لحصّة التربية البدنية، وهو ما كان يحصل فعلًا من خلال نزع الثياب المعتادة وارتداء الزّي الرياضي المُخصّص لهذه الحصّة. لكن هذا الانتقال من الانتماء إلى الفضاء العام والمدرسي إلى مجالٍ ضيقٍ للذكورة، كان فيه نوعٌ من التلذّذ بالعُري، وما زلتُ أذكر قصصَ استعراض البعض حجمَ قضبانهم أو ملامسة الأعضاء الحميمة في ما يشبه المشهدية البورنوغرافية، أو استعراض الشَعر في أماكن مختلفةٍ من الجسم. يحدث كلّ ذلك في إطار نوعٍ من الاحتفالية بالجسد، لكنها تبقى ضمن سياق صناعة محدّدات الذكورة، وفي ذلك شيءٌ من التنشئة التي تهدف لإرساء "الرجولة" بما هو مصطلحٌ ومفهومٌ شاملٌ للذكورات، والذي يمكن اعتباره المسار البنائي للفرد المُذكّر.
تعمل الأنشطة الرياضية بدورها على تثبيت التمييز الجندري، حيث يعمد مدرّسو/ات هذه المادة إلى فصل المتعلّمين/ت إلى مجموعاتٍ بحسب الجنس البيولوجي، وتُسند لكلّ فئةٍ أعمالٌ خاصةٌ بها
هذا البسطُ للذكورة يلازمه أيضًا حجبٌ للأنوثة إذا ما لاحظنا أنّ باب غرفة تبديل الملابس الخاصة بالفتيات لا يُفتح أبدًا إلّا للخروج، عكس الفتيان الذين كانوا يتركون باب حُجرتهم مفتوحًا جزئيًا في ضربٍ من الكشف عن عالمهم ذاك. هكذا، تعمل الأنشطة الرياضية بدورها على تثبيت التمييز الجندري، حيث يعمد مدرّسو/ات هذه المادة إلى فصل المتعلّمين/ت إلى مجموعاتٍ بحسب الجنس البيولوجي، وتُسند لكلّ فئةٍ أعمالٌ خاصةٌ بها، فتوكل للفتيان أنشطةٌ تتطلب جهدًا بدنيًا مضاعفًا، بينما توكل للفتيات أنشطةٌ تتطلّب الحد الأدنى من الجهد. يمثّل هذا الأمر نوعًا من الوصم المبني على أساس الجنس يؤسّس للتباين بين ثنائياتٍ متضادّةٍ مثل قوي/ضعيفة، مجتهد/متراخية، صلب/ليّنة، إلخ.
إنّ "حقيقة البدن" التي طرحناها في بداية هذا المقال هي الحقيقة الزائفة، فالبدنُ مبنيّ على تصوّر العقل البطريركي الذي يصنّفنا ويشكّلنا وفقًا للإنتاج الاجتماعي والرؤية السياسية ومنظومة العادات والتقاليد المهيمِنة. إنّ مساحة تفكير الذات في إطار السردية الذاتية قد مكّنتني من التفطّن إلى أن التعليم في مجال بناء المعرفة، لا يقدّم لنا ما يسمح بتفكيك البُنى الأولية، لأنه ببساطةٍ مرآةٌ تهذّب صورة الفضاء الخارجي. ففي المجال المدرسي، نتعلم كيف نوظف مجموعةً من الكفايات مثل القراءة والحساب وبناء معادلاتٍ رياضيةٍ من الدرجة الأولى أو الثانية، لكننا لا نفكر في ماهية أنفسنا، ولا تُتاح لنا الفرصة كي نقوم بنوعٍ من الهجرة نحو الآخر/الأخرى أو تدبير ذواتنا (في استعارةٍ لتعبير "تدبير المتوحد"6). وتكشف مادة التربية البدنية هذا الأمر بوضوح: كنا نعتقدها مساحةً للترفيه بعكس كلّ المواد المملّة الأخرى، لكني أكتشف اليوم أنها الفضاء الذي يُتيح "إتقان" الوعي الجماعي للذكورة والأنوثة. إنها تمامًا مثل الغرفة رقم 101 7 في ديستوبيا '1984' لجورج أورويل (George Orwell): مجالٌ لترهيب البدن، سواء بحشره مباشرةً في عالم الذكورة/الأنوثة أو بنفيه منه، فلا يمكننا تخيّل إمكانية أن تعثرَ التعبيراتُ الجندرية المختلفة عن السائد على مكانٍ لها في ذلك العالم. إذًا، لا يكتفي التعليم برسم الحدود الجندرية الكلاسيكية فحسب، بل يمثّل أيضًا التعبيرة السياسية التي نجدها في عمق الرؤية المعرفية.
السؤال الواجب طرحه هنا هو: هل المعرفة منفصلةٌ عن الهيمنة الذكورية؟ بالمطلق، الإجابة هي قطعًا لا، لاسيما عندما نهبطُ بالمنظار الجندري إلى فضاء التفاعلات اليومية بين الأبدان. في هذا السياق، لا يهدف هذا المقال إلى تناول علاقة التعليم بالجندر عبر مثال مادة التربية البدنية فحسب، بل هدفه أيضًا الإشارة إلى تجاربنا والسرديات التي يمكن أن نرويها في إطار بناء المعنى، ما قد يسهّل الحديث عن الجنسانية وعلاقتنا بأجسادنا وتمثلاتنا له، ويتيح لنا فهم التجارب المؤلمة مع التحرش الجنسي أو العنف، فهي أيضًا ذكرياتٌ قد نفهم من خلالها صيرورةَ هذا العالم ونفكّ رموزه. بناءً عليه، تكمن مهمة التحليل الجندري النقدي في تفسير الواقع المُعاش بغرض تجاوز تلك الهيمنة.
- 1تعريبٌ للاسم الفرنسي L’Ecole Normale Supérieure، وهي النواة الأولى للجامعة التونسية، تأسّست عام 1956، وهي نسخةٌ من إحدى أعرق مدارس التكوين الفرنسية. تهتم هذه المؤسسة الجامعية بإعداد طالباتٍ وطلبةٍ في مجال العلوم الإنسانية (فلسفة، تاريخ، جغرافيا) واللغات (العربية، الفرنسية، الإنكليزية) والرياضيات والفيزياء. وتهدف هذه المدرسة إلى تقديم تكوينٍ علمي متينٍ كي يصبح المُتتلمذون/ات فيها أساتذة تعليم ابتدائي وتعليمٍ عالٍ في مختلف المؤسّسات التربوية والجامعية التونسية.
- 2في هذا الإطار، يمكن أن نُذكّر بالجدل الذي دار مؤخرًا بشأن ميشال فوكو وعلاقته بالبيدوفيليا. ربما يبدو هذا الموضوع جديرًا بالذكر لأن كثرًا خلطوا بين مدونة الفيلسوف والاتهامات غير المبرّرة التي أطلقها ضدّه غي سورمان (Guy Sorman)، المفكر النيوليبرالي الفرنسي. نحن نتخذ موقفًا صريحًا في الدفاع عن فوكو نظرًا لغياب الأدلة، وإذا أراد القارىء/ة الاطلاع أكثر على الموضوع، يمكنه/ا قراءة مقالنا الصادر في جريدة ’الشارع المغاربي‘ (الصفحة 25) من خلال هذا الرابط.
- 3يُعد هذا المفهوم أحد الركائز الأساسية في فلسفة فوكو، إذ بيّن من خلاله أنَّ السلطة لا يمكن أن تتجسّد في الدولة فقط، أو في فردٍ واحدٍ فحسب، إنما هي مبثوثةٌ في كافة البُنى الاجتماعية، الاقتصادية والثقافية-الرمزية. إذًا، لم يعد من الممكن الحديث عن تجلٍ واحدٍ لعلاقة الصراع، فقد بيّنت فلسفة فوكو أنَّ مدار الخصومة بين حاكم/ة ومحكوم/ة أو مهيمِن/ة ومهيمَن/ة عليه/ا، موجودٌ في مختلف مجالات التفاعل الإنساني والبشري، وبذلك يكون قد تجاوز أكثر الفلسفات اشتغالًا في هذه الإشكالية، لاسيما الفلسفة الماركسية. للمزيد عن هذه المسألة: Christian Laval, "La productivité du pouvoir”, Marx et Foucault, lectures, usages et confrontations, éd. La Découverte, 2015, pp 29-44
- 4Vincent Troger, “Bourdieu et l’école : la démocratie désenchantée”, Pierre Bourdieu, son œuvre, son héritage, éd. Sciences Humaines, 2008, pp 25-35
- 5Pierre Bourdieu, 'Raisons pratiques', Seuil, 1994, p.161
- 6أردنا العودة إلى عبارة أحد أهمّ كتب ابن باجة ’تدبير المتوحد‘، والغاية أن نفهم سياقيًا أنّ الذات هي التي تدبّر شؤونها في حال تمّ تحصيل المعنى، ونعني بذلك الانعتاق من الأطر التحكّمية والمُهيمِنة، بحيث يكون الفرد هو مؤسّس/ةٌ لأفعاله/ا وغاياته/ا من دون التقيّد بأيٍ من بُنى الهيمنة. المصدر: ابن باجة ، 'تدبير المتوحد'، تونس، دار سيراس للنشر، 1994.
- 7في رواية جورج أورويل '1984'، الغرفة 101 هي بمثابة غرفة تعذيب يتم إرسال بطل القصة وينستون سميث إليها كي يخضع لعملية إعادة تأهيلٍ بقصد إدماجه لاحقًا في المجتمع.
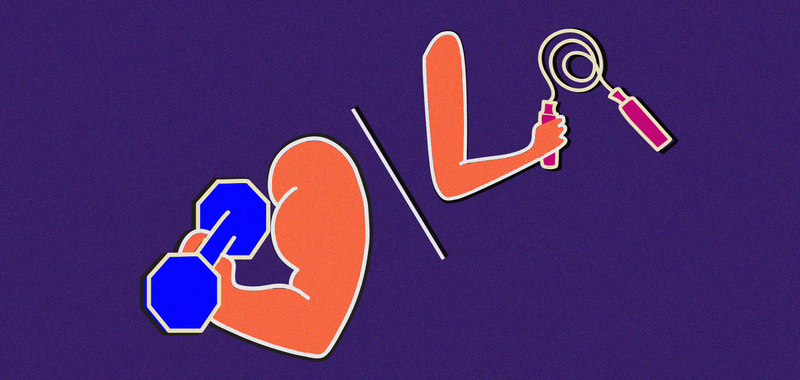


إضافة تعليق جديد