"بدأتُ أحملها بنفسي إلى الطابق الأرضي، كلّ صباح، ثمّ أعود وأصعد بها إلى الطابق العلوي، كلّ مساء، وأحيانًا، عندما كنتُ أحملها لأصعد بها، وأشعر أنّها كانت تبدو أخفّ ثقلًا بين يدي، كان يداهمني شعورٌ أليمٌ ومميتٌ، كما لو أني كنتُ أصل إلى صقعٍ مُتجمّدٍ من دون أن يكون مرئيًا، فيخدّر حياتي".
- شارلز ديكنز، "ديفيد كوبرفيلد"1
**********
لم تكن دورا بين ذراعَي كوبرفيلد في أفضل أحوالها، يُغلّفها الوهن والقُرب من الموت. مع ذلك، كنت أحبّ قراءة هذا المقطع في مراهقتي، وأعيد قراءته مرارًا لأشعر خلاله بالحبّ والإثارة. وعلى الرغم من وجود قُبلاتٍ وعناقاتٍ عدّة في الرواية، إلّا أنّ هذه السطور تحديدًا لا تزال أوّل ما يمرّ في بالي حين أتذكّر اكتشاف نفسي وجسدي وبيئتي في خلال مراهقتي.
ربّما تكون حميميّة ورهافة تشارلز ديكنز (Charles Dickens) هي ما أثارَ حواسي في ذلك العمر الصغير. كانت تأسرني معرفة أنّ الحبّ سوف يجعل شخصًا ما يعتني بي في مرضي. يحملني إلى غرفتي. يتلاصق جسدانا معًا. وأسند رأسي على قلبه. لذلك اتخذتُ الرواية أسفل وسادتي مسكنًا، مثلما يفعل والداي بكتبهما. على الرغم من ذلك، استبدلتُها لاحقًا بمطبوعاتٍ عديدةٍ تعرّفتُ إليها تدريجيًا في خلال مراهقتي، بعضها كان جريئًا، وبعضها الآخر كان يغلب عليه التزمّت؛ لكن جميعها كانت تفتقر إلى المعرفة الصادقة التي كنتُ أحتاجها كمراهقةٍ يتغيّر جسدها وعقلها بشكلٍ سريع، من دون أن يحدِّثها أحدٌ عنه.
قصص الجريمة بدل حكايات الحبّ الجريئة
أعتقد أن مشاعري المُشوّشة بشأن مقطعٍ بعيدٍ من الإيروتيكا، كانت مهربًا لذهني المراهق من ويلات القلق والخوف حيال ما عاشه كوبرفيلد من يتمٍ وفقرٍ وأحزانٍ مُتتالية، كنتُ أخشى عيشها في الواقع. كذلك كان للمراهقة وحدّة هرموناتها دورٌ كبيرٌ في تركيزي على الحميميّة، والعاطفة النابعة من الضعف، وقبول المساعدة، والعناية بالحبيبة، إذ ثمّة ما هو أكبر من التلامس والقبلات. كان ذلك شعورٌ جديدٌ عليّ في القراءة، واستزدتُ منه بالكلاسيكيّات الإنكليزية2 الشهيرة التي تمتلأ بها مكتبة المنزل، وتختلف تمامًا عمّا شعرتُ به خلال قراءة قصصٍ شهيرةٍ مثل عبير، وغدير، وأحلام. وسلاسل الروايات تلك تُعدُّ جزءًا أصيلًا من حياة المراهقين/ات في عالمنا العربي، حتى إن كرهوا/ن القراءة، فجرأتها في سرد اللحظات الحميمة بين العشّاق حصدَت جمهورًا واسعًا. ما زلتُ أذكر غضب أبي وعصبيّته حين وقع بين يديه كُتيّب عبير الصغير، وقرأ النّص التشويقي على الغلاف الخلفي: "لم يعُد قميصي القطني يحميني من لمسات جوردان". تملّكني الخوف يومذاك، وكدتُ يُغمى عليّ من الخجل.
يومها وقفَت أمي في صفّي، فهي من كانت تشتري لي الكتب، وأَخبَرت أبي أنّ لي، كفتاةٍ مراهقة، مشاعر من الأفضل تغذيتها بأكثر الطرق أمانًا؛ فأن أقرأ عن هذه المشاعر وأتخيّلها خيرٌ من أن أعيشها في الواقع، تمامًا مثلما فعلَت هي في مراهقتها. طمأنَته أنّها صادرَت مني ذلك العدد الجريء، إلّا أنّ الكتاب بقي تحت وسادتي.
لإرضاء الأباء المُتشدِّدين مثل أبي، ظهرَت زهور، وهي النسخة الأكثر تهذيبًا عن الحبّ وما قد يرافقه من رغباتٍ تتناسب مع معايير المجتمع
في الوقت نفسه، كانت قصص أغاثا كريستي (Agatha Christie) وأرسين لوبين (Arsène Lupin)، بكلّ ما فيها من جرائم وعنفٍ ودماء، مُتاحةً لي دائمًا من دون أي توترٍ من أبي، لاعتقاده بأنّ القراءة عن القتل وإخفاءِ الجثث وتقطيع أوصالها أقل وطأةً من القراءة عن الحميميّة، وتفتّح عينيّ المُغلقتَين على جسدي.
لإرضاء الأباء المُتشدِّدين مثل أبي، ظهرَت زهور، وهي النسخة الأكثر تهذيبًا عن الحبّ وما قد يرافقه من رغباتٍ تتناسب مع معايير المجتمع. صدرَت زهور ضمن مجموعة كتب مصريّة للجيب وتناولَت الحبّ العُذري البريء، وكيف تصدُّ الفتاة "المؤدّبة" محاولات الغواية من الرجال الوحوش غالبًا، أو تهرب من قصّة حبٍّ لن تؤدّي إلى زواج. كلّها حكاياتٌ لا تحتوي ما يتعدّى لمسات اليدَين. لا أذكر أنني صادفتُ فيها قبلات، ربما مرّ حديثٌ عن عناقٍ ما، لكن بندرةٍ بالغة، إذ ثمّة نقصٌ كامنٌ ورغبةٌ لا تُشبَع، وحبٌ لا يُعبَّر عنه سوى بكثيرٍ من الكلمات وقليلٍ من الأفعال. إنه حبٌّ تحت الرقابة، كأنّ أبي هو من كان يكتب تلك القصص الغراميّة لأقرأها من دون أن تخدش حيائي، كما يحلو له أن يفكّر.
ارتياح والديّ حيال محتوى سلاسل كتب مصريّة للجيب، جعلها أهمّ ما شكّل تفكيري في مراهقتي. بين حبّ الوطن وإحباط هجمات الجواسيس الأجانب في سلسلة رجل المستحيل، كنتُ أرى منى توفيق، ضابطةٌ مصريّةٌ شابّةٌ يشبه دورها فتاة بوند (Bond Girl) في أفلام جيمس بوند (James Bond) الشهيرة، وهي تحارب الأشرار مع أدهم، رجل المستحيل، وتحاول أنّ تثبت جدارتها له، على الرغم من استخفافه بنجاحها وسخريته الدائمة من وجود امرأةٍ تعمل معه ميدانيًا، إلى حين أصبحا عاشقَين.
تغمرني مشاعر النوستالجيا حين أتذكّر أبطال الحكاية، لكنّها رسّخَت في ذهني الفَتِيّ أنماطًا عدّةً مؤذيةً عن الحبّ، فالتنمّر دلالة إعجابٍ واضحة يبديها الرجل قبل اعترافه بالحب، وبقاء المرأة متحفّزةً لإبهار من حولها أمرٌ طبيعي كونها دائمًا تحت الاختبار.
على الرغم من تنوّع مواضيع إصدارات الكتب المصريّة التي كنتُ مُغرمةً بها، لاسيّما ما وراء الطبيعة، وكوكتيل 2000، وسافاري، وفلاش وسماش، فضلاً عن المغامرون الخمسة، والفرقة الانتحاريّة، والشياطين 13، وميكي جيب، وبطوط، إلّا أنّ أيًا منها لم يتناول أجساد المراهقين وتساؤلاتهم/ن، ما جعلني أبحث عن مصدرٍ آخر يعوّض الملل وتكرار مواضيع الجريمة والرعب والحبّ، فاتجهتُ إلى مجلّات اليافعين العربيّة.
وحدها الرِقابة تعرف تفاصيل الحبكة
تعدّدت المجلّات العربيّة المصوّرة لليافعين، لكنّها تشابهَت مع الكتب المُخصّصة لهم/ن، فمجلّاتٌ مثل سمير، وماجد، والعربي الصغير، وباسم، وسامر، وعلاء الدين، لم تتناول أيّ معلوماتٍ عن مرحلة المراهقة ومشاعرها. أحاول التماس الأعذار لتلك المجلات بالإشارة إلى أنها كانت تُباع للأطفال أيضًا.
إلى ذلك، صدرَت مجلّاتٌ عدّةٌ خاصّةٌ بالمراهقات، سمحَت لي أمي باقتنائها، كان من ضمنها تحت العشرين وحياة للفتيات اللتَان حملَتا صبغةً دينيّة. قرأتُ في تلك الإصدارات أنّ الفتيات هنّ السبب الرئيس في إيذاء مشاعر إخوتهنّ الذكور بسبب ارتياحهنّ لارتداء ملابس المنزل الضّيقة والكاشفة عن أجسادهن. كان الأمر مرعبًا وصادمًا بالنسبة لي. كيف يمكن أن يفكّر أخٌ بأخته بتلك الطريقة؟ بل وتتحمّل الفتاة وزر تفكيره أيضًا! لم ترَ مجلة حياة للفتيات - إن لم تخُنّي الذاكرة - ضيرًا في نشر شهادة أخٍ يتحدّث عن حزنه لعيشِه أحلامًا جنسيّةً رغمًا عنه بسبب أخته وبنطالها الأحمر الضيّق.
تعدّدت المجلّات العربيّة المصوّرة لليافعين، لكنّها تشابهَت مع الكتب المُخصّصة لهم/ن، فمجلّاتٌ مثل سمير، وماجد، والعربي الصغير، وباسم، وسامر، وعلاء الدين، لم تتناول أيّ معلوماتٍ عن مرحلة المراهقة ومشاعرها
كان هذا العدد الكارثي آخر ما اشترَيتُ من تلك المجلّة. لم تكن منطقيّةً بل مُخيفة. حتى أمّي خافت حين أخبرتُها بما قرأت، لأنّنا كنّا نستنكر إرغام صديقاتنا في المدرسة على ارتداء ملابس مُحتشمةٍ في البيت. وقتذاك، فكّرتُ أنّ السبب قد يعود إلى تحدّث رجلٍ ما عن حلمٍ مشابهٍ عاشه، ما حرمهنّ من ارتداء البرمودا والشورت حتّى في منازلهن.
مجلّةٌ واحدةٌ فقط حقّقَت حلمي وحلم كثيرات/ين غيري في ذلك السنّ، هي سماش 21 (Smash 21) المُترجمة إلى العربيّة. كانت صيحةً كبيرةً في ذلك الوقت. تحدّثَت المجلّة عن آلام الدورة الشهريّة، وطرق التركيز، وإنجاز ما نريد فعله على الرغم من فورة الهورمونات وتشتّت الأفكار والمشاعر التي نعيشها كمراهقات/ين. كما قدّمَت نصائح بشأن البحث عن شغفنا والمواعدة والإعجاب، ونشرَت حوارًا مع فنّانٍ كان ذا شعبيّةٍ كبيرةٍ بين مراهقي التسعينات ومطلع الألفية الثانية. ابتهجتُ حينها بصورته لدرجة أني قصصتُها من المجلّة واحتفظتُ بها في خزانتي. لكن سعادتي لم تدُم طويلًا قبل أن تتوقّف المجلّة عن الظهور في المكتبات. لعلّ الرقابة السعودية منعَت دخولها إلى البلاد وقتذاك.
لم تكتفِ الرقابة بحظر المجلّات التي تتعامل مع تغيّر أجساد المراهقين/ات ونفوسهم/ن بطريقةٍ مختلفةٍ عن السائد، لا بل شوّهَت العديد من قصص الكوميكس عبر التلاعب بتفاصيلها بما يتوافق مع الأيديولوجيا الدينيّة والمجتمعيّة السائدة. اختبرتُ هذه القراءة الناقصة في كوميكس مغامرات الرجل الوطواط (Batman).
لم تتوفر لي كثيرًا كتبُ الكوميكس بسبب غلاء أسعارها بالمقارنة مع المطبوعات الأخرى، لكن من حينٍ إلى آخر، عندما كان أبي يتسلّم راتبه الشهري، كنا نشتري عددًا ما، نختاره بالإجماع أنا وإخوتي. في إحدى المرات، عَرّفَنا أخي إلى بطله المفضّل باتمان (Batman)، الذي أصبح بالتبعية بطلنا الخارق المفضّل في المنزل. في أحد الأعداد، كانت اللبلاب السامّ (Poison Ivy) تحارب باتمان، وهي عالمة نباتاتٍ شريرةٌ ضلّت طريقها إلى عالم الجريمة، وتكمن قوّتها في مناعة جسدها ضدّ السموم، وإطلاقها فيرمونات الغواية، وقدرتها على بثّ السّم في أعدائها وقتلهم. في أثناء قراءتي للقصّة، شعرتُ أن ثمّة عنصرًا مفقودًا في الحبكة، إذ كقرّاء، لم نعرف طريقةَ آيفي في قتل أعدائها بالسمّ.
عندما تُهمل مطبوعات اليافعين الحديث عن مواضيع الجنس والحميميّة وإمتاع الذات، أو تحذف الرقابةُ القبلات واللمسات من النصوص، لا يبتعد المراهق/ة عن اكتشاف جسده/ا فقط، بل تنقطع صلته/ا به بالكامل
بعد سنوات، اكتشفتُ السرّ حين شاهدتُ فيلم الرجل الوطواط وروبين: كانت العالمةُ الشريرةُ تقتل الرجال عبر قبلاتها السامة، وهو ما حذفَته الرقابة في السعودية، وربما حذفَت معه مشاهد حميمةً أخرى.
رسائل مُشوشةٌ عن مواضيع مُهمَلة
عندما تُهمل مطبوعات اليافعين الحديث عن مواضيع الجنس والحميميّة وإمتاع الذات، أو تحذف الرقابةُ القبلات واللمسات من النصوص، لا يبتعد المراهق/ة عن اكتشاف جسده/ا فقط، بل تنقطع صلته/ا به بالكامل، فلا يدرك/تدرك وجوده إلّا بعد تعرّضه/ا للأذى عبره.
تحدث الجرائم فجأةً من دون منبّهات! ربّما لم أكن لأتعرّض للتحرّش الجنسي في صغري لو أنّ إحدى تلك المطبوعات ذكرَت أمرًا ما عن أنواع اللمسات والمخاطر المتربّصة بنا في الحياة. يحذّرنا الأهل من مختلف أنواع الأذى الجنسي، لكن الحيطة وصوت التنبيه من الخطر لا ينمو داخلنا إلّا بالتدرّج الكامن في القوّة الناعمة للقصص والحكايات، بعيدًا من سلطة الأهل ومخاوفهم التي تكبّلنا أكثر ممّا تحمينا أحيانًا.
كنتُ أتوق لمعرفة ما أجهله حيال الجنس. وعلى الرغم من أنّ أمّي كانت تعطيني بعض المجلّات الصحيّة لأقرأها، بقيَت حلقةٌ ما مفقودة، لاسيّما أنّ مواضيع تلك المجلات كانت محصورةً بجسم المرأة، والدورة الشهريّة، والمهبل، والرحم، والمبيضَين، في غيابٍ تامٍّ لأيّ حديثٍ عن المتعة، وجسم المرأة الخارجي، والفرج، والبظر، والأشفار.
أجابَتني أمّي عن بعض تساؤلاتي عندما ظَننتُ أنني حاملٌ وأنا في الصف الأول الثانوي، على خلفيّة سلامي على صديق أبي وإطالته في الإمساك بيدي. كان موعد دورتي الشهريّة قريبًا، وكنتُ أشعر بالتشنّجات والمغص المعتاد، لكن بما أنّ لحظة سلامنا صادفَت إحساسي بالألم، بدأتُ بالقلق. اعتقدتُ أنّ الحمل يحصل من خلال لمس غير الأقرباء وتقبيلهم على الخدّ. مررتُ بأسبوعَين قاسيَين تخلّلهما نزول دورتي الشهريّة. لكن كان سبق وأخبرَتني أمّي أنها لم تعرف بحملها بي لأنّها كانت تنزف دماء دورتها الشهريّة، فظننتُ حينها أني ورثتُ عنها تلك الحالة النادرة.
حَكيتُ لأمي عمّا أخشاه، فأخبرَتني أنّ السلام والقبلات، حتى بالفم، لا تسبّب الحمل، وأنّها سوف تخبرني عن الجنس في الوقت المناسب لكونه أمرًا معقّدًا أكثر ممّا كنتُ أتخيل. أُدرِجت هذه القصّة ضمن حكايات الترفيه بين الأقارب عند اجتماعنا معًا، ولطالما تفاخر والداي بأخلاقي وجهلي الجنسي، فلم يفكر أحدٌ أن جهلي ذاك هو في الواقع مصيبة، وبالتالي ما من شيءٍ يدعو للضحك ولا للفخر.
يبدو أنّ مجتمعاتنا تُحبّ فرض هيمنتها على الأجساد الصغيرة مُبكرًا عبر التجهيل المُمنهج، فلا تُمنح قوّة المعرفة وتواصل النفس والجسد بسهولةٍ من دون المرور بطريقِ الآلام نفسها التي عبرَتها الأجيال السابقة
أمّا في المدرسة، فلم نتعلّم شيئًا عن الجنس باستثناء ما أخبرونا به في دروس الفقه؛ الجماع - الذي لم يخبرونا ما هو - يتطلب الغُسل قبل الصلاة والصوم، والحامل التي لا تحيض يمكنها أداء العبادات إن استطاعَت. لم نتعلّم سوى بعض المعلومات البسيطة عن الأعضاء التناسليّة الداخليّة إلّا في الصف الثاني ثانوي العلمي، بالإضافة إلى معلوماتٍ عن الحمل تتعلّق بوصول الحيوان المنوي إلى البويضة، من دون الإشارة إلى كيفيّة وصوله.
يبدو أنّ مجتمعاتنا تُحبّ فرض هيمنتها على الأجساد الصغيرة مُبكرًا عبر التجهيل المُمنهج، فلا تُمنح قوّة المعرفة وتواصل النفس والجسد بسهولةٍ من دون المرور بطريقِ الآلام نفسها التي عبرَتها الأجيال السابقة. كأنّ الصدمات والأوجاع يجب أن تُمرّر إلى الجيل التالي كإرثٍ معنوي وجسدي بعيدًا من أيّ فرصةٍ حقيقيةٍ للنجاة واللذة.
إنّ التحايل على أسئلة المراهقين/ات في التسعينات وأوائل الألفية الثانية عبر إنكار تجاربهم/ن ومشاعرهم/ن، جعلَني أُثمِّن جميع صفحات التواصل الاجتماعي والمطبوعات التي تتحدّث عن التوعية الجنسيّة، كونها لا تساهم في خلق جيلٍ جديدٍ أكثر وعيًا بالمخاطر وأهمية التواصل مع الجسد فحسب، بل تساند أيضًا الأجيال السابقة التي لم تكن محظوظةً بالنجاة والحماية، موفّرةً لهم/ن فرصةً جديدةً للتعافي، أو أقلّه لإدراك طريق التعافي والسعي للسيرِ فيه بجسدٍ آمنٍ وسعيد.
أخبرَتني أمّي ما في جعبتها عن الجنس قبل عامٍ من موتها. كانت تخشى أن أتزوّج من دون أن تهيِّئني للجنس، مثلما فعلَت أمّها معها. وعلى الرغم من إدراكها بأنّني أعرف كل ما كانت ستخبرني به، وبأنّ الزواج لا يندرج ضمن خططي، إلّا أننا حاولنا خوض التجربة إدراكًا منّا بأنّ الوقت لن يسعفنا لإتمامها، فتوطّدت خلالها علاقتنا المُضطربة. ليلتها، كنتُ أصبحتُ في سنّ العشرين، لكني تمنّيتُ حقًا لو كنتُ في الرابعة عشرة.

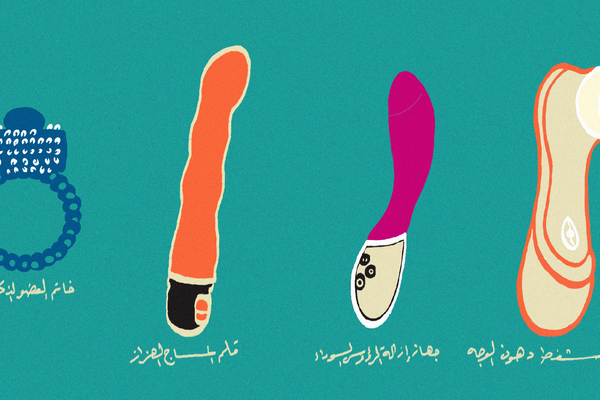

إضافة تعليق جديد