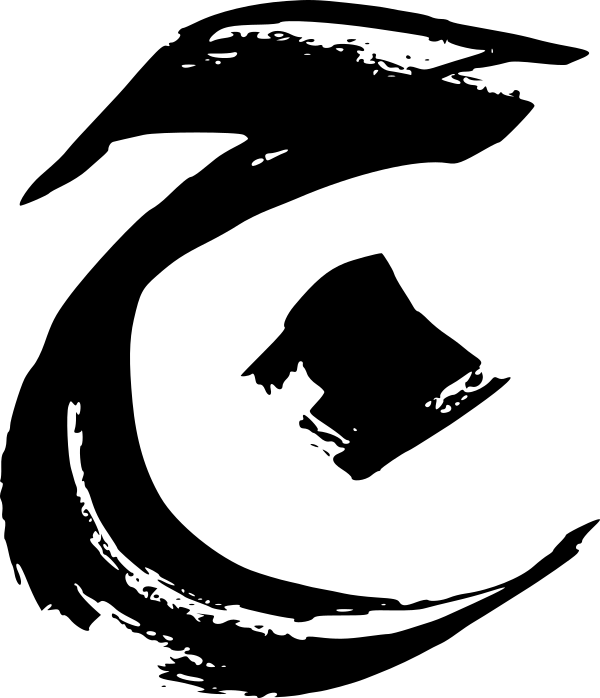سيلٌ أحمر يجرف زهر الوادي!
هذه المرة الأولى التي أكتب فيها خارج دفتر مذكراتي المُقفل بعناية في قفل حديدي، وأشعر بالحماس الشديد حيال ذلك. سأكتب بحرية نعم، سأكتب وأنا واثقة أني أكتب في المكان المناسب.
قضيتُ طفولتي بين الأودية والسهول؛ المنطقة التي أسكنها ريفية عذبة، ربتني وعلمتني ما لم يفعله والداي لي، بالطبع لم أكن أحظى بطفولة جيدة وصحية؛ ولقد أيقنتُ هذا من العقد النفسية التي لا زالتْ تصاحبني حتى هذا اليوم.
كبرتُ بين المدرسة والوادي، أرى الزهور الجميلة والأغنام في النهار، وفي الصباح أرسمها على كراستي. لم أكن أسأل أمي كثيراً، وكنتُ أكتفي بالمعلومات التي أحصل عليها من الطبيعة، والمعلمة التي أحب وبعض الصديقات الثقات، واستمرت طفولتي على هذا النحو حتى بلغتْ.
لا أنسى ذلك اليوم الذي شعرتُ فيه بعارٍ شديد لذنبٍ ما اقترفته، كنتُ أظنّ أني الوحيدة المصابة بمرض النزف الشهري، فكرهتُ جسدي كاملاً، وخصيصاً هذا الجزء القبيح الذي يخرج منه بولٌ يومياً ودمٌ شهرياً.
بذلتُ الكثير كي أتخلص من هذا الشعور المرافق بالذنب الكبير، عندما تبدأ معاناتي الشهرية، أبدأُ بالركض في كل الأركان أبحث عن قطعة قماش لأضمد فيها جرحي النازف.
ثم يحين ألم الجسد والبطن والهواجس المصاحبة، وما كان على أمي إلاّ أن تُغطّيني بأكبر عدد من الأغطية الثقيلة، لا بد أنها كانت متيقّنة أنني أعرف، لكنني لم أكن!
يسألها أبي عن سبب ألمي تقول:" ممغوصة من البرد واللعب طول النهار بالوادي"، وكانت تُعطني حبة من الدواء الذي لم يكن يجدي نفعاً، تحملتُ هذا الألم مقابل ألاّ ينفضح عاري أمام أبي وإخوتي. أما في اليوم الثالث من الدورة اللعينة التي تأتي دون استئذان، كنتُ أعود وألعب مع أصدقائي في الوادي، وذات مرة وقعتْ قطعة القماش وأنا ألعب وألهو، فنظر إليّ جميع الأصدقاء والصديقات بسخرية غير مكبوتة، وبدأ صديقي الذي يكبرني سناً ينادي ويركض في الحي قائلاً: " نزل منها فوطة.. نزل منها فوطة". كم تمنيت أن أقفز وأخنق صوته الأكثر قذارة من فوطتي وأحبس أنفاسه النتنة!
يا لقهر قلبي ذلك اليوم، عدتُ إلى البيت أبكي وأبكي، وكان هذا اليوم هو الأخير الذي ألعب فيه مع أصدقائي الذكور وآخر يوم أحتضن فيه أحجار الوادي وزهر الهندباء؛ فجارتنا اللحوحة أخبرت أمي بما سمِعتْهُ من صديقي، وقالت لي أمي غاضبة: " هاي آخر مرة بتنزلي عالوادي، فاهمة؟ ".
مرّت الأيام باهتة، خالية من أشعة الشمس في الريف كل صباح، ومن ضحكات أصدقائي.
بدأتْ المعاناة والوحدة سوياً، وبدأ الشعر يظهر بكثافة على جسدي، وكان الخجل مصاحب لي في كل مكان، فظننتُ أني خجولة حقاً رغم أني أحب الحياة والصخب، ولا وأحب الخجل والهدوء. أقضي صباحي أشاهد التلفاز وأقرأ القصص، وفي المساء أصنع الملابس لدميتي البلاستيكية؛ كنتُ أصنعُ لها فساتينَ بهية، وملونة، حِكتُ لها حمالة صدر، وتنورة، ولم أصنع لها فوطة؛ فلا أريدها أن تتألم مثلي، كان صوتُ ذلك الولد الذي كان ينادي في الحي عن فوطتي يطاردني في كل مكان، كنتُ أحضن دميتي لأحميها، وددتُها كما هي، تملك جسداً أنثوياً رائعاً، دون جزءٍ نازف.
كان هذا في العطلة الصيفية، عدتُ إلى مدرستي بعدها لبداية سنة جديدة، وكان جزء من صديقاتي بدأنَ بارتداء الحجاب، وبدأت صدورهنّ تكبر وتبرز إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من الحياة لم نعرفها بعد، وشبه محاولة للإنتحار لو سألنا أحد في البيت عن سيكولوجية ومتطلبات هذه المرحلة.
كنتُ أحب المرح، ومصادقة الفتيات المشاغبات، وكُنّ هنّ المصدر الأول لمعلوماتي التي من غير الممكن أن أجدها في البيت أو المدرسة، ففي إحدى المرات، وجَدتْ إحدى الصديقات المشاغبات فوطة صحية في الصف المدرسي، فمَسَكتْها وقالت: " مين الوسخة اللي رامية الفوطة عالأرض؟ " هنا كان الفرج، فنظرتُ بفرح ودهشة شديدة، وددتُ تقبيلها واحتضانها شكراً وعرفاناً؛ فأنا لستُ المريضة الوحيدة على هذه الأرض، ثمَّة أخريات مصابات مثلي بهذا الجرح النازف!
سألتُها بعد ذلك، وأخبرتني بأنها أيضاً تمتلك مهبلاً نازف، وأنّ غالبية بنات الصف ينزفن مرّة واحدة كل شهر، وأنّ هذه السلسلة المستمرة من النزيف الشهري، تسمى (الدورة الشهرية).
وزادت فرحتي عندما قالت لي: "حتى أمك بتيجيها".. عدتُ إلى البيت بكل فخر، وكنتُ أنظر لأمي بأنها هي أيضاً تمتلك ذات العار.
وأني أعرفُ عنها سراً كبيراً.
وفي المساء صنعتُ لدميتي فوطة صغيرة، وكنتُ أضعها لها بين ساقيها كل شهرٍ مرةً مثلي تماماً.