ماذا لو أصبح لديك يومٌ من كلّ أسبوعٍ وكلّ شهر، محمّلٌ بالرمزيات، يقيّدك بكابوسِ الفراغ والوحدة والفقد؟ ماذا لو استثار هذا اليوم رغبتك في الرحيل؟ ماذا لو كان هذا اليوم هو تاريخ وفاة أمك؟
قد يبدو الحديث عمّن غادرونا صعبًا أو مستحيلًا، لكن الأصعب هو أن تحاول الإفصاح عن وجعٍ حالَ دون أن يندمل. وهل يمكن أن يكون تحرير ألسنتنا وفكرنا وأصابعنا للكتابة عن موتانا "تبشيرًا" بانتهاء فترة الحداد؟ وهل يمكن أن نستبشر بخلع الحزن عن قلوبنا بعد رحيل الأعزّاء؟ قد تبدو فترة الحداد موضوعًا ينغمس فيه الباحثات والباحثون للكشف عن طرق عيشه، والعوامل التي تتدخّل في طول مدّته أو قصرها والتجارب المختلفة لمَن يعيشونه. لكن بالنسبة لي، لا يزال السؤال مطروحًا: هل يتسنّى لي إنهاءُ الحداد على روح أمي؟ هل أملك مشروعيّة الانتقال إلى مرحلةٍ أتعايش فيها مع الفقد العظيم والخسارة الكبرى؟
مرّت سنةٌ على رحيل الماجدة، ولم يبقَ عالقًا في ذهني غير الأيام التي بدَت فيها أمي مشارِفةً على النهاية. ما يفوق حزن الفقدان ألمًا هو الخوف من الفقدان. وهو تمامًا ما شعرتُ به يوم رأيتُ الارتباك على وجوه الأطباء وهنّ/هم يبحثن عن طريقةٍ لإخفاء خطورة حالتها عنّا. أتذكّر أنّي كنتُ أبحث كلّ يومٍ عن الإجابة وأنتظر اللحظة التي يخبرني فيها المشرفُ على حالتها أن لا داعيَ للقلق. بقيتُ في انتظار بشرى شفائها، إلى أن صُعقت بخبر المرض الذي تمكّن منها وبيقين الأطباء والعلم بأن المعجزات وحدها كفيلة بإنقاذها من سقمها. كانت كلّ الفحوصات كاذبةٌ بالنسبة لي، وكلّ مراجعات الأطباء واهيةٌ أمام إيماني المطلق والتّام بقدرة أمي على صنع المعجزات كما عوّدتنا دائمًا. لم تستسلم "مجّودة" - كما أحبّ أن أناديها - يومًا للمرض، ولا تخلّت لحظةً عن ابتسامتها في وجهي والرفع من معنوياتي، كما حرصَت على تذكيري بضرورة إتمامي مذكرة البحث لنيل شهادة الماجستير. أتذكر استبسالها في تحمّل وخز الإبر، وأوجاع الكيمياوي، ومصارعة آلام مرضٍ لعينٍ أفقدها نشاطها وقوّتها ووزنها، لكن لم يُفقدها الأمل والعزيمة والصمود وبريق عينيها.
يئس الفريق الطبيّ من شفائها وأمَرَ بعودتها إلى المنزل بعد مرور شهرٍ وأسبوعٍ على إجراء الفحوصات واستخراج العيّنات؛ فترةٌ تضافرَت فيها جهودٌ تسلّحَت بالأمل وآمنَت بالحبّ العظيم الذي زرعَته الماجدة في قلوبنا، حيث ترعرعنا ونهلنا من دروس الحياة التي لا ينضَب سحرها.
لم أكن أعلم حينها أنّ قرار تسريحها من المشفى هو إعلانٌ عن انسداد السّبل. خلتُ أن سرير أمي الدافئ القادر أن يسَعنا جميعًا بكلّ ما يحمله من سكينةٍ وحب، كفيلٌ بأن يخلع عنها المرض. خلتُ أن شجرات الفلّ والياسمين والعطرشية التي تنمو بأنفاسها ويختلط عبقها بعطر أمي، قادرةٌ على شفائها وتحفيزها على التشبّث بالحياة. خلتُ أنّ ألسِنة الشمس التي تضيء غرفتها بإمكانها أن تبعث فيها النور من جديد، بعد أن أخفَته عتمةُ المرض وحاصره كابوسُ السرطان محيلًا جسدَها المقاوم هزيلًا وضعيفًا.
كيف لإلهٍ عادلٍ أن يتسبّب في أذيّتنا إلى هذا الحدّ؟ وكيف لمَن يطلبون منه الرحمة أن يقسو عليهم/ن بهذا الشكل فيَحرمنا مَن نحب؟
ثم كيف لامرأةٍ بكل تلك القوة والشموخ والثقة والثبات أن تعلن خريفَ عمرها الذي أتى مبكرًا غير مرغوبٍ به؟ وكيف لأم أطلقَت اسم الأمل على أولى بناتها أن تفقده لكن تبقى مصرّةً على الكتمان؟ لم تكن أمي تعلم بأنّنا كشفنا سرّ يأسها من الشفاء، ولا تخلّينا يومًا عن إقناعها بأن كلّ شيءٍ على ما يرام. كانت فترةً غاب فيها الصدقُ عن حديثنا وانعدم في أعينِنا. جميعنا تشبّث بأملٍ كاذبٍ كان بمثابة حلمٍ جميلٍ استفَقنا منه على صوتٍ انفجار مدوّ أودى بكلّ ركنٍ من أركان المدينة التي شيّدَتها لنا الماجدة. تلك القلعة المنيعة مثلما كانت تلقّبها أمي، التي لم تكن تسمح لأحدٍ بالاقتراب منها إلا إذا وافقَت هي على ذلك. وانهارَت أولى حجارة تلك القلعة في الليلة التي أخبرَتني فيها أمي بأنها قررَت الرحيل. استغربتُ صراحتها، بل وأبى عقلي البسيط أن يستوعب أو يصدّق ما ترغب في القيام به. لم تستدعِ مني جملتها تعليقًا بقدر ما كانت تحثّني على إنكار كل ما جاء فيها. كل ما فعلتُه حينها كان أنّي تجاهلت ما أخبرتني به وأسرعتُ أخلد إلى النوم. لا أعلم ما جعلني أتصرّف هكذا، لكنّي أذكر أنّي حدقتُ فيها كثيرًا، وبكيتُ أمامها بحرقة، ثم قبّلتُ يدَيها واستنشقت رائحتها والتقطت صورةً أخيرةً لها. تدثرتُ ليلتها بكلّ ما حملتُه من حزنٍ وغضبٍ رأيتهما في عينيها، إلى أن استفقتُ صباحًا ووجدتُها بانتظارنا لننقلها ثانيةً إلى المصحّة. لم تتخلّ أمي قطّ عن هدوءها ورصانتها وحكمتها، فانتظرَتنا لنُنهيَ معًا كلّ طقوسنا الصباحية قبل أن تقرّر مفارقة العالم واقفةً على قدمَيها.
أيّ قوةٍ تحملينها يا أمي حتى خالفتِ كل مشاهد الموت التي نراها ونسمع عنها؟ أيّ عظَمةٍ لديك تجعلك تختارين شكل الرحيل؟ لم نكن ندرك حينها أن أمّي كانت تُحتضر لأنها لم تتوقف عن مخاطبتنا قاطعةً وعدًا بعدم الرحيل، فنقلناها إلى المصحّة بينما كانت هي قد فارقت الحياة بين أيدينا على غفلةٍ منّا.
هذا البؤس الذي نعيشه إلى الآن كنتُ رأيتُه في ملامح الطبيب الذي لم يقوَ على النطق بخبر الوفاة، فاختار الاتصال بوالدي لأنه قدّر أنه الأكثر صمودًا والأجدر بتلقّي الصدمات. لا أعلم كم استغرقتُ من الزمن لأستوعب ما كان يخبرنا به الطبيب، لكني حينها استرجعتُ شريط حياتي برفقتها، ثم توقف العالم بالنسبة لي وكفّت الأرضُ عن الدوران. غاب عني الكثير من الصّور، لكن صوت الطبيب كان يُعلمني بأني لن أنعم بالطمأنينة مجددًا، ولن أستنشق رائحة الفلّ والياسمين في كل مرةٍ تضعها أمي على وسادتي حتى أستفيق من نومي. كانت لحظةً علمتُ فيها أني سأنام بساقَين باردتَين بلا دفء، وسأخلد للنوم من دون قبلة، ثم سأستفيق على قهوة الصباح من دون رائحة، وفيروز من دون صوتٍ وسيجارةٍ أدخّنها بمفردي من دون طعم. كانت لحظاتٌ أشبه بدهر، استشرفتُ فيها صورة بيتنا المظلم والبارد الخالي من رائحة
12 نوفمبر 2020 كان اليوم الذي ناديتُ فيه الماجدة ولم تستجِب. رفضتُ أن أرى جسدها وقد فارقته الروح، ودخلتُ في قطيعةٍ مع تلك القوة الخارقة التي تتحكّم في أخذ أحبابنا منا. صرتُ في صراعٍ متواصلٍ مع فكرة العدل الإلهي. كيف لإلهٍ عادلٍ أن يتسبّب في أذيّتنا إلى هذا الحدّ؟ وكيف لمَن يطلبون منه الرحمة أن يقسو عليهم/ن بهذا الشكل فيَحرمنا مَن نحب؟ كلّ هذه الأسئلة لم تنفكّ تراودني، لاسيما في أكثر لحظات الوداع حدّة.
ليس غريبًا أن نستشفّ كيف تمثّل الأنوثة عائقًا يمنع النساء من عيش طقوس الموت وآلام الفراق من دون التفكير في مسائل شكليّةٍ وجانبيّةٍ تعمّق وطأة الحزن
توفّيت أمي، لكنّها بعثَت بروحها داخل جسدي أنا وأختي حتّى أضحَينا روحًا واحدةً تحرّك جسدَين. كانت تخاطب عقلَينا كأنّها تحثّنا على ألّا نتركها حتى نشيّعها إلى مثواها الأخير، فشرَعنا نبعث برسائل ضمنيّةٍ وعلنيّةٍ بأنّ لا أحد يملك مشروعيّة منعنا من مرافقة أمّنا إلى المقبرة. لم يقوَ عددٌ من المحرِّمات/ين على إخفاء آرائهنّ/م، لكنهنّ/م لم يتجرّأوا على الإفصاح صراحةً عن معارضتهنّ/م لنا.
كان الجميع يتصرّف كأنّه في حضرة الماجدة، ويتفاعل كأنّه في تواصلٍ مباشر معها، تمامًا كما كانت هي تحرص على وضع الأمور في نصابها دومًا. لكن ليس غريبًا أن نستشفّ، عبر هذه التجارب، كيف تمثّل الأنوثة عائقًا يمنع النساء من عيش طقوس الموت وآلام الفراق من دون التفكير في مسائل شكليّةٍ وجانبيّةٍ تعمّق وطأة الحزن.
أتذكّر أيضًا أنّ أختي كانت تسعى إلى مضاعفة لقاءاتي بأمّي بالرّغم من يقينها بأنّي لا أقوى على رؤيتها ساكنةً ومُغادِرة. أشكر الأمل (أختي) لأنّها أجبرَتني على النظر في عينيّ "مجّودة" الملهمتَين وتقبيل جبينها البارد. لكن حتى هذه اللحظة، ما زلتُ ساخطةً على مَن أخبرَتني وقتها بأنّ دموعي ستحرق أمي وكلماتي ستؤلمها. ولن أسامح مَن حاولَت منعي من المساعدة في حمل أمي ووضعها داخل التابوت، لكنّي فخورةٌ بأنّي صفعتُها بقوّةٍ وواصَلت مهمّتي بغضبٍ لكن بجدّ. كما لن أسامح تلك التي لم تنفكّ عن دعوتي لستر "لحمي" وأنا في طقسٍ جنائزيّ أودّع فيه مَن كانت تحثّني على تحرير عقلي، ومَن احتفَت بالوشم المحفور على جسدي. كيف لي أن أُخفي شعري، أنا ابنة الماجدة، التي ظلّت رافضةً فكرة ارتداء الحجاب؟ وكيف لي أن أسير على خطى حارسات وحرّاس المعايير الاجتماعية، وأن أمقت أنوثتي وأعتبرها عائقًا أمام عيش تجاربي دون صنصرةٍ تفرضها عليّ السلطة الأبوية، في حين كانت الماجدة تتباهى بمنحها الحياة لابنتَين هما سليلتَاها في كلّ أفكارها وتطلّعاتها، وماضيتَان على دربها وفيّتَين لعهدها؟
علّمَتنا أمي أنّ الوعد مقدّس، فحملتُ وأختي نعشَها على كتفَينا - حزينتَين وفخورَتين.
حُملت أمّي على الأكتاف مرفقةً بأزهار الفلّ والياسمين، وشيّعَت جثمانها إلى المقبرة نساءٌ كاشفات الرأس، ووطأت أقدامهنّ أرض المدافن وحضَرنَ مراسم الدفن. الكلّ كان خاشعًا/ة أمام هذا الطّقس المهيب. لم تتجرّأ أي امرأةٍ على الاصطفاف مع الرجال لإقامة صلاة الجنازة. كنتُ الوحيدة التي تحلّت بجرأةِ الماجدة المعتادة، فقمتُ خلافًا لقناعاتي بتغطية شَعري حتى لا أُمنع تمامًا من عيش تجربةٍ حرَمتني إيّاها الثقافة والأعراف.
كان يوم دفن أمي معركةً تيقّنتُ فيها أنّ بعض النساء نتاج ثقافةٍ اجتماعيةٍ تجعلهنّ أكثر حزمًا وقسوةً في الدفاع عن الأبوية
كان الحجابُ مجرّد جزئيّةٍ تلاشَت أهمّيتها عند اقترابي من فضاء الذكورة. وعلى الرَغم وضعي غطاء الرأس، لم يكن ذلك كافيًا للسّماح لي بالصلاة على جثمان أمي، بل أصرّت إحدى النساء على أن تكون الأكثر ذكوريّةً والأشرس في تطبيق قواعد الأبويّة، فسمحَت لنفسها بأن ترغمني على مغادرة صفّ الصلاة، وأبَت تصديقي بأنّي خضعتُ لطقوس التطهّر قبل القدوم. كيف لي أن أقنع سليلات البطريركية وسليليها بأنّ رحمي ومبيضيّ وحيضي وفرجي ليسوا أبدًا عائقًا أمام انتزاعي الحقّ بدفن أمي ومعانقتها داخل مكانٍ سترقد فيه غريبةً ووحيدة؟ حتى في ذلك المكان المقفر والمظلم، كانت أمي أكثر حرّيةً من كلّ أولئك المصلّين عليها، وعرفتُ أنها سترقد مستنيرةً بأفعال تحريرنا من أغلال السّلطة والخضوع لمركزيّة القضيب وديكتاتوريّة كارهي/ات النساء.
كان يوم دفن أمي معركةً تيقّنتُ فيها أنّ بعض النساء نتاج ثقافةٍ اجتماعيةٍ تجعلهنّ أكثر حزمًا وقسوةً في الدفاع عن الأبوية، ودرسًا يحملنا على النضال من أجل انتزاع حقّنا في عيش الألم والانكسار من دون حمل أوزار إملاءات المعايير الاجتماعية التي تجعل حدادنا أبديًا، ليس فقط على موتانا، إنّما لكوننا نساء أيضًا. أدركتُ يومها أنّ تجارب الموت تجبرنا على التطبيع مع ما لا نؤمن به، لكنّها في الوقت عينه تنبّهنا كيف يستغلّ مَن حولنا الأوضاعَ التي نكون فيها أكثر هشاشةً وانكسارًا، للإمعان في تعزيز الفوارق الجندريّة وإحكام بُنى الهيمنة علينا.
في كلّ الأحوال، لم يكن ذلك التعامل أشدّ قسوةً عليّ من رؤية جسد أمي مغمورًا بالتراب. جلّ ما فكّرتُ فيه آنذاك كان: لو أنّ أمي ما زالت على قيد الحياة، لدافَعت عنّي كي أفتكّ حقي في توديعها بالطريقة التي أرغب.


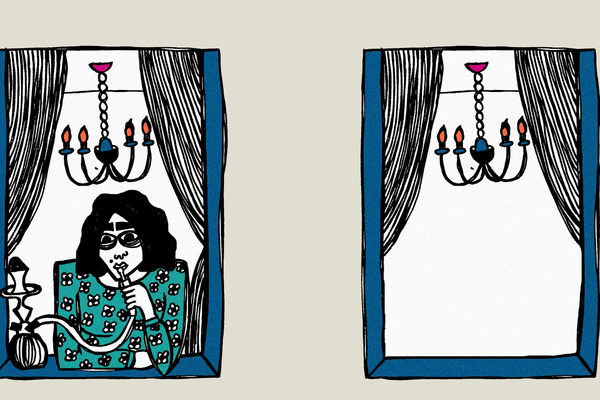
إضافة تعليق جديد