كبرتُ في تونس وعلى مسامعي مقولةٌ تتكرّر: "المرا من دار بوها، لدار راجلها، للقبر". ظلّ صدى هذه الكلمات يتردّد في أذنيّ على مدى عقدٍ من الزمان حتى أصبحَت الحقيقة الوحيدة التي أدركُها في حياتي كامرأة. ظننتُ أنّ من المقدّر لي أن أعيش حياةً تحكمها تصوّرات والدي لما يجب أن أكون عليه، وأن أكابد من أجل مستقبلٍ ترسم ملامحه توقّعات "زوجي" لما يجب أن أكون عليه؛ وفي نهاية المطاف، أن أستقرّ في قبري جاهلةً بما أردتُ أنا أن أكون عليه.
منذ 13 عامًا، كنتُ أبلغ من العمر 19 وكنت مُقبلةً على الزواج؛ زواجٌ غير مدبّر. على العكس ممّا قد يعتقده البعض، لم أكن مُجبرةً على الزواج، بل أبديتُ رغبةً في ذلك الارتباط وكنتُ مستعدةً لتلك الخطوة.
تعرّفتُ إلى خطيبي في خلال موسم الصيف عندما كنتُ أبلغ سنّ 18 عامًا، وكنتُ قد أنهيتُ دراستي في المرحلة الثانوية وينتابني الحماس لقضاء الوقت مع جدتي في البلدة قبل بدء موسم الدراسة الجامعية. وكان ذلك الشاب، الذي أصبح فيما بعد خطيبي، يتردّد إلى المتجر حيث يعمل أحد أقاربي، وهو صديقٌ له، ليمضيا الوقت معًا. وللمصادفة، كان هذا المتجر مجاورًا لمتجر الثياب الذي يملكه والدي حيث كنتُ أعمل آنذاك.
كان ذلك الشاب ظريفًا وجذابًا وبليغًا. وكيف لا يكون كذلك؟ فهو يكبُرني بعشر سنواتٍ ولديه ما لديه من قصصٍ يرويها عن تجاربه الحياتية. هكذا، سرعان ما وقعتُ فريسة سحره. وبحسب اعتقادي، ذُبت فيه لأنه عاملني بطريقةٍ مختلفةٍ عن تلك التي ربّاني والدي عليها: فشعرتُ بأنّه يقدّر رأيي، ويُصغي إليّ حين أتكلم، ويُشركني في اتخاذ القرارات، ما جعلني أشعر بأنّ لوجودي أهمية، وهذا ما يفعله أيّ شريكٍ حقيقي. شعرتُ معه أنني، أخيرًا، أُعامَل كراشدةٍ وليس كطفلةٍ تائهةٍ تتلقى الأوامر. شعرتُ بأنّ لي قيمة، وبأنني أتمتع بالقوة والتمكين.
ما إن أصبح الارتباط رسميًا حتى انقلبَت الآية: فذلك الرجل الذي عهدته جذابًا وحنونًا وداعمًا ولطيفًا، تحوّل إلى كائنٍ متطلّبٍ سلطوي أراد أن تتمحور حوله كلّ حياتي
رأيتُ فيه سبيلًا لحياةٍ أردتُ أن أعيشها: حياة يُسمح لي فيها بأن أخرق الحدود التي نُقِشت لتحدّ من سقف طموحات المرأة وتمنعها من اكتشاف ذاتها وأحلامها ورغباتها، كل ذلك باسم الأخلاق الحميدة. اعتقدتُ أن وجودي مع ذلك الرجل سيحرّرني.
عقدنا خطبتنا بعد ذلك الصيف، وحدّدنا موعد الزواج في الشتاء التالي. لكن ما إن أصبح الارتباط رسميًا حتى انقلبَت الآية: فذلك الرجل الذي عهدته جذابًا وحنونًا وداعمًا ولطيفًا، تحوّل إلى كائنٍ متطلّبٍ سلطوي أراد أن تتمحور حوله كلّ حياتي. في بادئ الأمر، كنتُ أنجذب لكمّ الاهتمام الذي يُبديه بي هذا الرجل الذي اعتقدتُ أنني أحببتُه. حتى أنّ كل الاتصالات والرسائل النصّية التي كانت تتتبّع حركتي كانت تُشعرني بالاهتمام، بعكس الآن. ومع الوقت، زادت حدة أسئلته بشأن مواعيد ذهابي وإيابي، وتحولَت الاتصالات اليومية من مبادرةٍ تبعث فيّ شعورًا بالحب والاهتمام إلى حبلٍ يلتفّ حول عنقي ويخنقني.
شعرتُ بأن لا حق لي في الخصوصية، لا بل أسوأ ما في الأمر هو أنني صدّقتُ أن لا حق لي فيها. فقد كان يعتريني شعورٌ بالذنب لإخفائي أتفه التفاصيل وأصغرها عنه. وبالنسبة لفتاةٍ نشأَت على مبدأ أنّ المرأة مدينةٌ لزوجها بحياةٍ مستباحة، ظننتُ أن حصولي على حياةٍ خاصةٍ بي هو نوعٌ من أنواع الخيانة. وهكذا تحوّل الشعور بالذنب إلى شعورٍ بكراهية الذات؛ إذ شعرتُ بأنّ رغبتي بالمحافظة على نوعٍ من الخصوصية في ما يتعلق بحياتي الخاصة يتعارض مع ما نشأتُ عليه من سلوكٍ كان عليّ الالتزام به باعتباري امرأةً "صالحة". كانت الأفكار في رأسي متضاربة، فبينما كنتُ أريد أن أعكس صورة المرأة "الصالحة"، أردتُ أيضًا أن أكون صالحةً بحق نفسي.
بالنسبة لفتاةٍ نشأَت على مبدأ أنّ المرأة مدينةٌ لزوجها بحياةٍ مستباحة، ظننتُ أن حصولي على حياةٍ خاصةٍ بي هو نوعٌ من أنواع الخيانة
قد يبدو الخيار الآن واضحًا، لكن حينذاك، كانت بيئتي - سواء عائلتي أو مجتمعي أو أصدقائي - قد جعلَتني أتشرّب أفكارًا مثل ارتباط رفاهي برفاه زوجي المستقبلي وتعلّق راحتي براحته، وأنّي ما إن أستوفي معايير السعادة المتوقعة مني كشابةٍ ذات صحةٍ جيدةٍ مع زوجي المستقبلي، لن أتمكّن أبدًا من تخطّي ذلك الشعور. كنتُ مشوّشة. كنتُ أعرف أنّ الغضب يعتريني، لكني لم أكن أدرك أنّ لي الحق في أن أغضب. شعرتُ بأنني عالقة؛ فإمّا أن أخسر شخصًا ظننتُ أنني أحببتُه وألطّخ شرف عائلتي – إذ بالنسبة لعائلتي بشكلٍ خاصٍ والمجتمع بشكلٍ عام، أكون عندها امرأةً فاسقة، على افتراض أنّ الخطوبة لا تُفسخ إلا إذا فقدَت الفتاة "طهارتها" (عذريتها) – أو أتخلّى عن قدرتي على التحكّم بحياتي.
في تلك اللحظة، كان من الصعب عليّ أن أقدّر قيمتي وأن أختار نفسي على حساب رضا الأشخاص الذين ظننتُ أنني أحتاجهم في حياتي. ففي النهاية، لم أكن إلا فتاة نشأَت على أن تعيش لترضيَ من حولها؛ فتاةٌ مطيعةٌ ومنصاعةٌ للقواعد المجتمعية لإسعاد الجميع.
لكن بالرغم من كل ذلك، قررتُ أن أختار نفسي، ففسختُ الخطوبة، وكان ذلك إلى حدٍّ كبيرٍ بفضل الجامعة. فما إن دخلتُ ذلك العالم الجديد والواسع، حتى ارتسمَت أمامي ملامح مستقبلٍ أكون فيه مستقلةً ومعتمدةً على نفسي: في خلال دراستي الجامعية، تعرّفتُ إلى أشخاصٍ لديهم/ن نظرة مختلفة عن الديناميّات الجندرية، وتعلمتُ أن أجتاز بتفكيري ونظرتي المنظورَ الجندري الذي كنتُ أعيش في ظلّه. حتى أنني التقيتُ رجالًا قدّروا قيمتي بغضّ النظر عن الدور الإنجابي أو الرعائي المتوقع مني أن أؤديه. أدركتُ حينها أنه كان عليّ الرهان على نفسي لأكون كما أتمنى.
وعلى الرغم من اقتناعي بأنني اتخذتُ القرار الصائب بفسخ الخطوبة، إلا أنّ توصّلي إلى ذلك القرار لم يكن سهلًا. كانت الطريق محفوفةً بمشاعر الوحدة، وانعدام الثقة، والخوف. كما كان عليّ أن أستعدّ لردّ الفعل العنيف؛ فالذكورية المدفوعة بالكبرياء لا تتقبّل الرفض. ظلّ خطيبي يطاردني لعامٍ على الأقل بعد انفصالنا، كما استمر بمحاولة ترهيبي مستخدمًا شتّى الطرق، مثل تهديدي بأن ينشر علنًا تسجيلاتٍ للحظاتٍ حميمةٍ جمَعَتنا، وهي على الأرجح غير موجودة، ومحاولة تحريض أهلي عليّ. كنّا بالكاد تبادلنا القُبل، ومع ذلك، كانت فكرة نشر تسجيلاتٍ كتلك، وإن كانت على الأرجح مفبركة، تُرهبني. وتصاعدَت حدّة تهديداته لتبلغ حدّ الاتصال بي كل ليلةٍ ليقول لي بأنني سأندم على قراري، كما أخذ يفاجئني بقدومه إلى الجامعة من دون سابق إنذار.
في خلال دراستي الجامعية، تعرّفتُ إلى أشخاصٍ لديهم/ن نظرة مختلفة عن الديناميّات الجندرية، وتعلمتُ أن أجتاز بتفكيري ونظرتي المنظورَ الجندري الذي كنتُ أعيش في ظلّه
وبالإضافة إلى مواجهة خطيبي، كان عليّ أن أواجه نظرات الذنب والشفقة والعار التي كان يرمقني بها أفراد عائلتي، وشعور الإحراج الذي كان يعتري والدتي كلما سأل أحدهم عن موعد الزفاف. كما كان عليّ أن أتعايش مع نظرات والدي المليئة بالخيبة كلما سأله أحدهم عن صهره المستقبلي. هكذا، تمحورَت كلّ الأحاديث والهمسات الدائرة في اللمّات العائلية حولي أنا، إذ جرى تصويري على أنني "الفتاة الشابة المسكينة التي أضاعَت مستقبلها"، و"الموصومة بالعار غالبًا"، والتي ستواجه إلى الأبد سؤال "مَن سيتزوّجها الآن؟"
عندما أستذكر الماضي، أدرك أنّ الارتباط في سنّ 19 كان ضربًا من ضروب الحماقة. لا يمكنني سوى اعتبار تلك الخطوة استسلامًا لضغوط البيئة المحيطة بي، والتي تمجّد فكرة الزواج باعتبارها الطريقة المثلى لتقدم المرأة في الحياة – تلك البيئة نفسها التي تعتبر أنّ إنجاب الأطفال وتأسيس عائلةٍ هما أقصى ما يمكن للمرأة أن تنجزه في حياتها.
ما زلتُ اليوم أتخبّط في محاولة هدم صورة المرأة التي رسمَها لي المجتمع الأبوي الذكوري عنّي، وجعلَني انعكاسًا لها. لقد حققتُ تقدّمًا كبيرًا في مسيرة حب الذات والاهتمام بها، كما سمحتُ لنفسي أن أشغل حيّزًا خاصًا بي. وأدركتُ بأنني لا أحتاج إلى كسب رضا الرجال من حولي لأكون ما أنا عليه. وحدي أنا أستطيع أن أحدّد مَن أنا.

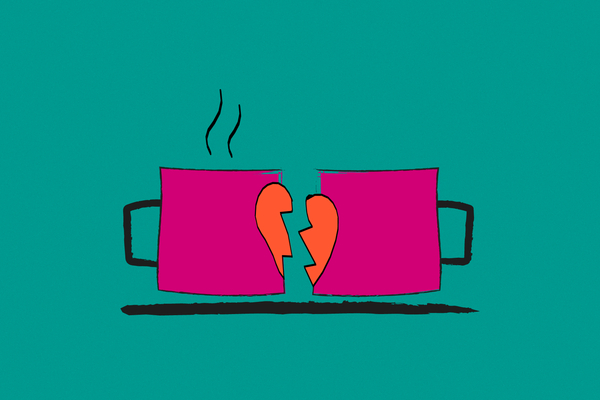
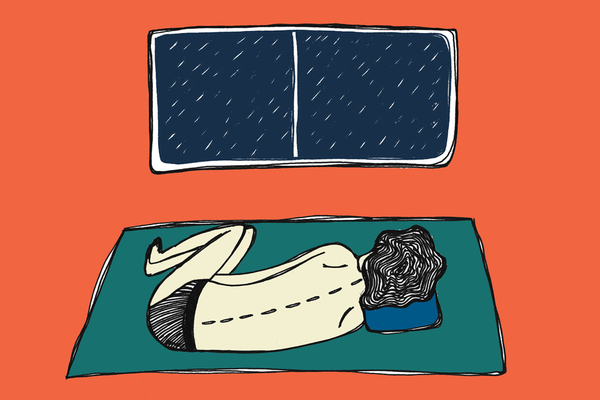
إضافة تعليق جديد