مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة بشتّى أشكاله، ألاحظ حولي ولدى عملائي وحتى في نفسي، ما تعلّمتُه عن صدمات الشهادة على الحروب والإبادة. وبالتأكيد، ما تعلّمتُه لم يكن كافيًا لأدرك التجربة كاملة.
ففي هذه الأيام، نواجه تحدّيًا كبيرًا في تأدية مهامنا اليومية، وفي الوقت نفسه متابعة الأخبار وهضم مشاعرنا في ظلّ القلق والألم اللذَين نواجههما كلّ صباح، بالترافق مع موجاتٍ من البروباغندا المضلّلة والحملات الموجّهة.
في كثيرٍ من الأحيان يكون الأمر مرهقًا وصعبًا، إذ يبرز تحدٍّ كبيرٌ في ظلّ الحرب الإعلامية الجارية وشهادتنا على الأحداث، يُشعرنا بوجوب نشر الحقيقة والتفاعل معها ومواجهة الخوارزميات. ولكنّ الحقيقة شديدة الألم؛ فكيف لنا أن نصمد ونُديم دعمنا للقضية الفلسطينية من دون أن يقضي الألم علينا بسبب المشاهد المروّعة، والواقع الذي يزداد بؤسًا بفعل التجويع وقطع كل سبل الحياة والاتصال؟
في الواقع، الجسد لا يفرّق بين ما هو حقيقيّ وما هو على الشاشة. على سبيل المثال، تتفاعل أجسادنا مع أفلام الرعب، فنبكي على القصص الحزينة في السينما برغم علمنا بأنها غير حقيقية. فما بالك بكيفية تفاعل أجهزتنا العصبية مع ما نراه يوميًا من موتٍ ودمارٍ حقيقيَّين ويحدثان فعلًا؟
عند التعرّض للخطر أو مشاهدته، تتفاعل أجسادنا بثلاث طرقٍ مختلفة: إما الهجوم، أو الهروب، أو التجمّد. ومع غياب المساحة اللازمة لاستكمال ردّات الفعل هذه، وتواتر المشاهد الصدمية على المتابعين/ات عبر منصّات التواصل الاجتماعي، تتوقّف ردّات فعلنا تجاه هذه المشاهد المروّعة، مسبّبةً لنا آلامًا جسدية ومشكلاتٍ نفسيةً وصعوباتٍ متعدّدة.
أيضًا، يتعرّض كثيرٌ من الأشخاص العاملين/ات في مجالات الإغاثة والطوارئ والصحافة في مناطق النزاع للصدمة الثانوية1، بسبب تعرّضهم/ن لصدماتٍ شديدةٍ واختبار تجارب الفقد بشكلٍ مُتكرّر.
وبحكم تنامي استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحَت الأخبار متاحةً بسرعةٍ ومن دون توقّف. لا شكّ في أنّ هذا التعرّض مفيدٌ لتشكيل الوعي العام بالقضايا المهمّة والحسّاسة، لكنّه يملك أيضًا وجهًا آخرَ يبتلع الوقتَ اللازم لهضم التجربة الجسدية والعصبية وردّات الفعل الناتجة عن التعرّض لمشاهد الخطر.
فكيف ندعم القضية ونؤدّي الأدوار التي نريد وسط هذه الأحداث؟ وكيف نصمد من دون أن نُصاب نحن فننشغل بإصابتنا؟
ثمّة ما يُسمّى بالسّعة النفسية، وتحوي كلّ ما يمكن أن يساعدنا على الشعور بنطاقٍ أوسع وأكثر تنوّعًا من المشاعر والتفاعل معها وهضمها، من دون أن تقضي علينا أو تؤثّر في شعورنا بالأمان أو قدرتنا على التعامل مع الخطر. وفي الحياة اليومية، تأتي السّعة من قدرتنا على الاتصال بمصادر قوّتنا وإيماننا، وبكلّ ما هو حسّي ومادي ومعنوي وروحاني، ويمدّنا بالقوّة والثبات. وفي هذا السياق، يمكن لاستخلاص المعنى من كلّ ما يحدث أن يزيدَ من سعتنا النفسية.
لكن ضمن ذلك كلّه، تندرج مشاعرُ الحنق والضيق والقهر والإحباط، وكذلك مشاعر الأمل والصبر والحلم والإيمان بانتصار الحقّ والحقيقة في النهاية. تتأثّر تلك المشاعر بشكلٍ أساسي وعلى مستوًى فردي بتجاربنا الشخصية والإنسانية والنفسية، ومخزونها الصدمي. ويختلف هذا الأمر من شخصٍ إلى آخر. لكنّ ما يجمعنا في خضم كلّ ما يحصل هو الشّعور يالغضب، الذي قد يتحوّل أحيانًا إلى شعورٍ بالذنب أو بالعار، فينتُج عنه غضبٌ موجّهٌ ضدّ الذات، وفي أحيانٍ أخرى ضدّ الآخر، فيبدأ الشخص بلوم الآخرين وتخوينهم/ن والهجوم عليهم/ن، أحيانًا من دون تفهّمٍ أو مبرّرات.
فكيف نتعامل مع الغضب؟ عندما نشاهد غيرنا يتعرّض لظلمٍ جائر، نشعر بالغضب. والغضب بشكلٍ عامٍ هو شعورٌ مهمٌّ لأنه يساعدنا على التحرّك لتغيير الواقع، وإعادة ترسيم الحدود، وتحقيق الأمان أو البحث عنه، كما يساهم في إيقاف الأذى، أو الدفاع عن المظلوم ورفع الظلم عنه. لكنّ المشكلة تكمن في تطوّر هذا الغضب مع الوقت، ومدى تأثيره الفعّال الذي يُحدث تغييرًا، أو انعدام فعاليّته، وتأثير ذلك فينا وفي قدرتنا على إحداث تغييرٍ حقيقي.
هنا، يصبح السؤال الفعليّ عن كيفية نجاتنا. يشارك بعض الناس على مواقع التواصل الاجتماعي شعورهم/ن بالذنب نتيجة تمكّنهم/ن من تأمين احتياجاتهم/ن الأساسية من النوم والطعام والراحة، بينما تتمّ إبادة شعبٍ بكامله. يُطلق على هذا الشعور مفهوم «ذنب الناجي/ة»، ويتمثّل بشعور الناجي/ة من الكارثة بالذنب لمجرّد النجاة. ولكن في الحقيقة، لا يعني ذلك سوى أن الناجيَ لم ينجُ على الإطلاق.
في الواقع، تفترض النجاة الفعلية وعيًا وجهازًا عصبيًا جماعيَّين يساعدانا على الركون إلى بعضنا البعض. إذ يمكن لقوّة المجتمع والجَمع أن تزيد من سعتنا النفسية، شرط أن نفهم الغضب وألا ندعه يتجاوز حدود التعاطف والتراحم.
فعندما نتحرّك «معًا وسويًا» يمكننا أن نثِق في قدرة الآخرين على دعمنا بينما نلتقط أنفاسنا، خصوصًا أن الأمور تكون أحيانًا أكبر من أن يحملها شخصٌ واحد، وأخطر من أن ينجو منها الناجي/ة. لذلك، من خلال الحراك الجماعي والثقة فيه والإيمان بتأثيره، يمكن لكلٍّ منا القيام بأقصى ما بوسعه من دون أن يحمل وزر جريمةٍ لم يرتكبها، لأنه يعلم أنه لا يتحمّل مسؤوليّتها وحده.
يتمثّل الحراكُ الجماعي حول العالم في المظاهرات التي تجوب الشوارع دعمًا لفلسطين، والمقاطعة المستمرّة والممتدّة لمنتجات الشركات الداعمة لإسرائيل، وكذلك في حراك المقاومة السّلمية التي تمنع سفنَ الأسلحة من التوجّه إلى إسرائيل.
تساعدنا هذه الأمثلة على فهم أنّ على كلٍّ منا تأدية الدور الذي يقدر عليه، سواء من خلال نشر الأخبار والتطوّرات، أو التوعية بالقضية، أو حتى الحديث عنها بشكلٍ واضحٍ لكلّ من لا يعرف تاريخها.
إنّ تنويع حضور القضية في حياتنا اليومية، وتنويع طُرق دعمنا لها، يساعدنا على المشاركة بقدر استطاعتنا، وفي أوقاتنا المتاحة المختلفة، وبحسب طاقاتنا ومالنا وسعتنا النفسية. والتنوّع يعطينا فرصة الاختيار والقدرة على فعل أقصى ما يمكننا. ففي يومٍ ما، قد تكون سعتك واسعةً بما يكفي لصنع محتوى ذي صلة، أو المشاركة في مظاهرة، أو متابعة الأحداث ونشرها،.وفي يومٍ آخر، قد لا يكون في سعتك سوى حمل الألم ومجرّد الجلوس والحداد، لتعود مجدّدًا في اليوم التالي وتستكمل ما بدأته.
لكن الأهم من الاستمرار بلا هوادةٍ وبسِعةٍ محترقة، هو أن نستمرّ باستدامة، أي أن نقدّم أقصى ما نستطيع وفق سياسة "النفَس الطويل"، وأن ندرك أننا لسنا وحدنا في هذا الألم.
7 نصائح للتعامل مع المشاهد المؤلمة
لا مفرّ في أحداثٍ مماثلةٍ من رؤية مشاهد دموية، سواء برضانا واختيارنا أو من دون استعدادٍ منّا. لا أنصح بمحاولة الامتناع تمامًا عن رؤية تلك المشاهد لأنه سيحدُث مهما التزمتَِ الحذر، في ظلّ تصاعد العنف والقصف وتسارع الأخبار. لذلك، أشاركك بعض الممارسات التي قد تساعدك في هضم التجربة قدر الإمكان حتى تحافظ/ي على صلابتك النفسية ومرونتها، وبالتالي تمارس/ي حياتك اليومية وتتابع/ي الأحداث باستدامة.
النصيحة الأولى: حاول/ي أن تحدّد/ي أوقاتًا معيّنةً لمتابعة الأخبار. قد لا يكون الأمر ممكنًا دومًا، لكن تذكّر/ي أنّ أجهزتنا العصبية تشعر بالإغراق إزاء تسارع الأحداث وثقلها ومداها وفداحتها، ما يقضي على سعتنا النفسية. فحتّى لو تمكنّا من تقديم الدعم لفترةٍ ما، لن نتمكّن من الاستمرار لمدّةٍ طويلة، أقلّه من دون آثارٍ جانبيةٍ مثل الآلام الجسدية، ومشاكل النوم والشهية، والعجز عن إنجاز المهام اليومية، ومشاكل التركيز، ومشاكل التعامل مع المشاعر، والشعور بالاحتراق النفسي…
النصيحة الثانية: حاول/ي قضاء لحظةٍ مع نفسك بين كلّ مشهدٍ أو خبرٍ وآخر. بهذه التكتيكات البسيطة نعطي أجهزتنا العصبية فرصةً لتعود إلى حالة الأمان، بحيث ندرك الشعور والإحساس بالخطر، ونقوى على العودة منه إلى الأمان.
النصيحة الثالثة: عندما نرى مشهدًا دمويًا أو صعبًا، نلاحظ ما نشعر به في أجسادنا. لذلك، لا بد من منح أجسامنا الفرصة للحركة والتناغم مع ما حدث، بما في ذلك البكاء، أو إصدار أيّ صوتٍ كان للتعبير عن الغضب، أو القيام بحركةٍ جسديةٍ ما وإن كانت غير مفهومةٍ أو غير منتظمة.
النصيحة الرابعة: لا بدّ من تنويع الأخبار التي نتابعها. فكما نتابع المشاهد الصعبة والدموية، يجب أن نتابع أيضًا ما يحدث من مظاهراتٍ وأنشطةٍ ينظّمها ويحضرها عشرات الآلاف حول العالم دعمًا للقضية. تابع/ي وتفاعل/ي أيضًا مع صانعي وصانِعات المحتوى الذين ينشرون محتوًى يشرح التاريخ ويبشّر بنتائج الحراك القائم. إنّ الشهادة على الأحداث المؤلمة قد تعرّضك لصدمةٍ نفسيةٍ ثانوية، إلّا إذا قمت بتغيير تجربتك وتغيير سردية الصدمة التي تكرّر في ذهنك أفكارًا مثل: الإنسانية انتهَت، لا أحد يشعر بما تشعر/ين به، أنت وحدك، أنت ضحية، لا يوجد أيّ أمل… يمكن تغيير السردية والتجربة من خلال تنويع المحتوى البصري الذي نتعرّض له. فالمحتوى البصري أقوى بمئات المرات من أيّ محتوًى مقروءٍ أو أخبارٍ متناقلة.
النصيحة الخامسة: امتنع/ي قدر الإمكان عن رؤية المشاهد الصعبة قبل النوم. وفي حال الاضطرار، حاول/ي تفادي المحتوى البصري.
النصيحة السادسة: اختاري مشاهد محدّدةً تشعرك بالأمان، سواء كانت مشاهد المظاهرات الداعِمة للقضية، أو صورًا حيّةً تدلّ على الصمود. احتفظ/ي بها، وعُد/عودي إليها كلّما شعرتَِ بصعوبة المشاهد الدموية والمحزنة. اجعل/ي منها محتواك الاحتياطي اللطيف الذي تلجأ/ين إليه في حال لم تتمكّن/ي من اتباع النصيحة الرابعة.
النصيحة السابعة: شارك/ي غضبك وحنقك مع شخصٍ مقرّب. إنّ مشاهدة حرب إبادةٍ قد تثير ردّ فعلِ الهجوم في أجهزتنا العصبية. والهجوم - كردّ فعلٍ - يحتاج إلى مجموعةٍ تبثّ فيه الدّفع والقوّة. لذلك، استغلّ/ي علاقاتك المقرّبة، واعتمد/ي على الدعم، وتشارك/ي مشاعرك وغضبك وصراخك وحتّى السّباب مع شخصٍ قريبٍ يشاركك المشاعر نفسها. فالتنظيم المشترَك لمشاعرنا يساعدنا على ألا نحبسها في داخلنا.
- 1هي الصدمة النفسية الناتجة عن الشهادة على تجارب الآخرين الصدمية من دون القدرة على تغيير تجربتهم، مثل الشهادة على الحروب، والكوارث الطبيعية، وأعمال العنف، والإبادة الجماعية، والقتل وغيرها. وهي نوع من الصدمات، ولكنها تعد ثانوية لأن صاحبها لم يختبر الحدث بشكل مباشر، وهذا ما ينطبق على الشهادة على الأحداث الصدمية من خلال متابعة الأخبار بشكل مستمر ولاسيما المحتوى البصري شديد الصدمية/الدموي.

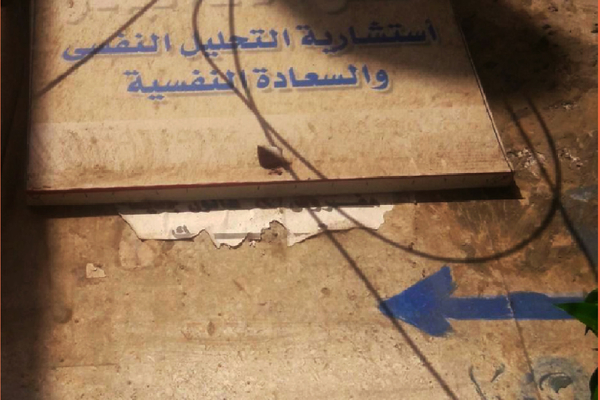

إضافة تعليق جديد