"كنتُ أحاول أن أكون نسوية مرحة، لكنني كنتُ غاضبة جدًا". هذه الجملة للمخرجة الفرنسية الراحلة آغنيس فاردا تطاردني مؤخرًا، حيث تخطر ببالي عند استرجاع لحظات الغضب التي تجتاحني في مواقف حادّة لا تحتمل التأويل شعرت فيها أنني "نسوية على السكين". أتذكّر وجوه الشباب الذين كانوا حولي حينها، والفتيات أيضًا اللاتي كنت أتوقّع منهنّ تعبيرًا غاضبًا أو دعمًا أو تعاطفًا، غير أن ما واجهته في الغالب لم يكن سوى غضب مضاد: غضبٌ من غضبي.
ما الذي يحدث عندما تغضب النساء؟ وما الذي يحدث عندما تغضب النسويات تحديدًا؟ هذا النص محاولة لفهم هذا الفصل القاسي بين "النساء" و"النسويات"، كما لو أن النسويات لا يُنظر إليهن باعتبارهنّ نساء عاديات، بل ككائنات متجردات من أنوثتهنّ. فما الذي يجعل غضبهن غير محتمل؟ ومن يُسمح لها بالغضب ومن تُدان حين تغضب؟
أتساءل: ما هي زاوية الرؤية التي نُظر من خلالها إلى غضب ماريانا باخماير، حين أطلقت النار على قاتل ومغتصب ابنتها داخل المحكمة عام 1981؟ هل عُد غضبها مشروعًا؟ هل كان "مفهومًا" لأنها أم؟ أقصد ما هو الغضب المشروع؟ ومن هنّ النساء اللواتي يسمح لهنّ بممارسة هذا الغضب؟
نشأتُ على قناعة خفية بأن النساء لا يغضبن. يمكن أن يكنّ حزينات، مقهورات، يائسات، لكن غاضبات؟ لا. الغضب فعلٌ له تبعات: تكسير، صراخ، قرار، رفض، مواجهة… وكلها أمور لا يُفترض بالنساء أن يفعلنها. الغضب يفتح أبوابًا لا تُغلق، ويُفترض أن تبقى النساء في أماكنهن، هادئات، صامتات، متكيفات. ولهذا بدا الغضب كأنه شعور لا يُفترض بهن أن يملكنه أصلًا.
لكن الحقيقة ليست كذلك. النساء يشعرن بالغضب طبعًا. لكن المشكلة ليست في الشعور نفسه، بل في التعبير عنه. حين يُكبت الغضب طويلًا قد يتحوّل إلى تجاعيد، إلى شعر أبيض، إلى ورم سرطاني في الثدي، وأنا كلّما نظرت إلى وجه أمي قرأت في تجاعيده لحظات صمتٍ كانت تستحق أن تكون صراخًا. لحظات وجدتها تبكي فيها بحرقة، بدون سبب واضح سوى أنه غضب دفين لم يجد مخرجًا.
السودانيات حين يغضبن
كانت الثورات من اللحظات التاريخية الكاشفة لغضب النساء السودانيات على السلطة والهيمنة الذكورية، إذ شكّلت مساحة جماعية للتعبير عنه.
في ثورة ديسمبر 2018 مثلًا تجاوزت مشاركة النساء نسبة 60%، امتدادًا لدورهنّ منذ ثورة أكتوبر 1964 وما قبلها، فلطالما كنّ في مقدمة صفوف المقاومة، لكن ما ميّز ثورة ديسمبر كان ذاك الغضب العلني الحاد، الذي ساد المشهد وهدّد السلطة بوضوح إلى الدرجة التي دفعت العساكر لقتلهنّ عمدًا في المواكب، وكأن تعبيرهنّ عن الغضب أسقط عنهنّ حصانة "الأنوثة"، فصرن يُعاملن كخصم خطير.
الغضب الذي أخرج النساء إلى الشارع لم يكن موجهًا فقط إلى الجيش أو السلطة، بل كان تمرّدًا صريحًا على كل أنظمة السيطرة: العسكر، الذكورية، السلطة الأبوية، والنظام الرأسمالي.
في قلب الاعتصامات سيّرن مواكب ضد الثوار أنفسهم احتجاجًا على التحرّش الجسدي واللفظي، في مشهد كشف أن الغضب النسوي لم يكن موجهًا فقط ضد السلطة الرسمية، بل أيضًا إلى الامتيازات الذكورية داخل ساحة الثورة ذاتها.
هذا الغضب الجارف والصادق أخاف الجميع. ظنّ العساكر أن النساء سيتراجعن بعد مقتل الشهيدة ست النفور أحمد بكّار (24 عامًا) في حي شمبات شمال الخرطوم، في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، وبعد حملات الاعتقال والاغتصاب اليومية.
كانت تلك آلية النظام الذكوري لمنع النساء من الغضب. حتى المضايقات اللاتي واجهنها من الثوار لم تكن سوى تعبير عن خوفهم من خسارة امتيازاتهم كرجال، لأن غضب النساء خرج عن النصّ وحدود "المعقول"، فلم يعد محصورًا في مواجهة العساكر أو الخصم المشترك، بل امتدّ ليطال البنية كلها بمن فيها الرجال الذين يدّعون الانحياز للثورة وحاولوا إسكات النساء بنفس أساليب العسكر.
هذا لا يختلف كثيرًا عمّا نشهده اليوم في سياق الحرب؛ فالاغتصاب والعنف الجنسي الممارس ضدّ النساء لا ينبعان من قرارات فردية، بل من رؤية جمعية متجذرة في بنية ذكورية تعتبر النساء أدوات وأجسادهن ساحات لتأكيد الهيمنة.
لقد لاحظت ذلك بنفسي، فمعظم الرجال، حتى أولئك الذين يرفعون شعارات حقوق الإنسان، لا يُبدون أدنى اعتراض على الاغتصاب، بل يبرّرونه ويدافعون عنه علنًا عبر وسائل التواصل، باعتباره "انتصارًا" للطرف الذي يقفون في صفه.
يرى البعض في الحديث عن الاغتصاب إلهاءً عن "المعركة الكبرى"، إذ تتمحور رؤيتهم للحرب حول انتصارات الرجال وخساراتهم، بينما تُعتبر النساء وما يقع على أجسادهنّ مجرد تفاصيل هامشية.
مقاومة النساء هي الأمر الوحيد الذي يوحّد جميع الرجال، على اختلاف آرائهم ومبادئهم وأحزابهم ضد خصم مشترك: المرأة الغاضبة. غضب النساء يهدّد النظام، ولهذا يتحالف الجميع لمنع هذا الخطر من تحقيق أي خطوة إلى الأمام إذ يتوقعون منهنّ أن يغضضن الطرف عن العنف والإقصاء وأن يصمتن، لأن هذا ما يُنتظر من "المرأة الصالحة". لا يجب أن يكنّ عنيدات أو غاضبات كما تقول أودري لورد1.
كي لا يطالبن بالمزيد
في حادثة شهيرة انفجرت شابة نسوية غضبًا في وجه رئيس هيئة علماء المسلمين، خلال جلسة نقاش مصوّرة تناولت قضايا الشباب والنساء، إذ عبّرت عن شعورها بالإقصاء، مشيرة إلى أن المتحدثين لم يكونوا من جيل الشباب أصلًا، وأنّ االمشاركات تحدّثن من موقعٍ يحمل تصورات وأحكامًا جاهزة عن الفتيات "المختلفات" عنهنّ، إذ لم تشعر أن الحديث يشملها، خاصة أنها كانت غير محجبة، وهذا وحده كان كافيًا لإسقاط حقها في التمثيل.
تُشكّل هذه الحادثة نموذجًا كاشفًا لحدود الغضب الاجتماعي المسموح بها للنساء، إذ قوبل حديث الشابة بكثير من السخرية والازدراء، ليس فقط من المجتمع التقليدي بل من مجتمع الناشطين والمثقفين تحديدًا. لقد تجاوزت حدود الغضب "المقبول" حين تطرّقت إلى هيمنة متخذي القرار في الدولة، وانتقدت رجال الدين والنظام القائم باعتبارهما نظامًا ذكوريًا يضطهد النساء. وبهذا لامست المحرّمات التي لا يُفترض نقدها، وإن حدث فلا بد أن يصدر هذا النقد عن لسان رجل.
هذه الحادثة لا تختلف كثيرًا عن حالات الغضب النسوي خلال الثورات؛ إذ يصدران من نقطة انطلاق واحدة، إلا أن الحالة الأولى فردية والثانية جماعية. ومع ذلك لم يكن الغضب مسموحًا في الحالتين لأنه لا يخدم مصالح الرجال. إنه غضب يخصّ النساء ويعبّر عن مصالحهن، ولهذا يُقابل بالاستهتار كوسيلة لتقويضه وتجريده من جديّته وتأثيره.
كتب كثيرون عن تلك الشابة التي صرخت في وجه رئيس هيئة علماء المسلمين في السودان، منتقدين حديثها عن حرية اللباس والتفكير، بذريعة أن السودان بلد إسلامي وأن عليها احترام ذلك2. لكن حديثها لم يكن عن الدين بقدر ما كان رفضًا لربط اللباس بمشروعية التحرّش. كانت ببساطة تحاول القول إنها تملك الحق في ارتداء ما تشاء دون أن تتعرض للمضايقة، إذ نعرف جميعًا أن التحرش لا علاقة له باللباس، وأنه يحدث في كل الحالات ومع فتيات يرتدين أنماطًا مختلفة من الملابس.
يمكن فهم هذا الإصرار على الربط بين اللباس والتحرّش كواحدة من الآليات التي يستخدمها المجتمع الذكوري لمواجهة أي شعور بالحرية لدى النساء، فمن يزعم أن لباسًا معينًا "يدعو" للتحرّش، يعرف في قرارة نفسه أن ذلك غير صحيح. لكنه يقول ذلك كوسيلة للمنع، فهو إن سمح لهن اليوم باللباس الذي يردنه، فسيطالبن غدًا بالمزيد.
لا تكسري كلمته
شهدتُ موقفًا لصديقة منعها والدها من مواصلة تعليمها بعد الثانوية دون سبب مقنع، ورغم كونها ذكية ومجتهدة كان والدها يشجّع شقيقها على الدراسة رغم أنّه لم يكن يرغب في استكمالها أصلًا.غضبت بشدّة وامتنعت عن الطعام ورفضت مغادرة غرفتها أو التحدث مع أحد. ورغم ذلك لم يستجب والدها لرغبتها، ووقف الجميع ضدها، حيث قُوبل غضبها باللوم والغضب المضاد.
كان هذا الغضب المضاد تعبيرًا عن حرص بفرض الهيمنة الذكورية، إذ كان يفترض بها أن تطيع والدها حتى وإن كان مطلبها الوحيد هو الاستمرار في الدراسة. لم يكن الأمر متعلقًا بالتعليم فقط، بل بالخوف من التمرّد. لم يكن ليسمح لها بالانتصار لأنه يهدّد سلطة مجتمعٍ بأكمله، ويحفّز فتيات أخريات على الغضب والمواجهة، ورفض قرارات الآباء، وهو ما يُعدّ مرفوضًا اجتماعيًا، بل ومُدانًا شرعيًا أحيانًا.
لقد توحّد الجميع ضدها، لا لحماية المصلحة، بل لحماية مكانة الأخ والأب وقمة الهرم الذكوري الذي لا يجوز كسر كلمته أو التشكيك في قراراته.
"الهرمونات"
هناك ظاهرة اجتماعية متأصلة في المجتمعات السودانية تُعرف بـ"الجودية"، وهو مصطلح سوداني قديم يشير إلى تسوية الخلافات بين أفراد المجتمع بدون اللجوء إلى المحاكم الرسمية. "وتعني الجودية الأجاويد، وهي الجماعة التي تلعب دور الوساطة بين المتخاصمين لحل خلافاتهم بالحسنى والتراضي، مستندين في ذلك على الأعراف والعادات والتقاليد الموروثة في المجتمع المعين"3.
وإلى جانب دورها في حل النزاعات القبلية وإنهاء الحروب الأهلية، تؤدّي الجودية دورًا اجتماعيًا في معالجة الخلافات الزوجية. فعندما يحدث الطلاق يجتمع الأعيان؛ وهم رجال يُعرفون بالحكمة وكلمتهم مسموعة، للتوسط بين الزوجين. يبدأون عادة بالجلوس مع الزوج لمعرفة موقفه ورغبته في إعادة زوجته، ثم يجتمعون بالزوجة التي ترفض العودة رغم محاولاته.
في هذه المساحة يُسمح للزوجة بالتعبير عن غضبها. يمكنها أن تصرخ، توبّخ، تشتم، تلعن، أي تعبّر عن ألمها بأي شكل حتى في حضرة الأعيان. هذا السماح ليس اعترافًا بغضبها كحقّ فردي، بل ينبع من تقدير المجتمع لمكانة الأسرة، وحرصه على "تفريغ" ذلك الغضب بما يسمح للزوجة بالعودة إلى البيت بدون ضغينة، فالغضب هنا مقبول لأنّه يخدم هدفًا جماعيًا: إعادة تماسك العائلة الصغيرة والممتدّة.
في الإطار نفسه تسمح الحدود الاجتماعية للمرأة الحامل أيضًا بأن تغضب، إذ يُتاح لها أن تصرخ في وجه زوجها وأن تؤنّبه بل وأن تطرده من المنزل أحيانًا. لكن هذا القبول المشروط بالغضب كما في حالة الطلاق، لا يعبّر عن اعتراف حقيقي بإنسانيتها أو بحقّها في الغضب، بل يُمنح لها مؤقتًا ومن داخل منطق حماية العائلة، لا من منطلق احترام مشاعرها الفردية.
تُبيّن هذه الأمثلة المختلفة بوضوح حدود الغضب المسموح به للمرأة السودانية، والمبرّرات الاجتماعية التي تشرّع هذا السماح، فالغضب المعقول في السياق السوداني هو ذاك الذي لا يُهدّد البنية القائمة، ولا يسعى إلى تغيير جذري أو مساءلة الثوابت. هو غضب مقبول فقط حين يُفهم كأثر جانبي لتغيرات هرمونية كما في حالة الحوامل، أو حين يُختزل في المطالب الزوجية البسيطة التي لا تتجاوز حدود البيت كما في نموذج الجودية. لكن ما إن يتجاوز الغضب هذه الدوائر ويتحوّل إلى موقف سياسي، أو تمرّد على السلطة الأبوية، أو رفض للتراتبية الجندرية، حتى يُصبح مرفوضًا وغير عقلاني في نظر المجتمع ويُقابل بالردع.
"سبب البلاء"
منذ وقت طويل، يواجه غضب النساء ومطالبهن بأشدّ الوسائل عنفًا ووحشية. اغتُصبن، قُتِلن، وأُحرِقن لأن غضبهن قابل للانتشار، ولأنه إذا تُرك ليتراكم غضبًا فوق غضب، فإنه يهدد بانهيار البنية الذكورية المتهالكة. يخرج رجال الدين ليعلنوا أن الفتيات غير المحجبات هنّ سبب البلاء، وأن وجود النساء في المجال العام هو أصل الأزمات والمآسي التي يعيشها المجتمع السوداني.
لكن الحقيقة أن غضب النساء وسعيهن لنيل حرياتهن لا يقود إلى الهلاك. بل هو قوة تحرّكنا نحو إعادة تعريف الشروط التي نعيش ونعمل وفقها، وبحسب رأي أودري لورد "ليس غضب امرأة سوداء هو ما يتحول إلى عمى وقوة لا إنسانية تسعى إلى إبادتنا جميعًا، ما لم نواجهها بما لدينا، بقدرتنا على الرؤية وإعادة البناء، غضبًا تلو الآخر، حتى نبني مستقبلاً من الاختلافات التي يخصّب بعضها بعضًا، وأرضًا تدعم خياراتنا. ونحن نرحبّ بكل امرأة يمكن أن تلتقينا وجهاً لوجه، متخطيات التشيئ والشعور بالذنب"4.
بهذا المعنى فإن غضب النساء السودانيات، سواء أثناء الثورة أو في تجاربهن الفردية، هو غضب تغييري عدالته في قدرته على مساءلة البنية لا الانصهار فيها، وهو الغضب الذي يجب أن يتراكم حجرًا فوق آخر حتى يصير أساسًا لمجتمع مختلف.
في الختام كما قالت نوال السعداوي: "الخوف هو المرض الذي يعيق الإبداع والنبوغ"، إذ علينا نحن النساء أن نوجّه غضبنا لما يدور حولنا. أن نغضب من أجل النساء اللواتي يُقتلن في فلسطين، ومن أجل السودانيات اللواتي يُغتصبن ويُهجّرن. علينا أن نغضب بوعي وثبات، بثورة يومية ضد الظلم والاضطهاد. لسنا مطالبات بأن نكون "نسويات سعيدات" لا نُعكر مزاج أحد. بل ربما حان الوقت لنقتل البهجة الزائفة ونشيّعها إلى مثواها الأخير، لنصنع سعادة حقيقية تستحق أن تُعاش.
تقول وديعة فرزلي: "ليس من السهل الإفصاح عن مشاعر الغضب والبؤس لأن السعادة بحسب ما يروج، هي التزام ومسؤولية تجاه الإحساس الجمعي بالرضى، ولذلك فإن أي تعبير عن عدم الإحساس بالسعادة هو مسؤولية فردية يتحملها الأفراد أو الفئات الذين فشلوا في الوصول إلى السعادة"5.
ليس من السهل التعايش مع نظرات النقد المستمرة، ومع الوصف الدائم بأننا "نكديات"، لكن الخوف من هذا التصنيف هو الحاجز الحقيقي الذي علينا كسره، فالغضب ليس عيبًا، بل هو تعبير عن الشجاعة، وهو الوقود الذي يدفعنا إلى المضي قدمًا، فالإنسان "عندما ينفجر غضبه يعيد اكتشاف براءته، ويصبح قادرًا على معرفة نفسه من حيث إنه هو الذي يخلق نفسه"6.
تستطيع المرأة الغاضبة أن تدرك نفسها بوضوح، وأن تضع حدود غضبها وفق مبادئها ورؤيتها. لا المجتمع ولا القانون يملكان سلطة تحديد ما يغضبها. فعندما يفقدان هذه السلطة، يفقدان شرعيتهما في تعريف سعادة النساء، ويخضعان لهذا الغضب بالشكل الذي ينبغي أن يكون عليه.
- 1
سارة أحمد، نسويات قاتلات البهجة، ترجمة: دانا علاونة، مجلة إختيار https://www.ikhtyar.org/writings/.
- 2
محمود جميل، حينما صرخت وئام شوقي: بين الحرية الشخصية والالتزامات الدينية https://www.aljazeera.net/blogs/2018/10/11/.
- 3
أحمد سمي جدو محمد النور، الدور التاريخي للجودية في دارفور والقلد في شرق السودان في فض النزاعات، مجلة القلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية (العدد الثالث: 2021). ص 109.
- 4
أودري لورد، استخدام الغضب: مواجهة النساء للعنصرية، ترجمة: تامر موافي، مجلة إختيار. https://www.ikhtyar.org/wp-content/uploads/2015/03/
- 5
وديعة فرزلي، أريدك فقط أن تكون سعيدًا، الجمهورية: 2020.
- 6
الزواوي بغورة، الهوية والعنف نحو قراءة جديدة لموقف فرانز فانون، مؤمنون بلا حدود: 2015. https://www.mominoun.com/articles/
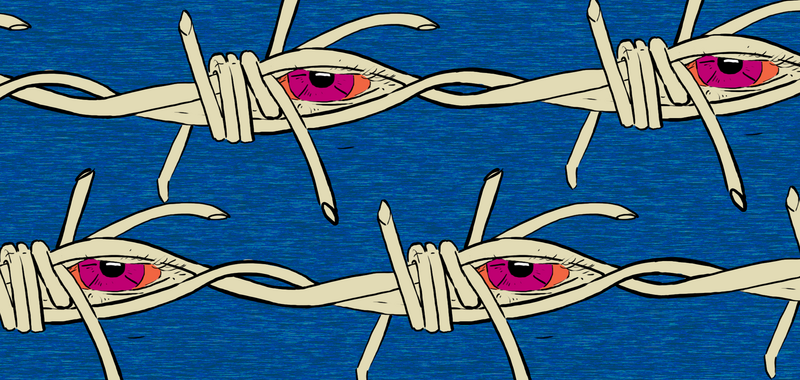
إضافة تعليق جديد