ونحن نعيش على وقع نهاية العالم، أو على الأقل أحد السيناريوهات الأكثر معقولية لنهايته، تطفح على وجه المجتمع عاهاته، كغدير راكد بعد رجّة أرضية.
هي حرب بيولوجية حقيقية يخوضها العالم في "الجُحر" (الحجر) الصحي، كان البعض محظوظًا بما يكفي (لأن أجورهم الشهرية، أو أرباحهم المالية سارية رغم مكوثهم في المنزل لمدة أسابيع أو أشهر) كي يتفلسفوا ويخمّنوا أنها هدنة يُقدّمها الكون لسكان الأرض من البشر حتى يتمحّصن ويتأملن في ماضيهن ومستقبلهن بالفعل، عالم تكون فرصة التفكير فيه امتيازًا يقايض في معظم الأحيان بالبقاء، هو عالم يحتاج على الأقل، إلى هدنة.
نتذكر أن للطبيعة علينا ديون أضحت منذ عقود غير قابلة للتسديد وندرك أنه يحق لها أن تكشّر عن أنيابها وتثأر ممن سمحت له نفسه الخاوية المتضخمة أن يتمثلها في مرتبة دونية عنه، فيستعبدها ويستغلّها بصفة فاحشة.
في ظل جليد التباعد الاجتماعي الإجباري وضرورة التواصل الافتراضي، ذهب البعض إلى وجوب استغلال هذه الفاصلة (رغم كارثيّتها الظاهرة) لمساءلة أولويات الفرد بعد أولويات الإنسانية. فرصة، حسب هذه المقاربة، لولادة عدوى القناعة والامتنان لما لطالما كان وجوده مفروغ منه. مساحةٌ لاستعادة المعنى.
من الملفت كيف لجُسيم مجهري أن يدفع كل هذه الأعين الواسعة لتلتفت إلى ذواتها، إلى الحياة البشرية الداخلية المهجورة، إلى زوايا نظر مغبرّة أو "مستجدّة". لكنّ هذه الهباءة البيولوجية الحاملة للوباء، تُنبّه بوباء هو الآخر لا يُرى، ماكر يحتمي بجدران، يترعرع داخل الأسوار في صمت إلا أنه حصّاد للأرواح على حين غرّة.
في عزل عن العالم الخارجي، ننغرس في بيوتنا إلزامًا وكذلك في ديناميكيّاتنا الأسرية والاجتماعية السامة. هذه العلاقات المختلّة في وظائفها وأسسها، كان لنا -في أيام ما قبل العزل- أن ننكر وجودها ربما، أن نطمس آثارها بأحمر شفاه، أن نطور ضدها آليات دفاع بالذوبان في واجبات العالم الخارجي اليومية. ثم تختفي فجأة ضوضاء الفروض ويضحي من المستحيل إخفات صوت الروابط المتكسرة المتزعزة المريضة.
إن العنف المسلّط على النساء في بيوتهن أو (المورّد من) خارجها؛ جنسيًا كان أو ماديًا أو نفسيًا أو اقتصاديًا، واحدٌ. هو بصدد التعرّي أمامنا لأن مساحة زمانية ومكانية أوسع أُتيحت له كي يتضخّم إلى حد يصعُب تجاهله. ولا مفرّ لنا من أن نبصره منعكسًا على المرآة التي "أهدتنا" إياها الجائحة، لنُصارح أنفسنا بالجرائم الواقعة علينا.
في مثل هذه الظروف القاتمة، تتسع هوّة التفاوت على حساب الفئات الأكثر هشاشة التي اعتاد المجتمع تهميش معاناتها -النساء تحديدًا- ويكتسي غياب المساواة حملًا أثقل.
نرى كيف تجد الإنسانية بقاءها رهين المهن المرتبطة بالتنشئة الاجتماعية الملقاة على عاتق النساء
نرى هذه الهوّة اليوم بالعين المجرّدة دون عناء إنزال الناكرين الأزليين من أبراجهم العاجية الى أرض الواقع، ونرى كيف تجد الإنسانية بقاءها رهين المهن المرتبطة بالتنشئة الاجتماعية الملقاة على عاتق النساء من رعاية وتنظيف وطبابة. في تونس، السجينات كذلك منخرطات في مهمة إنقاذ العالم، فيُحوّلن السجون إلى مصانع كمامات. نساء ينحتن من ظلمة عالمهن نقاط ضوء بأياد مكبّلة على اختلاف القيود، في سجونهن على اختلاف الجلادين.
مهن في الصفوف الأولى من الدفاع وأقلّها حماية، في ظل ظروف عمل كارثية أساسًا. ورغم ديمقراطية هذا الفيروس وعدم انتهاجه للتفرقة، لا على أساس الجنس ولا الطبقة الاجتماعية، فإن الإجراءات المتّخذة لمجابهته ما تزال غير متكافئة وما تزال النسوة تدفعن الثمن الأبهظ.
فهل يأخذ اليوم أصحاب الشركات والمسيِّرون لدواليب الدول بعين الاعتبار، في مهام العمل عن بعد الموكَلة للنساء، كل الأدوار الأخرى التي يضطلعن بها والتي رسّختها النمطية الجندرية؟
لا أظن أنه خطر ببال أحدهم أن يحاول تخيل يوم في حياتهن في ظل الوضعية الوبائية. أن تجتمع المعلمة والأم والزوجة والمعالجة النفسية والمسؤولة في شركة وعاملة النظافة كلها في شخص واحد، يوميًا وبدوام كامل، وألا يُقرّ بنصف هذه الاعمال، أمرٌ صعب التصور فعلًا. تنكبّ الأمهات العاملات، في عودتهن إلى "حيّزهنّ الطبيعي" -حسب النظام الأبوي السائد-، على الأشغال المنزلية، يعتنين بالأبناء وبتعليمهمن عوضًا عن المدرسة الموصدة أبوابها وغيرها من الأعمال غير مدفوعة الأجر، التي لا تجد طريقها إلى عجلة الاقتصاد رغم كونها المحور الأساسي الذي تُبنى من حوله الثروة.
عجلة اقتصاد مطلوقة العنان، تدور وتدور ونُبيح لها دهس كل ما يعترض طريقها ونوجِد، في ردة فعل تكاد تكون أوتوماتيكية، كل الوسائل لحمايتها من تداعيات الفيروس قبل أن نوجدها لحماية الإنسان. "حماة العجلة" هم نفسهم أولئك الذين لا ينفكّون يعلنون في كل فرصة أن الخلاص من هذه الأزمة لا يكون إلا جماعيًا وبالتفكير في الجميع على قدم المساواة.
خلاص جماعي… ولكن بأي ثمن؟
عالم مشحون بالخوف، مستقبل تبدو ملامحه ضبابية، انطواء على الذات، انغماس في أعباء خانقة، استنزاف للقوى البدنية والعاطفية؛ هي مكونات الوصفة الفعّالة لخلق حالة من الضعف النفسي والاكتئاب. ولكن ماذا لو كان كل هذا يجري داخل بؤرة عنف نفسي أو جسدي سابقة للوباء، نلوذ بها من الوباء؟
انزواء الضحية وعزلها عن أي نوع من الدعم، الحدّ من حرياتها وأفق خياراتها، كلمات مفتاحية في استراتيجيات المعنِّف، يأتيه بها فيروس الكورونا المُستجد بلا عناء. فتغدو مدة الحجر الصحي مدة ترهيب مفتوحة الأمد يمتد طيفها من المضايقة والتحقير والمسّ بالكرامة، مرورًا بأسلوب "المصعد العاطفي" للمزيد من التلاعب بالمشاعر والابتزاز وصولًا إلى تهديد السلامة الجسدية.
يضحي الأمر أشدّ خطورة حين تتعالى بعض الأصوات منادية، بالفعل، بقمع مثل هذه التساؤلات. لقد تعودنا على أنه لا يوجد توقيت مناسب لطرح الإشكاليات النسوية أبدًا وتكتسي الأعذار المبررة لذلك مشروعية زائفة خاصة عند المرور بظروف حرجة. وكأن المطلوب من النساء هو أن يكففن عن الوجود إلى أجلٍ غير مسمى.
تُخمد أصوات النساء بصفة ممنهجة لأن صلوحية الحق في التعبير ومناصرة القضية النسوية، لا تتجاوز مدة الحملات الانتخابية. الحق في التغطية الاجتماعية من خلال عقود تضمن الحقوق من تأمين صحي وضمان اجتماعي، والحق في كرامة العيش، والحق في تثمين المجهودات المنزلية والاعتراف بها، والحق في المساواة والحماية لم يكونوا يومًا من الأولويات، حتى وإن كنّا حاليًا في أمس الحاجة إلى قشة نجاة كهذه، ليس للنساء فحسب وإنما لجميع القابعين على الخيط الرفيع بين الحياة والموت.
أليس من العبث أن تُقام حجة الحياة في وجه من لم تُطالبن بأكثر من حقهن في الحياة؟
يُصوَّر الحديث عن القضايا النسوية كترفٍ للمترفات.ين، خلال أزمة عالمية غير مسبوقة همّها الأكبر البقاء. لنا أن نتساءل إذا كان لنساء مكتئبات، معنَّفات، مهمَّشات، مُفقّرات، ومُحمّلات أكثر من طاقاتهن، نفس هاجس البقاء الذي يحرّك كوكبنا اليوم. أليس من العبث أن تُقام حجة الحياة في وجه من لم تُطالبن بأكثر من حقهن في الحياة؟
إن الأزمات ليست انقراضًا للنضالات، وإنما وجب أن تكون على العكس، لحظة تجدّدٍ لليقظة والكفاح.
علينا أن ندرك أنه لا يمكن أبدًا اتخاذ الجائحة ذريعة لسلب الحق في التعبير أو لازدهار مساعٍ (خاسرة مسبقًا) لطمس ما لم يعُد بالإمكان التستّر عنه. بل إنها اليوم فرصة للمناداة عاليًا بالمساواة في الحقوق، لأن حقيقة تجارب النساء المريرة لم تكن يومًا بمثل هذا البريق.
لقد برهنت الأزمة على أن العنف المسلّط على النساء يجد جذوره في غياب المساواة وينتعش في مناخ قانوني ومؤسساتي وعُرفي متسامح معه، وأنه ليس مُجرّد تجلٍّ للتفاوت كما يُدّعى وإنما وسيلة في حد ذاته لتخليده.
فماذا يعني ذلك بالنسبة للنسوية ككل؟ هل أن هذا الإثبات كفيلٌ لاقتلاع اعترافٍ نهائي بأن البطريركية والرأسمالية وجهان لعملة واحدة؟ هل أن تشخيصًا شاملًا للوضع وإزاحة الستار عن المسائل الطارئة كافيان لإحداث تحوّلٍ ملموسٍ في قلب النظام العالمي؟ هل من الواقعي اليوم تصور نهضة القضية النسوية في سياق ما بعد الوباء؟
الخطوة الأولى إلى ذلك في تقديري هي ضمان عدم تنفيذ مخطّطات الانعاش الاقتصادي التالي للأزمة على ظهور النساء كالعادة. فقد اتسعت الأعين بلا شك، أكثر من أي وقت مضى، بقي الآن للأصوات النسوية والنسائية أن تستلهم من ثورة كوكبنا علينا، كيف تُطلق حبالها كي يُصغيَ الجميع.
في هذه الأثناء، أُفضّل أن أتنزّه بأفكاري، في شوارع مدينة Equiterra، مدينة فاضلة بمقاييس عصرنا، مسالمة للنساء والأرض، لا مكان فيها للقوالب النمطية، تتكافأ فيها الفرص والحقوق والواجبات، ملوّنة بألوان الاختلافات التي تتعايش في كنفها، تصوّرها بعض الفنانات.ين، في صفحة هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
لنا أن نتفكر فيما يجري، وعلينا أن نتحرك. لنا أن نحلم بعالم يحتضننا بعدل. لكن في الوقت الراهن نقول لكل اللواتي يعانين في صمت: على هذه الأرض المريضة ما يستحق الحياة و … من تُفكر فيكُنّ.
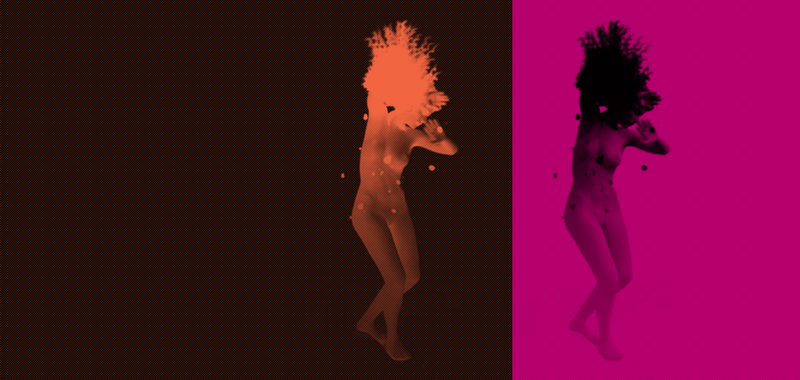
إضافة تعليق جديد