يُشبه الأمر السقوط من أعلى قمة جبلٍ إلى سفحه من دون الانتباه لعملية السقوط حتى تتمّ وتتركك تتلوّين ألمًا. هذا ما يحدث لمثيلاتي من المصابات باضطراب ثنائي القطب عندما تنتابنا أزمة المزاجية التي تحلّ بنا من حيث لا ندري، ومن دون سابق إنذارٍ أو إشعار.
منذ مراهقتي عرفتُ في داخلي بأن ليس للأمر علاقةٌ بالاكتئاب لأني لم أكن مكتئبةً طوال الوقت، بل كانت حالاتٌ تأتي وتذهب. كنتُ أقرأ عن عوارض الاكتئاب فأجدها لا تنطبق على حالتي التي تتأرجح بين كوني مبتهجةً جدًا وحزينةً جدًا. ففي كل مرةٍ يتصاعد مزاجي بوتيرةٍ صاروخية، ثم لا يلبث أن يستقر حتى يهوي كنيزكٍ ليصطدم بالأرض بقوةٍ تتركني مُعذبة. تقدّمَت بي السنون لأنتقل من المراهقة إلى الرشد وتصبح مسألة التأرجح المزاجي غير قابلةٍ للتبرير كإحدى سمات المراهقة. صرتُ أحمل وزر حالتي التي ليس لي يدٌ فيها.
كان مستبعدًا جدًا أن أفكر في زيارة مختصٍ نفسيٍ أو مختصةٍ نفسيةٍ لأن فكرة الزيارة تعني أمرًا واحدًا، هو أني مريضةٌ نفسيًا أو عقليًا، أو بمعنًى آخر "مجنونة"، بحسب الاعتقاد المجتمعي الذي ترعرتُ في كنفه واكتسبتُه عبر قنوات التعليم العمومي أيضًا. في المجتمع الذي نشأت فيه، والذي يمكن اعتباره مجتمعًا ذكوريًا بامتيازٍ كما البلد بأسره، لا تطأ أقدام النساء عيادةً للطب النفسي لأن وصف "المجنونة" سينتظرهنّ عند باب العيادة. إذ أن تكوني امرأةً هو في حدّ ذاته نقصٌ فكيف إذا كنتِ امرأةً مجنونة؟! خوفًا من التعرّض لهذا اللقب البغيض، تظل فتياتٌ ونساءٌ كثيراتٌ أسيرات المعاناة النفسية بصمتٍ مطبق، ويخفين معاناتهنّ كي تبقى صورتهنّ في العائلة والمجتمع صافيةً وخاليةً من أي شوائب قد تعرقل مسيرتهنّ المرسومة مُسبقًا من طرف النظام الذكوري؛ نظامٌ يُعدن إنتاجه بدورهنّ.
بقيتُ أصارع وأحاول أن أقنع نفسي بأنّ العمر سيتكفّل بمعالجة حالتي. أفرح بشدةٍ وأحزن بشدةٍ أكبر وأغضب إلى حدود الهيجان وفقدان السيطرة أحيانًا كثيرة، إلى أن قابلتُ شخصًا يتعايش مع حالتي ذاتها. أنقذني ذلك الشخص من حيرتي وأخبرني بأنّ الحالة تسمّى الاضطراب ثنائي القطب.
تظل فتياتٌ ونساءٌ كثيراتٌ أسيرات المعاناة النفسية بصمتٍ مطبق، ويخفين معاناتهنّ كي تبقى صورتهنّ في العائلة والمجتمع خاليةً من أي شوائب
لم أكن قد سمعتُ عن ذلك الاضطراب من قبل. فكّرتُ في زيارة مختصٍ نفسيٍ أو مختصةٍ نفسيةٍ، وجاهدتُ لأُبعد الأفكار المسبقة التي زرعوها في عقلي عن الطب النفسي. كنتُ بحاجةٍ للتأكد من حقيقة إصابتي بذلك الاضطراب، ومنح الشرعية لحالتي التي كانت تفاجئني أنا نفسي في كثيرٍ من الأحيان. كنتُ اكتفيتُ من الاستماع إلى التشخيصات والآراء العشوائية بشأن حالتي، وتحديدًا تلك التي تُسرع إلى تشخيصي بالاكتئاب وكأنه الاضطراب الوحيد! في الواقع، أنا امرأةٌ إيجابيةُ الميول، أرى الحياة على نحوٍ إيجابي معظم الوقت، ولعلّ ذلك ما دفعني للاحتفاظ بحياتي في محطاتٍ كثيرة.
على أيّ حال، اقترح عليّ الشخص ذاته زيارة أحد المختصّين، فحجزتُ موعدًا وسافرتُ إلى العاصمة مجهّزةً نفسي لحضور جلسة التشخيص. نادت عليّ السكرتيرة: 'ميساء!'، وما هي إلا ثوانٍ حتى كنتُ أجلس قبالة المعالج المختص. سألني إن كنتُ أمارس أي عملٍ إبداعي فأجبتُه: "أعتقد أنّي أتقن الكتابة!". ثم سأل عمّا إذا كان أحد أفراد العائلة كوالدتي أو والدي أو أحد أقاربهما يعاني اضطراباتٍ نفسية، إذ تعتبر بعض الدراسات أن الإصابة بالاضطراب ثنائي القطب تعود إلى عوامل جينية.
استمرّ بطرح أسئلة:
- ما الذي يُفرحكِ؟
- سَلني سؤالًا غير هذا.
- ما الذي يُحزنكِ؟
- لا يُحزنني الشيء نفسه دائمًا.
انتهت جولة أسئلته المُلغّزة وإجاباتي الضبابية، وشخّص حالتي بالاضطراب ثنائي القطب من الدرجة الأولى. لم أشكّك مطلقًا في تشخيصه، لأن ما كنتُ قرأتُه عن هذا الاضطراب كان مطابقًا نوعًا ما لما كنتُ أمرّ فيه. قال لي المعالج أن لا شفاء من هذا الاضطراب، لكن من الممكن تحقيق بعض التوازن العاطفي واستقرار المزاج عن طريق تناول جرعات الليثيوم. رفضتُ بشكلٍ قاطعٍ تناول تلك المادة، ودُهش المعالج لرفضي العلاج قبل أن أعرف حتى مزاياه وآثاره.
رفضتُ يومها تناول الليثيوم وإن كان العنصر الكيميائي الأخفّ بين كل المعادن المعروفة والمستخدمة في صناعة الأدوية. أرفض الدخول في دوامة الاعتماد على جرعة 1000 ميليغرام من الليثيوم والتحوّل إلى رقمٍ جديدٍ يُضاف إلى عدّاد مستهلكيه. ولا زلتُ أصرّ على الرفض بالرغم من النوبات الاضطرابية الصعبة التي تلمّ بي وتتسبّب بمعاناتي إلى حدٍّ يستعصي على الوصف. فكثيرًا ما تتداخل فيها العوارضُ الفيزيولوجية والنفسية وتدفعني إلى أن أعيد التفكير في رفضي تناول الليثيوم لتفادي الإصابة بنوباتٍ تُحيلني من إنسانةٍ طبيعيةٍ تمارس حياتها بشكلٍ عادي إلى أخرى تعجز حتى عن النهوض من فراشها وتغرق في نوبة حزنٍ حادةٍ مصحوبةٍ بأفكارٍ انتحاريةٍ أحيانًا.
أرفض الدخول في دوامة الاعتماد على جرعة 1000 ميليغرام من الليثيوم والتحوّل إلى رقمٍ جديدٍ يُضاف إلى عدّاد مستهلكيه
من جهةٍ أخرى، يعود رفضي تناول الليثيوم إلى رفضي الخفيّ لاضطرابي. هو رفضٌ غير واعٍ، رغمًا عن جزئيَ الواعي الذي يدرك أني أعاني الاضطراب ثنائي القطب، ورغمًا عن تقبّلي حالة الفرح المتطرّف والحماسي التي أعيشها، وتألّمي لحالات الحزن الجنائزي التي تستبدّ بي، وانزعاجي من حالات الغضب الهوجاء التي غالبًا ما أنتهي منها منهكةً بعد أن تمتصّ كامل طاقتي. هو رفضٌ يأتي من عدم تقبّلي اختلافي عن معظم الفتيات الأخريات اللواتي يُحزنهنّ تأخر حبيبٍ في الرد على رسائلهنّ، وتفرحهنّ ترقيةٌ في العمل ويغضبهنّ تصرفٌ طائشٌ من صديقةٍ ما. أرفض الليثيوم لأن القبول بتناوله يعني قَبولي بواقع اضطرابي، وهو أمرٌ لم أتقبّله بعد بالرغم من اعترافي به.
في أحد الأيام، نجحتُ في تجاوز إحدى أسوأ النوبات وأطولها بعد أن كنتُ قد كرّرت على مسامع كل من عايشها معي أنّي "لا أقوى على العيش".
نجوتُ، وعشتُ، واستطعتُ كتابة هذا النص.
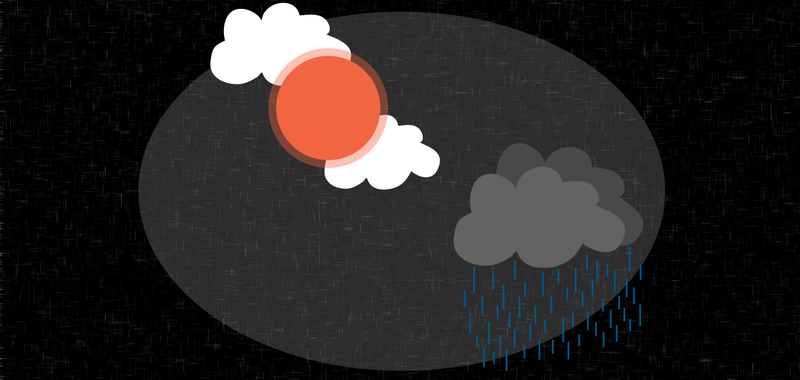
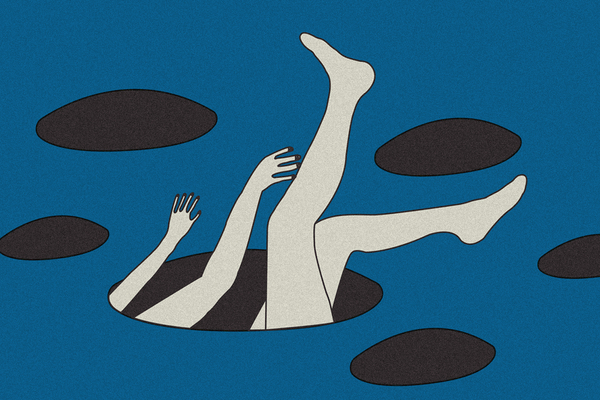

إضافة تعليق جديد