لم تكن محدّدات العفّة في المرأة أو الرجولة في الرجل، ثابتة عبر التاريخ ولا مدوّنة في قائمة مغلقة يُحتكم إليها لتثبيت العفّة أو الرجولة أو لنزعهما، بل هي قائمة مفتوحة تُفرز محدّدات جديدة وتهمل أخرى، وتغضّ الطرف عن بعضٍ منها لأسباب كامنة في النفوس، قد تنكشف مع الزمن أو تبقى طيّ الكتمان.
وقد صاغت الثقافة العربيّة في طوريها البدويّ والحضريّ، وعلى امتداد مسارها التاريخي من الجاهليّة إلى اليوم، نماذجها الخاصّة في تحديد معنى "الطهريّة" لدى المرأة والرجل، وهي نماذج تفسّر كثيرًا من ملامح المجتمع العربي وشخصيّته القاعديّة.
ألفاظ الوصم في اللغة: فوضى النعوت "المنظّمة"
الوصم هو إخراج للرجل أو المرأة من مجال الحُرمة الاجتماعية إلى مجال الحرام بالمفهوم العُرفي والديني، ويشبه فعلَ تجاوزِ العتبات les seuils، من المقدّس le sacré إلى المدنّس le profane، كما في اصطلاح مرسيا إلياد.
ورغم أن فعل الخروج من الطهرية يبدو واحدًا لدى المرأة والرجل، إلا أن اللسان العربي لم يتعامل دائمًا مع هذا الخروج بالألفاظ نفسها. نلاحظ – رغم وجود نعوت مشتركة – نوعًا من "الفرز" الاصطلاحي، حيث تُوجَّه صفات مخصوصة إلى المرأة دون الرجل. وينعكس هذا التمايز في المعاجم العربيّة القديمة، كما يُبيّنه الجدول التالي، علمًا بأن هذه الاصطلاحات شهدت تحوّلات حديثة سنتطرّق إليها لاحقًا.
|
نعوت مشتركة |
نعوت للمرأة فقط |
نعوت للرجل فقط |
|
امرأة عاهرة ورجل عاهر |
امرأة قحبة |
رجل مأبون |
|
امرأة زانية ورجل زانٍ |
امرأة بغيّ |
رجل مجبوس/ جبيس |
|
امرأة فاجرة ورجل فاجر |
مومس |
رجل مخنّث |
|
امرأة منيوكة ورجل منيوك |
داعر |
رجل دعبوب |
ويمكن أن نصوغ ثلاث مقدّمات أساسيّة من هذا التمثّل المعجميّ الأوّلي:
- أوّلًا: ألفاظ التصنيف الجدولي تمثّل المشهور فقط من المتداول في اللسان العربيّ القديم، وقد جرى اجتناب بعض الألفاظ لكونها من الغريب المهجور، مثل: المتدثّر، العصيد، الدقفانة، الممحون، الخيعامة، المثفار. وغيرها1.
- ثانيًا: أغلب النعوت المشتركة (من الصنف الأوّل) لا تشير إلى اشتراك في الفعل، بل في مجرّد النعت؛ إذ ثمّة فارق جوهريّ في موقع الذات من الفعل؛ فالرجل العاهر يُفهَم على أنّه "فاعل" أي "لا يُؤتى من خلف"، بينما تُفهَم العاهرة على أنّها "مفعول بها". وينطبق ذلك أيضًا على نعتَي الزاني والفاجر، باستثناء "المنيوك" التي تُصرّح بمفعوليّتها. وهذا التمييز بين الفاعليّة والمفعوليّة يتماشى مع التصوّر العام للجنس، الذي يرى في المرأة "وعاءً" للرجل.
-
ثالثًا: لم يحتفظ اللسان العربيّ الحديث بهذا الفرز الاصطلاحيّ، بل وسّعه تأثّرًا بالتنوّع الواسع في اللهجات، فاللّهجة التونسيّة، مثلًا، تُعدّ من أغزر اللهجات العربيّة في استخدام مفردات البذاءة، والتي تنعَت المرأة بـ"المأبونة"، وهي لفظة ارتبطت أصلًا بالرجل، كما تُطلق عليه نعت "القحبون"، وإنْ في دلالة بعيدة عن العهر (غالبًا بمعنى الدهاء).
ويبدو أنّ بعض اللهجات العربيّة "سئمت" ألفاظ اللسان القديم، لا سيّما مع كثافة استخدامها، فبدأت تولّد ألفاظًا جديدة إمّا بوضع مباشر أو عبر استعارة مجازيّة من مجالات أخرى، من ذلك مثلًا: "شرموطة" في اللهجة المصريّة، أو تعبير "فيه الرائحة" و"يرحم عمّي" في التونسيّة، تلميحاً إلى ابْنَته في اللهجة التونسية.
واللافت أنّ هذا الفرز الجندريّ في ألفاظ الوصم، يقابله فرز مشابه في ألفاظ "الطهريّة" أو التجريد من الوصم، حيث نجد نعوتًا مشتركة وأخرى مخصوصة بكلّ من الجنسَين، كما يتّضح في الجدول المستند إلى أمّهات المعاجم العربيّة القديمة.
|
نعوت مشتركة |
نعوت للمرأة فقط |
نعوت للرجل فقط |
|
امرأة عفيفة ورجل عفيف |
امرأة محصن |
فلان "رجل" |
|
امرأة شريفة ورجل شريف |
امرأة عذراء |
|
|
بنت رِشدة وابن رِشدة |
امرأة مصون |
|
|
امرأة طاهرة ورجل طاهر |
الأصول الأولى لألفاظ الوصم
كلّ لفظ من ألفاظ الوصم تقريبًا له قصّة أصليّة، تربطه بمعنى قد يقترب أو يبتعد عن المعنى التداوليّ الحاليّ. وهذه الظاهرة اللغويّة لا تقتصر على ألفاظ الوصم، بل تمثّل سمة عامّة في اللغة، وتُعرف بـ"الانزياح الدلاليّ"، أي انزياح اللفظ عن معناه الأصليّ إلى معنى أو معانٍ أخرى لأغراض شتّى. وسنمثّل هنا للمعنى الأصليّ بلفظ مشترك، ثمّ بوصم خاصّ بالمرأة وآخر خاصّ بالرجل.
العُهر
يُطلَق العُهر على الرجل فيُقال: عاهر، وعلى المرأة فيُقال: عاهرة. والدلالة الأصليّة للكلمة وفقًا لأمّهات المراجع، تشير إلى خروج المرأة ليلًا طلبًا للجنس. ويرتبط هذا المعنى بسياق الثقافة البدويّة التقليديّة، حيث كان العشّاق يترقّبون حلول الظلام للّقاء خلف كثيب من الرمل أو ما يشبهه. وتكرّر هذا المشهد في الشعر الجاهليّ كثيرًا، كما في قول امرئ القيس حين أخرج حبيبته ليلًا من مخدعها، وانتحى بها موضعًا صلبًا مستترًا وراء الكثبان، فيما أرسلت الحبيبة في طرف ثوبها خيوطًا تمحو بها آثار أقدامهما.
خرجت بها تمشي تجرّ وراءنا *** على أثرينا ذيل مرطٍ مرحَّلِ2
وقد شاع لفظ العهر حتّى "غلب على الزنا مطلقًا3" سواء في الليل أو في النهار.
القحب
القُحْبُ كلمة مولّدة ليست في لسان أهل الجاهلية ولا صدر الإسلام4، ويرى أغلب أصحاب المعاجم على أنّ معناه الأصليّ هو السعال واسمه القُحاب، وهو في الحيوان وأساسًا في الخيل والإبل. ويطلق أهل اليمن على العجوز المسنّة قحبة لكثرة سعالها ولا يقصدون غير ذلك5. وقد ذهب بعض المعجميّين إلى أنّ "البغيّ" تُنعت بـ "القحبة" لأنّها "كانت في الجاهليّة تأذن لطلّابها بقُحابها، فهو رمز لها6". ولعلّ المقصودات بذلك هنّ أصحاب الرايات: نساء يطلبن المتعة فيضعن على خيامهنّ أو أبوابهنّ راية حمراء للدعوة7.
الأبْنَة
أصله الأُبنة وهي الشُبهة، سواء بخير أو بشرّ، لكن إذا لم يقيّد المتكلّم هذه الكلمة بنعت"خير" أو "شرّ" واكتفى بقوله "مأبون" فهي للشرّ، والشرّ هنا محدد فهو "الفاحشة8". والقيد في الوصم هنا هو المطاوعة، فالمأبون هو "الذي يؤتى طائعًا9"، وبذا يخرج من هذا الوصم من اغتُصب وحُمل على الجنس دون رغبة.
لكن هذا اللفظ من الأضداد، أي يحتمل المعنى وضدّه، فالتأبين ويفترض أنّه رمي الرجل بالأبنة، يعني أيضاً الثناء على الرجل أو المرأة، ويستعمل أكثر في ذكر شمائل الميّت.
ولأنّ الذهنيّة العربيّة عمومًا مهوسة بعفّة المرأة أوّلًا والرجل ثانيًا، وباعتبار أنّ الطقس الجنسيّ الكامل عمومًا هو طقس سريّ يُنفّذ وراء الأبواب المغلقة، فإنّ المخيال الشرقيّ وضع إشارات ودلائل ورموز تُيسّر اكتشاف "العهر" في المرأة والرجل دون حاجة إلى معاينة المشهد "الحيّ".
علامات "قحب" المرأة و"أُبنة" الرجل في المخيال العربيّ
العلامات في المرأة
من المفارقات العجيبة أنّ السلوك الجمعيّ العربيّ لا يتحرّج من إطلاق شبهة العهر على المرأة بناءً على علامات ظنيّة، في الوقت الذي يتشدّد فيه الفقه الإسلاميّ بصرامة في شروط إطلاق تهمة الزنا على المرأة، وهي التهمة المعروفة بـ"قذف المحصنة"، والتي تُعدّ إحدى السبع الموبقات التي نهى عنها النبيّ محمّد في بعض الأحاديث10.
وجاءت الشرائط وعقوبة المخالفين في الآية 4 من سورة النور: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾.
وتذكر كتب الأخبار وقائع عديدة لتنفيذ حدّ الجلد بحقّ من رمى محصنة بالزنا دون استيفاء الشروط الشرعيّة؛ فقد جلد عمر بن الخطّاب بعض القاذفين، رغم أنّ بعضهم من الصحابة11. بل إنّ عمر وضع شرطًا لم يُذكر في القرآن، وهو أن يكون الاتّصال الجنسيّ بين الطرفين كاملًا، وشبّهه بوقوع "الميل" وهو القلم في "المكحلة"، أي أنّ مجرّد العناق أو الملامسة لا يكفي لتثبيت الزنا.
ولم يتقيّد المخيال العربيّ بأحكام آية القذف، بل وضع أحكامه الخاصّة لتثبيت تهمة العهر، دون اشتراط رؤية "الِميل" في مرمى "المكحلة". حتّى إنّ عائشة زوجة النبيّ نفسه لم تسلم من القذف قبل الآية وبعدها - في ما يُعرف بواقعة الإفك - رغم غياب الشهود.
ويمكن ردّ مختلف العلامات التي يُستند إليها في إطلاق هذه التهمة إلى نوعين أساسيّين: علامات في الجسد ذاته، وعلامات في السلوك الصادر عن هذا الجسد.
أ. علامات في الجسد نفسه
أفادتنا هدى نعمان12، أنّ بعض الأعضاء البارزة في جسد المرأة في هيئة معيّنة وفي سنّ محدّدة، قد تُؤوَّل ضمن المخيال الشعبيّ كدليل على إقامة علاقة جنسيّة قبل الزواج. فالصدر الكبير المتهدّل مثلًا، قد يُفهم على أنّه نتيجة "طول مداعبة" من رجل أو أكثر. وحتى حين تمتلك الفتاة في سنّ المراهقة صدرٌ بارز، تُعدّ هذه سمة على "تنبّه جنسيّ مبكّر"، أو تجربةٍ سابقة لشيء من المتعة الجنسيّة أيًّا كان نوعها.
كذلك تُفسَّر الأرداف الكبيرة، في تصوّرات العقل الشرقيّ، على أنّها نتيجة لاتّصال جسديّ سابق. وغالبًا ما تُقال هذه الملاحظة للنساء بعد الزواج باعتبارها أمرًا طبيعيًّا، وهو التفسير نفسه الذي يُستخدم في وصم الفتاة قبل الزواج.
وقد تُؤوَّل طريقة المشي أيضًا كمؤشّر على ماضٍ جنسيّ خفيّ، فالراجح في التصوّر العامّ أنّ مشية المرأة التي فيها "فحجة" - أي تباعد بين الفخذين - تُعدّ دالّة على تجربة جنسيّة "عنيفة" تسبّبت لها بذلك. وهذا النمط من المشي يُفهم على أنّه "اضطراريّ" لا اختيار فيه للمرأة.
ب. علامات في السلوك الصادر عن الجسد
تُعدّ هذه العلامات أشدّ إقناعًا من العلامات الأولى لدى من يُصدّقون بها، ذلك أنّ علامات الجسد في ذاته، ككبر الصدر أو الأرداف تظلّ غير قطعيّة، نظرًا لكون كثير من النساء المقطوع بـ"عفّتهنّ" من ذوات الصدور والأرداف.
وأبرز هذه العلامات الصادرة عن الجسد هو الصوت بمختلف تمظهرات، فالضحك مثلًا بصوت عالٍ، يُعدّ في المخيال الجمعيّ دليلًا صريحًا على "القحب"، والمفارقة أن غناء المرأة يُعدّ أخفّ وطأة من الضحك المفرط. وقد رُميت الفنّانة أمينة فاخت، في إحدى حفلاتها بمسرح قرطاج بالعهر، بسبب ضحكتها "المتقعّرة" أثناء تفاعلها مع الجمهور.
وفي الفيلم التونسيّ عصفور السطح، أوقفت الممثّلة هيلين كاتزارس في دور لطيفة، جمعًا من الرجال بضحكتها، وعوملت في سياق الفيلم على أنّها "فاسدة".
أما مضغ "العلكة" بطريقة معينة، فقد يُفهم في بعض السياقات بوصفه علامة على "فساد" الماضغة، وتظهر "متلازمة العلكة والعهر" كثيرًا في الأفلام والمسلسلات العربيّة، كما في مشهد الممثلة رانيا يوسف في دور بائعة الهوى في الفيلم التونسيّ الهربة.
وتُعدّ المشية التي تتعمّد فيها المرأة هزّ أردافها دعوة صريحة - في المخيال العام - إلى الجنس، بغضّ النظر عمّا إذا كانت "ذات سوابق" أم لا.
علامات أخرى ترتبط بمجال العناية بالجسد، حيث يعتقد في كثير من الأعراف المحليّة العربيّة أنّ إهمال الزينة إلى حدّ ما، يُعدّ من علامات العفّة لدى المرأة قبل الزواج، فهي لا تحلق من جسمها سوى إبطيها، ولا يُطلب منها صبغ شعرها، أو تنميص حواجبها، أو إزالة شعر يديها وساقيها. وعمومًا تُصنَّف كلّ مظاهر "المبالغة" في الزينة كمؤشّرات على العهر.
وفي الاعتقاد العام، قد تنجح المرأة في إخفاء ماضيها الفاسد، لذا تبقى ليلة الدخلة الاختبار الأخير للعفّة. ولن ننجرّ هنا إلى الحديث عن تفاصيل عذريّة البكارة13، بل نشير إلى أنّ البكارة ليست الشهادة القاطعة على العفّة، إذ قد تكون المرأة قد "جرّبت" اللذّة بطرائق أخرى، أو ببساطة قد رتقت بكارتها. ولهذا يعوّل بعض الرجال المهووسين بعذرية المرأة على علامات أخرى، مثل الانفعال أثناء الممارسة. ومن الأمثال المتداولة في هذا السياق: "إذا تحرّكت اطّلقت"، أي إنّ أيّة علامة على الانتشاء تُعدّ دليلًا على تجربة سابقة.
ومع التحوّلات الكبرى في عالم الأزياء والموضة والصورة، انسحبت كثير من مظاهر العناية بالجسد من لائحة الوصم في معظم المدن، وباتت محصورة في بعض المناطق الريفيّة أو البدوية، أو داخل بعض العائلات المحافظة في المدن.
علامات الأُبنة في الرجل
إنّ رمي الرجل بالأبنة نادر في المجتمعات العربيّة مقارنةً برمي المرأة بالعهر. وغالبًا ما يُوصم الرجل بنعوت قريبة تبدو في ظاهرها إخراجًا له من شروط "الرجولة"، لكنها في جوهرها نعوت "معنويّة" لا جسديّة مثل وصفه بـ"الديوث" إن لم يغَر على ابنته أو زوجته أو أخته. وقد يُرمى بالأبنة أحيانًا على سبيل المبالغة في السبّ، لا توصيفًا لحالة واقعيّة.
ثمّة فارق أيضًا في أنّ تجريد الرجل من صفته الذكوريّة لا يعني بالضرورة أنّه "مأبون"، ففي رواية "شرق المتوسّط" لعبد الرحمن منيف، يعترف "رجب" بطل الرواية لامرأة أرادته للجنس بالقول: "أنا لستُ رجلا14" لأنّ الجلّادين أخصوه في السجن.
أمّا إذا قُصدتِ صفة "المأبون" في ذاتها فهنا يرتكز المخيال الجمعيّ على نوعين من نماذج "الأبنة": النموذج الصريح والنموذج الخفيّ.
أ. النموذج الصريح للأبنة
يمكن أن نردّ جميع العلامات "الصريحة" لتوصيف الرجل بأنّه مأبون إلى أصل واحد، بحسب ما تذكره مراجعنا وهو: التشبّه بالمرأة.
والتشبّه يكون في الأقوال والأحوال والأفعال. فأمّا في القول ففي كلّ تلفّظ تنطوي عليه "رخامة15"، ولهذا وُصِمت شخصيّة "سنبل آغا" في مسلسل حريم السلطان بالأبنة لما في صوتها من رقّة.
وفي الأحوال ثمّة محدّدات كثيرة، أبرزها المشية وحركة الجسد عمومًا. وتصف المعاجم العربيّة ذلك بـ"التكسّر في الأعضاء16"، وأي كلّ تثنٍّ أو ليونة في الحركة. وقد وصف أبو نواس فتىً طاوع رجلًا طلبه بالتثنّي، فقال:
فلما انتحى فيه تحرّف وانثنى *** وأطرق عند النيكِ أحسن إطراقِ17
ومن الأحوال أيضًا أن يضع الرجل ما اتُّفق عليه في العرف أنّه من زينة النساء. ونقول "ما اتُّفق" لأنّ محدّدات الزينة لم تخضع تاريخيًّا، لضوابط صارمة أو تمييز صريح بين ما هو للرجل وما هو للمرأة في هذه الثقافة.
فالرجل في الجاهليّة مثلًا كان يُخضّب شعره وأصابعه بالحنّاء، ويكتحل ويُطيل شعره. بل إنّ بعض هذه المظاهر تُعدّ من السنّة النبويّة، إذ تجمع الروايات على أنّ النبيّ كان يكتحل بالإثمد18.
ورغم هذا الأساس الدينيّ، فإنّ هذه الممارسات ستنحصر في عصور لاحقة بالنساء، ويظهر ذلك صريحًا في بيتٍ لجرير يهجو فيه الفرزدق، ويضيف إليه محدّدًا نسويًّا آخر هو التعطّر:
خذوا كحلا ومجمرة وعطرا *** فلستم يا فرزدق بالرجال19
وكذلك يُعدّ من علامات التشبّه في التصوّر الشعبي، وضع القراريط في الأذن أو الأنف، وارتداء ألوان مخصوصة لا سيّما اللون الورديّ.
ويبدو المجتمع العربيّ الحديث منفصمًا في مسألة المظهر العام تحديدًا؛ فلبس القراريط، مثلًا بات رائجًا حتّى بين مغنّي الراب العرب المعروفين باستعراضهم لـ "فحولتهم"، ومع ذلك يظلّ النموذج التقليديّ صلبًا ومتشدّدًا، خصوصًا في المؤسّسات الرسميّة، كالمؤسّسات التربويّة، حيث يُسمح للبنات بوضع القراريط، ويُمنع الفتيان من ذلك منعًا باتًّا.
لكن ماذا عن الرجال الذين لا يحملون أي علامة من هذه العلامات، ومع ذلك يُوصمون بالأبنة؟ لهذا تدبير آخر.
ب. النموذج الخفيّ للأبنة
عادةً ما يكون رمي رجلٍ بأنّه مأبون، مع انعدام "العلامات الظاهرة" صادمًا في أوّله، إذ لا يستند إلى دليل محسوس، بل إلى "سرديّات" تُنقل عن "ثقات"، وتكتسب مع مرور الوقت قوّة التصديق. فإذا "تواترت" الروايات والقصص زالت الصدمة الأولى، وثُبّتت التهمة في المخيال العام.
وقد رُمي عمر بن الخطّاب بذلك في رواية وردت في بعض الأصول المهجورة والحواشي، تفيد بأنّ في "دبره داء لا يُشفى إلا بماء الرجال"، هذا رغم ارتباط عمر في الذهنية الإسلاميّة بصورة "الفتى الكامل".
والذي ننتهي إليه، أنّه رغم الجامع المشترك بين "القحبة" و"المأبون" في نزع العفّة عنهما، فإنّ التحيّز يظلّ حاضرًا حتّى في مربّع الوصم ذاته. فعند الزواج مثلًا،لا يُقدَّم اعتبار العفّة في الرجل كما يُقدَّم في المرأة؛ إذ تُعرض المرأة أوّلًا باعتبارها "مصونة"، أمّا الرجل فيُقدَّم أساسًا باعتبارات أخرى كالمال والمنزلة الاجتماعيّة، ولا يُشار إلى كونه "رجلًا" بالمعنى النموذجي المشحون بالفحولة.
فالمهمّ في المرأة هو "ماضيها"، بينما المهمّ في الرجل هو حاضره ومستقبله.
- 1
الموادّ المعجميّة مستقاة من أمّهات المعاجم ويمكن طلبها في جذورها هناك، انظر خاصّة: لسان العرب لابن منظور، الصحاح للجوهري، المحكم والمخصّص لابن سيده، تاج العروس للزبيدي، القاموس المحيط للفيروزآباذي.
- 2
الزوزني حسين بن أحمد بن حسين، "شرح المعلّقات السبع"، ط1، دار إحياء التراث العربيّ، 2002، معلّقة امرئ القيس.
- 3
لسان العرب، مادّة (ع ه ر).
- 4
ابن سيده، المخصّص، مادّة (ق ح ب).
- 5
الأزهري، تهذيب اللغة، مادّة (ق ح ب).
- 6
الأزهري، تهذيب اللغة، مادّة (ق ح ب)، ابن سيده، المخصّص، مادّة (ق ح ب).
- 7
الفاكهي أبو عبد الله محمّد بن إسحاق بن العبّاس، "أخبارمكّة"، تحقيق عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، دار خضر، بيروت، ط2، 1994، ج5، ص200.
- 8
الجوهري، الصحاح، مادّة (أ ب ن).
- 9
لسان العرب، مادّة (ج ب س).
- 10
صحيح البخاري (2766)، ومسلم (89).
- 11
ابن كثير، "البداية والنهاية"، دار الفكر، بيروت، ج 7، 1939، ص 81-82.
- 12
باحثة وعارفة بطبيعة التوصيفات الجندريّة في الثقافة المحلّية التونسيّة.
- 13
انظر هنا مقالنا في جيم: سحر ووهم ودم: الخرافات عن الجنس في الثقافة العربيّة الحديثة
- 14
عبد الرحمن منيف، "شرق المتوسّط"، ط 19، دار التنوير، 2016.
- 15
تاج العروس، مادّة ( خ ن ث).
- 16
تاج العروس، مادّة (خ ن ث).
- 17
أبو نواس، الديوان.
- 18
انظر الفتاوى في الكحل ومراجعها في:
- 19
جرير، الديوان.
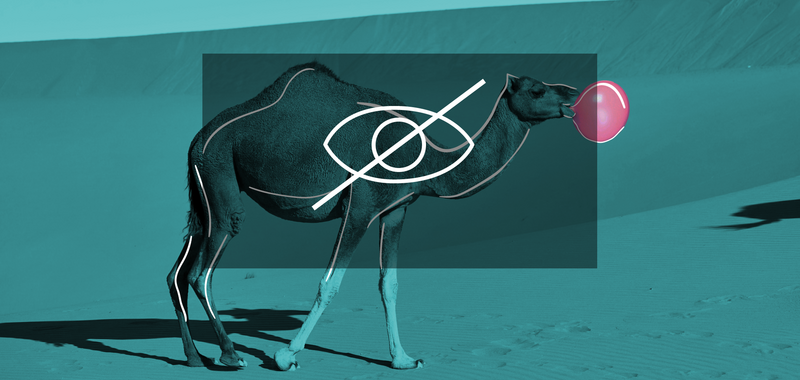
إضافة تعليق جديد