لم تكن رحلة خروج الشابة العراقية آية الموسوي من منزل والدها المعنِّف بمساعدة الشرطة المجتمعية مأساويةً فحسب، بل كشفَت أيضًا تواطؤ الشرطة مع السلطة ضدّ النساء المعنّفات، لاسيّما بعد إطلاق سراح والدها من السجن بعد ليلةٍ واحدةٍ من توقيفه. شكّلَت هذه الحادثةُ رسالةً صريحةً للنساء بأنّهنّ لن ينعَمن بالأمان حتّى لو خرَجن من دائرة العنف الأسري المُمارس بحقّهن، إذ تعمل الشرطة المجتمعية على إعادة الهاربات منهنّ، سواء استعنّ أم لم يستعنّ بها، إلى منازل معنّفيهنّ بعد توقيع الجناة تعهّداتٍ بـ "عدم التعرّض" للضحية.
لكنّ تعهّدات عدم التعرّض لم تضمن يومًا عدم تجدّد العنف بحقّ الضحايا، وصولًا إلى قتلهن. وغالبًا ما تتعامل الدولة مع الجرائم المُرتكبة بحقّ النساء بوصفها "جرائم شرف" مُبرّرة، ما يساعد الجناة على الهروب من العدالة.
لهذا السيناريو نماذج عدّة في الواقع، كان من بينها جريمة قتل المدوِّنة العراقية طيبة العلي، التي خنقها والدُها حتّى الموت ثمّ خرج من السجن بعد 6 أشهرٍ فقط، إذ اعتبر القضاءُ الجريمةَ «جريمة شرف» ولم يصنّفها «جريمة قتلٍ مع سابق الإصرار»، على الرغم من وجود أدلةٍ دامغةٍ تُثبت تورّط عائلتها وتستّرها على تحرّش شقيقها بها جنسيًا، السبب الذي أدى لهروبها من العراق ونشأة الخلاف بين الضحية وأسرتها .
تشير إحصاءات وزارة الداخلية العراقية إلى تسجيل 90 حالة عنفٍ بحقّ النساء يوميًا في بغداد وحدها. كما تبيِّن إحصائية لمجلس القضاء الأعلى في العراق وجود نحو 16,861 دعوى عنف أسري مسجّلة في عام 2019. تعبّر هذه الأرقام المرتفعة عن هيمنة النظام الأبوي على حياة النساء، مع الإشارة إلى أنّها لا تشمل سوى الحالات المبلّغ عنها لدى المحاكم ومخافر الشرطة، أي أنّها تستثني الكثير من النساء اللواتي يرفضن الادّعاء قضائيًا على معنفيهنّ أو الإبلاغ عنهم لأسبابٍ مختلفة، منها الترهيب وإمكانية تعرّضهنّ لعنفٍ أشدّ، وانعدام ثقة الكثير منهنّ بالقضاء؛ عدا عن اعتماد أسلوب الصّلح والتراضي المُمأسَس من خلال شعبة «الصّلح والتراضي بين الزوجَين» في وزارة الداخلية بدلًا من فَرض المساءلة ومعاقبة المعنِّف. ويعود ذلك إلى أنّ الدولة تعتبر العنف المنزلي ضد النساء مسألةً لا تخصّ الشرطة أو السلطات، بل جانبًا طبيعيًا من الحياة المنزلية وجزءًا مركزيًا من العلاقات بين النساء والرجال، مع لحظ الامتياز الذكوري في القانون العراقي الذي يضفي الشرعية الدينية والقانونية لتأديب الرجل زوجته/أفراد أسرته. والجدير بالذكر أنّ طيبة العلي أُرغمَت على السّير بذلك "الحلّ"، أي الصّلح والتراضي، في الليلة التي قُتلت فيها.
تحوّلَت قضيّتا الموسوي والعلي إلى قضيّتَي رأي عام تناولَتهما مواقع التواصل الاجتماعي، على العكس من عشرات آلاف النساء الأخريات اللواتي تبقى معاناتهنّ غير معروفة. مع ذلك، يبدو واضحًا أن المشكلة لا تكمن في الإبلاغ عن القضايا أو عدمه، بل في بنية الدولة التي تخدم نظامًا أبويًا وتعمل مؤسّساتها - بما فيها جهاز الشرطة المجتمعية - على تجذير العنف الممارس بحقّ النساء لإدامة ذلك النظام بدلًا من حمايتهنّ، وتعمد في كثيرٍ من الأحيان إلى معاقبتهنّ، كما حصل مع آية الموسوي التي خرج والدها المتهم بمحاولة قتلها من السجن بكفالة، لتُزجّ فيه آية بتهمة «الاتجار بالبشر». واليوم، تقبع آية في سجنٍ سيّء السمعة في البصرة، محلوقة الشّعر، وتعاني وضعًا نفسيًا مزريًا. وكان آخر ما نشرَته آية على حسابها على إنستغرام طلبًا للنجدة، تعابيره غير مفهومةٍ بالكامل، انتابَتها في خلاله نوباتٌ من البكاء الشديد.
بحسب الكاتب والمؤرّخ البريطاني بيري أندرسن (Perry Andersen)1، تمارِس الدولةُ ما يُطلق عليه «القوّة الصامتة» في احتكارها القانوني للعنف عبر مؤسّساتها العسكرية والأمنية المولجة فرض القوانين، كما من خلال التوافق بين شكل الدولة ومؤسّساتها والنظام الأبوي بغرض تعميم سلطتها وأفكارها وتحويلها إلى حسٍّ مشتركٍ يسود بين أفراد المجتمع. ولتحقيق ذلك وإدامته، تتم الاستعانة بالبُنى المجتمعية نفسها، ويجري اختيار نساء «محافظات ولا يتزيّنن ومتديّنات» للمشاركة في تطبيق هذه النُظم وتجذيرها نهجًا. ويعود ذلك إلى أنّ المؤسسة العسكرية/الأمنية صُمّمَت وفق النموذج الذكوري للسلطة الذي يرسمه ويحدّده الرجال، بحيث تُشجّع السلوكيات والممارسات التي تتناسب مع ذات الإطار التصوّري عن القوة والعفّة (بغضّ النظر عن خيارات النساء الشخصية).
وتعكس هذه التصوّرات رؤى المفكِّر الماركسي أنطونيو غرامشي (Antonio Gramsci)، عن «الدولة المندمجة» أو «الخنادق الأمامية للسلطة» التي لا تمارس نشاطًا سياسيًا فحسب، بل اقتصاديًا واجتماعيًا وأخلاقيًا أيضًا.
لا تكتفي الدولة بممارسة هذه الأنشطة العملية والنظرية في ملاحقة النساء، بل تفرض سيطرتها من خلالها وتسعى للحفاظ على قيمها، كما تعمل على كسب موافقةٍ شرعيةٍ من المجتمع على تلك الأفكار. هكذا تتشكّل
أستذكر حادثةً وقعَت في 7 آب/أغسطس 2023، عندما كانت سلمى (اسم مستعار لشابة عراقية) متّجهةً إلى أحد المقاهي في منطقة الكرّادة وسط بغداد، وأوقفَها 6 عناصر من الشرطة المجتمعية، وتحرّش بها الضابط المسؤول. يومها تجاهلَت سلمى تحرّشات الضابط، ومضَت في سبيلها. لكنّ نقيبةً كانت موجودةً بين عناصر الشرطة أوقفَتها وسأَلتها عن لباسها الذي وصفَته بـ "غير المحتشم"، على الرغم من أنّ ثوب سلمى لم يكن يُظهِر سوى يدَيها. ردّت سلمى بأنّها غير مسلمةٍ لكي تتحدّث معها عن الاحتشام، فما كان من النقيبة إلا أن لكزَتها وأمرَتها بتغطية جسمها. انصرفَت سلمى، لكنّ عناصر الشرطة المجتمعية تبِعوها إلى المقهى حيث ألقوا خطابًا عن العادات والتقاليد، قائلين إنّ ما يفعله بعض النساء ليس حرّية، وإنهنّ في بلدٍ إسلاميّ، وإنّ مظهرهنّ ولباسهنّ يشوّه صورة المجتمع.
عندها، تدخّلَت الناشطة النسوية حفصة عامر، التي كانت سلمى ذاهبةً للقائها في المقهى، وقالت: «هذا الخطاب يجب توجيهه إلى المتحرّش نفسه، فطريقة اللّباس هي حرّية شخصية». ردّت النقيبة عليها بلهجةٍ فيها الكثير من الازدراء، قائلة «المتحرّش من حقّه أن يتحرّش إذا لم يكن لباس المرأة محتشمًا». استُفزّت عامر وأجابَتها بالقول: «هذا تبريرٌ صارخٌ للمتحرّش، وينمّ عن انعدامٍ في المهنية، خصوصًا أنك تُلقين باللوم على الضحية لكونها تعرّضَت للتحرّش، فيما أساس مهنتك يقوم على حمايتها منه». وفي حين أصرَّت النقيبة على موقفها واستمرّت في إلقاء العظات، اقتربَت من سلمى مجدّدًا ونعتَتها بأنّها «عارية». عندها تدخّل أصحابُ المقهى لإسكات سلمى وإنهاء المشادة الكلامية.
تبيِّن هذه الحادثة، وهي واحدةٌ من بين عشرات الحوادث التي تحصل يوميًا في المجتمع العراقي، أنّ عملية تنشئة الفرد الاجتماعية لا تقتصر على تربيته/ا وإلزامه/ا باتباع عاداتٍ وتقاليد محدّدة، بل تتضمّن أيضًا تكوين مقدرته/ا الداخلية وفهمه/ا لنفسه/ا والآخرين/ات. وتشكّل التبعية هنا نُظُمًا وقيمًا اجتماعية كاملة.
وترتكز التبعيةُ على الخضوع والطاعة، وهي تنشأ وتتشكّل وفق نوع الأخلاقيات التي تفضّلها السلطة، بما فيها السلطة الأبوية، فتُنتجُ أفرادًا تبعيّين/ات يلبّون حاجةً أساسيةً للمجتمع الأبوي، حيث يكون ولاء الفرد للعائلة أو القبيلة أو الدين أو المذهب أو الطائفة، وتكون فكرة المجتمع مجرّدةً من المعنى إلّا من حيث ارتباطها بنموذج القرابة والقبول بسيادة السلطة والتعامل بها ووفق شروطها وقواعدها.
وتصبّ هيمنة المؤسّسات العسكرية والأمنية على المجتمع في السياق نفسه، وتهدف إلى توليفه وصوغه وفق ما ترى أنّها معايير المجتمع «الجيّد»، لاسيّما في ما يتعلّق بحرّيات النساء وحيواتهنّ. ومن بين الأدوات التي تستخدمها هذه المؤسّسات لتأدية وظيفتها هو اختيار نساء محافظات، بمعنى ملتزمات بالنظام الأبوي، للقيام بدورٍ سلطويّ والتأثير مباشرةً على أفراد المجتمع. ولا يمكن لهذا إلا أن يكون شكلًا من أشكال الهيمنة الأبوية على المجتمع، وإفقاد الفرد فعاليته/ا، وتحويله/ا إلى ذاتٍ بلا مواطنة، وتجريده/ا من حقوقه الإنسانية والمدنية.
تعجز بنية الدولة البيروقراطية العسكرية عن الظهور بمظهر نظامٍ اجتماعي-سياسي موحّدٍ بنمطها الاجتماعي-السياسي التقليدي لتمثيل المجتمع؛ فعلى الرغم من امتلاك هذا المجتمع جميع مظاهر الحداثة، لكنه يفتقر إلى الوعي الداخلي بهذه البنية. ويعود ذلك جزئيًا إلى التعصّب الديني العنيف الذي نشأ بعد 20032، حيث تفرض العشائر قوانينها الخاصة المرتبطة بعاداتها، والتي بدورها تُنتج عواقب على النساء اللواتي يتلقّين أشكالًا مختلفةً من المعاملة غير العادلة. ومن المهمّ في هذا السياق ملاحظة الارتباط الوثيق بين نشأة قوى الأصولية الدينية السياسية وخطابات رفض فرض "الثقافة الغربية" وضخّ التبريرات الثقافية والدينية لظلم النساء، بحيث تُفهم حرّيتهن وتمتّعهن بالمساواة على أنها رموزٌ صريحةٌ للثقافة الغربية. وبذلك، تستمر قوى السلطة في تصديق وترسيخ نظامها القمعيّ مبرّرةً أنه "ملائم ثقافيًا" ومروّجةً لأهمّيته في حفظ قيَم المجتمع. وسواء كان مجتمعًا مُحافظًا أم غير ذلك، تبقى الهيمنة البطريركية أهمّ سِماته الاجتماعية، حيث العلاقة بين الحاكم والمحكوم عموديةً قائمةً على الإكراه. وتبقى أكثر الأجهزة فعاليةً لممارسة هذا الدور في مجتمعٍ أبوي مُستحدَثٍ هي القوى العسكرية البيروقراطية. هنا، لا تعود النساء محرومات من حقوقهنّ الطبيعية فحسب، بل يصبحن سجينات هذا النظام وعرضةً للقهر الدائم.


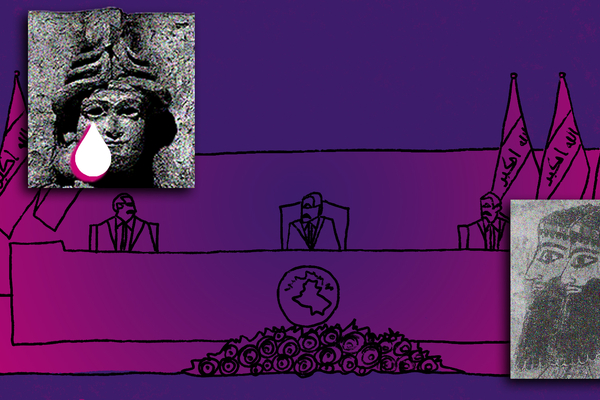
إضافة تعليق جديد