مع انطلاق موجة جديدة من مواجهة العنف الجنسي في مصر في منتصف العام 2020، محورُها تحديدًا كتابة الشهادات الشخصية المجهّلة ونشرها، طرحَت قضية المجهولية جدلًا واسعًا مرتبطًا بمدى إمكانية تصديق المتلقّين تلك الشهادات المُجهّلة والمُحمّلة بالمشاعر والتجارب الشخصية، وهو الجدل الذي يشتبك معه هذا المقال.
في شهر حزيران/يونيو الماضي احتلّت صفحات التواصل الاجتماعي شهاداتٌ عن الاعتداءات الجنسية المتعددة التي ارتكبها طالب الجامعة الأميركية في القاهرة أحمد بسام زكي. نُشرت الشهادات في البداية باللغة الإنجليزية على صفحة assault police على موقع إنستجرام. وما هي إلا أيامٌ قليلةٌ حتى تُرجمت إلى العربية وبدأ جمهورٌ أوسع في تداولها على عددٍ من منصّات التواصل الاجتماعي قبل أن تنتقل إلى وسائل الإعلام التقليدية، لتصبح قضية زكي حديث الساعة في برامج التوك شو والمواقع الإخبارية لأيامٍ متتالية. صاحَب تداول الشهادات ردّ فعلٍ غاضبٍ من سلوكيات الشاب اليافع ابن الطبقة الراقية، في ظل بعض الجدل بشأن ارتباط حوادث الاعتداء تلك بالانتماء الطبقي للمعتدي. وبين الادعاءات المتجاهلة لواقع قضية العنف في مصر من جهة، والتي اعتبرت أن هذا النوع من الاعتداءات يخصّ أبناء الطبقة العليا وحدهم ويرتبط بقيمهم وأسلوب حياتهم الذي لا يشبه عموم "المجتمع المصري"، والتوقعات بأن مكانة أسرة الشاب سوف تحميه من مواجهة تبِعات جرائمه من جهةٍ أخرى، صدر قرار النيابة بالقبض على زكي وفتح تحقيقٍ في القضية. ووُجهت لزكي تهم "الشروع في مواقعة فتاتين بغير رضاهما، وهتكه عرضهما وعرض فتاةٍ أخرى بالقوة والتهديد" وفقًا لما جاء في بيان النيابة العامة المصرية المنشور على صفحتها على فيسبوك بتاريخ 6 تموز/يوليو.
ولّدت قضية زكي وما صاحبها من ردود فعلٍ مجتمعيةٍ ورسميةٍ زخمًا تجاوز الواقعة في حدّ ذاتها، مطلقًا موجةً جديدةً من مواجهة العنف الجنسي في مصر، محورُها تحديدًا كتابة الشهادات الشخصية ونشرها. وعلى الرغم من أنها لم تكن المرة الأولى التي تُنشر فيها شهاداتٌ عن العنف الجنسي على مواقع التواصل الاجتماعي، اختلفَت هذه الموجة عن سابقاتها بانتزاعها مساحاتٍ أرحب للحركة وإنتاجها مجموعةً جديدةً من الاستدلالات والتساؤلات. ولم يقتصر اختلاف هذه الموجة على مدى مركزية الشهادات كمحرّكٍ رئيسٍ للحراك الناشئ، ولا على اختلاف الأطراف الفاعلة التي قادت الحراك أو مضمون الخطاب الذي تبنّته المتفاعلات والمتضامنات مع صاحبات الشهادات، والذي جاء أكثر جذريةً وصداميةً وحاملًا قدرًا كبيرًا من الغضب على الخطابات التقليدية المبرِّرة للعنف الجنسي أو المستهينة بآثاره. في الواقع، تميّزت هذه الموجة أيضًا بطريقة السرد التي اختارتها صاحبات الشهادات والتي تجاوزَت رصد وقائع الاعتداءات لتنتزع مساحاتٍ أكبر لسرد المشاعر والأفكار التي صاحبت وتلت هذه الوقائع. أما الاختلاف الأبرز فكان في اعتماد منصّات النشر استراتيجية النشر المجهّل والدفاع عنها كاستراتيجيةٍ مشروعةٍ ومبررة، لاسيّما في ظل البُنية الحالية لعلاقات القوة التي تحكم جرائم العنف الجنسي في مصر.
طرحَت قضية المجهولية جدلًا واسعًا مرتبطًا بمدى إمكانية تصديق المتلقّين تلك الشهادات المُجهّلة والمُحمّلة بالمشاعر والتجارب الشخصية، وهو الجدل الذي يشتبك معه هذا المقال. لكن بعد التأمل سريعًا في ما حملَته تلك الشهادات من تجارب وما أنتجته من استدلالات، يمكننا فهم سبب اختيار النساء المجهولية ودفاع النسويات عنها.
عبر الحدود الطبقية والجغرافية والثقافية: كلنا ناجيات/ضحايا1
في الأسابيع التي تلت انفجار قضية زكي، ظهر عددٌ كبيرٌ من المنصّات تضمّن مدوناتٍ وصفحاتٍ على فيسبوك وحساباتٍ على تويتر وإنستجرام نشرت عشرات الشهادات المُجهّلة لنساءٍ مصرياتٍ يروين قصصهنّ ليس فقط عن الاعتداءات التي مررن بها، بل أيضًا ما صاحبها وتلاها من ردود فعلٍ ومشاعرٍ وأفكارٍ اختبرنها. وعكست الشهادات تنوعًا كبيرًا في الخلفيات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والجغرافية لصاحباتها، كما في خلفيات المعتدين. وبقدر اختلاف قصص الناجيات/الضحايا بعضها عن بعضٍ على مستوى التفاصيل، فقد جمعَت بينها عناصر مشتركةٌ تجعل القارئ/ة تدرك فورًا - إن لم تكن تدرك فعلًا - مدى تأصّل ظاهرة العنف الجنسي في المجتمع المصري ورسوخ جذورها الاجتماعية وعبورها الحدود الطبقية والثقافية والجغرافية، وارتباطها بموازين قوى اجتماعية وسياسية لا تجعل جميع النساء المصريات عرضةً للعنف الجنسي باستمرارٍ فحسب، بل تجعل مقاومتهن لهذا العنف أو التصدي له فرديًا أو جماعيًا معركةً بالغة الصعوبة وباهظة الثمن.
في ظل هذا الواقع، شكّل نشر الشهادات وتداولها لحظةً شديدة الاستثنائية جمعت صاحبات الشهادات - اللواتي لم تكن أيّ منهنّ على معرفةٍ بالأخريات - في حراكٍ واحدٍ مع المتضامنات معهنّ. وعبر هذا الحراك، أرسلت النساء رسائل هامةً لبعضهنّ البعض كما لجمهور المتابعين والمتابعات الأوسع، تضمّنت بجانب تبادل الدعم في ما بينهنّ، شرحًا لدوافعهنّ في مشاركة شهاداتهنّ واختيارهنّ النشر المُجهّل.
تذكّرنا صاحبات الشهادات أيضًا أننا بالرغم من اختلافنا كنساء، فإن تلك المرارات المشتركة المرتبطة بتجاربنا مع العنف تجمع بيننا
تصِف بعض النساء في شهاداتهنّ كيف قرّرن البوح للمرة الأولى بعد أن قرأن شهادات نساءٍ أخرياتٍ وأدركن أن ما مررن به من أفكارٍ ومشاعرَ كالارتباك، والألم، والغضب، والإحساس بالذنب ولوم الذات لا يقتصر عليهنّ فقط، بل هو نمطٌ متكررٌ تختبره من يقع عليهنّ العنف الجنسي، لاسيّما في السياقات التي اعتادت لوم الضحايا/الناجيات وحماية المعتدين وتبرير جرائمهم. أما البعض الآخر من النساء، فيُشرن إلى قرار نشر شهاداتهنّ دعمًا لصاحبة شهادةٍ أخرى، متوجّهاتٍ إليها برسالة تصديقٍ ضمنية، أو مؤكّداتٍ للجمهور الأوسع صدقها لكَون المتهم معتديًا متسلسلًا ارتكب جرائم في حقّ غيرها من النساء أيضًا.
بالإضافة إلى ذلك، تشرح صاحبات الشهادات قرارهنّ التزام الصمت أو اضطرارهنّ إليه، ما يساعدنا على فهم وتفهّم قرار الآلاف غيرهنّ عدم نشر قصصهنّ علنًا. كما تتحدث بعضهنّ عن قرار نشر شهاداتهنّ في محاولةٍ للتعافي عبر التخلص من حملٍ يثقل كاهلهنّ منذ وقوع الاعتداء عليهنّ. وتذكّرنا صاحبات الشهادات أيضًا أننا بالرغم من اختلافنا كنساء، فإن تلك المرارات المشتركة المرتبطة بتجاربنا مع العنف تجمع بيننا، وكذلك مصيرنا المشترك في بلدٍ يجعل العنف الجنسي ضد نسائه ممارسةً يوميةً شبه مطبّعة. تخبّرنا تلك الشهادات أن طريقتنا الوحيدة للنجاة كنساءٍ هي بإعادة امتلاك روايتنا الشخصية والتضامن مع غيرنا من النساء عبر تصديق رواياتهنّ ودعمهنّ.
بين المصداقية والمجهولية: نصدّق الناجيات والضحايا
اختارت غالبية النساء اللواتي شاركن في تلك الموجة نشر شهاداتهنّ بمجهولية، كما نُشر معظمها على منصاتٍ مجهّلةٍ أيضًا أُنشئت خصيصًا لدعم عملية نشر الشهادات، كمدوّنة دفتر حكايات وصفحة "اتكلم/ي" على الفيسبوك، وصفحة assault police على الإنستجرام. وأثارت قضية النشر المُجهّل عاصفةً من النقد والجدال بشأن مصداقية الشهادات غير معلومة المصدر، إذ تساءل المشكّكون - وغالبيتهم من الرجال - عن إمكانية تصديق "ادعاءاتٍ" تفتقر إلى دليلٍ ملموس، لاسيّما في ظل عدم معرفة القرّاء هوية كاتبات الشهادات والقائمات على منصّات النشر. الكثير من هؤلاء الرجال عبّروا عن تحفّظهم وتخوّفهم من تبِعات تسهيل وتطبيع "تداول الاتهامات"، ما قد يعصف بسمعة رجلٍ مدعًى عليه من دون التحقّق من تلك الاتهامات والتدقيق فيها. وفي حين جاءت تخوفات بعض هؤلاء الرجال من موقعٍ دفاعي لكونهم هم أنفسهم أو أحد أصدقائهم محل اتهامٍ سابقٍ أو حالي، شرح البعض الآخر دوافعه المتمثّلة في حرصه على دعم قضية مناهضة العنف الجنسي والحراك القائم، الذي لا يمكن له أن ينجح برأيهم، ما لم تخُض صاحبات الشهادات أو القائمات على نشرها معركةً مفتوحةً بهوياتهنّ المعلنة وباستخدام الأدوات "المُتعارف عليها" في البحث والتدقيق والتحقّق من المصداقية؛ وهي الأدوات التي وضعها في الأساس رجالٌ متجاهلين خصوصية جرائم العنف الجنسي وطبيعة السياق الاجتماعي والثقافي والسياسي الذي تُرتكب فيه.
باختصار، طرح المشكّكون والمنتقدون سؤالين أساسيّين: لماذا اختارت صاحبات الشهادات نشرها مُجهّلة؟ ولماذا اختارت منصّات النشر الحفاظ على سرية هويات القائمات عليها؟
تدرك الناجيات وضحايا العنف الجنسي إدراكًا تامًا الأثمان الباهظة المترتبة على الإفصاح عن هوياتهنّ، وهي أثمانٌ لا تنحصر فقط في ما اعتدنا سماعه من وصمٍ للناجيات والضحايا، بل تتعدى ذلك إلى خسائر على المستوى المهني والاقتصادي؛ كفقدان النساء وظائفهنّ ومصادر دخلهنّ أو تعرّضهن لمزيدٍ من المضايقة والتهديد في مكان العمل، وقد رأينا أمثلةً كثيرةً على ذلك في الأعوام القليلة الماضية من بينها قضية الصحافية المصرية مي الشامي. أما على المستوى الاجتماعي والأسري، فتتعرّض النساء اللواتي يقرّرن البوح إلى اللوم أو النبذ من قبل سياقهم الاجتماعي، أو يواجهن التضييق على حرّياتهن أو حتى العقاب على يد أسرهنّ. من جهةٍ أخرى، على المستوى الفردي، تُحصر النساء في دور الناجيات أو الضحايا وتُختزل هوياتهنّ وحيواتهنّ الثرية والمعقدة في قصة الاعتداء التي يحاولن تجاوزها. أخيرًا، تتضمّن العواقب المحتملة أيضًا الملاحقة القضائية في ما يُسمى بقضايا السب والقذف والتشهير في حال عدم قدرة الناجية/الضحية على إثبات صحّة روايتها، كما حدث في قضية الصحافي الذي لا يمكننا ذكر اسمه لأنه هدّد بمقاضاة من يفعل ذلك.
تتعرّض النساء اللواتي يقرّرن البوح إلى اللوم أو النبذ من قبل سياقهم الاجتماعي، أو يواجهن التضييق على حرّياتهن أو حتى العقاب على يد أسرهنّ
أما بالنسبة إلى القائمات على منصّات نشر الشهادات، فلعلّ قرارهنّ يرتبط أيضًا بالأثمان المحتملة لانكشاف هوياتهنّ، والتي تتراوح بين تشويه السمعة والتشكيك في دوافعهنّ من قبَل دوائر المتلقين، وجرّهن إلى النزاعات الشخصية، وصولًا إلى الانتقام المباشر منهنّ عبر إقامة الدعاوى القضائية ضدهنّ. ومؤخرًا، رأينا أيضًا احتمال الركون إلى الملاحقة القضائية للناجيات/الضحايا والشهود والداعمات والداعِمين لهنّ والقائمات والقائمين على حملات النشر الإلكترونية، وذلك على يد الدولة نفسها تحت مسمّيات تشويه سمعة مصر، ونشر أخبارٍ كاذبةٍ وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
بالإضافة إلى ذلك، تدرك الناجيات وضحايا العنف الجنسي والداعمات لهنّ أيضًا تمام الإدراك أن الطرق التي تتبناها الدولة والمجتمع في تعريف وتوصيف جرائم العنف الجنسي سواء على المستوى القانوني أو المجتمعي، وسبُل وأدوات التحقق من تلك الجرائم هي في جوهرها طرقٌ منحازةٌ تتبنى وجهة نظر الرجل المعتدي وروايته، لا رواية النساء ووجهة نظرهنّ. فعلى سبيل المثال، ما زال حتى اليوم التعريف القانوني للاغتصاب في القانون المصري يقتصر على إيلاج العضو الذكري في المهبل، بينما يُعد كلّ ما دون ذلك "هتكًا للعرض" أو "شروعًا في الاغتصاب" وتترتب عليه عقوباتٌ قانونيةٌ أقل تشددًا.2 بالإضافة إلى ذلك، تبرز الضرورة القانونية إلى إثبات عنصر "الإكراه" للاعتداد بوقوع الجريمة، وهو أمرٌ يصعب إثباته عمليًا في الغالبية العظمى من جرائم الاغتصاب. أما على المستوى المجتمعي، فالناجية/الضحية مطالبةٌ ليس فقط بإقناع المجتمع بوقوع الجريمة، بل بإقناعه أيضًا "بحسن خلقها" والتزامها بكافّة الصور النمطية للمرأة "المحترمة"، وإلا تفقد تعاطف المجتمع فورًا، ويتم تجاهل روايتها وتُواجه بالسؤال الشهير: "إيه اللي ودّاها هناك؟"
إذًا، ما زالت الطرق التي تعتمدها الدولة ويتبناها المجتمع تصرّ على إقصاء النساء وتجاهل حقائق تراكمت على مدى عقودٍ عن طبيعة الجرائم الجنسية وأسباب لجوء النساء إلى الصمت وعدم الإبلاغ. في مواجهة هذا الواقع، كان على النساء خلقَ أدواتٍ جديدةٍ خارج معايير الدولة والمجتمع، وغير خاضعةٍ لرواية الرجال ومنطقهم في التصديق والتكذيب.
مقاومة احتكار الدولة والمجتمع لرواية العنف الجنسي
لم يكن خيار النساء بالنشر المجهّل محاولةً للتخفيف من تبِعات انكشاف هوياتهنّ فحسب، بل لعلّه كان أيضًا محاولةً لمواجهة تلك التصوّرات الرائجة الظالمة للنساء والتمرّد على شروط المصداقية وآليات التحقق التي فرضها الرجال. في الأشهر الماضية، حاولت النساء التحرّر من تلك الحلقة المفرغة التي ثبت مرارًا وتكرارًا عجزها عن تأمين العدالة، كما ثبت عدم رغبة القائمين عليها في إنصاف النساء.
إزاء هذا السياق المنحاز ضدهنّ، تسعى النساء إلى انتزاع مساحةٍ لفرض روايتهنّ الخاصة عن معاناتهن وسبل مقاومتهنّ وفقًا لتصوراتهنّ الخاصة عن المعاناة والمقاومة. وفي هذه الروايات، تحتل مشاعر وأفكار الناجيات/الضحايا محلًّا قد تفوق أهميته الأحداثَ والوقائع التي تهمّ الباحث عن التحقق من المصداقية. فصاحبات الشهادات يذكّرننا بأن أحد الأهداف الرئيسة للنشر هو التعافي وتحقيق النجاة الشخصية عن طريق استعادة الرواية، وفهم مشاعرهنّ وأفكارهنّ في ضوء مشاعر وأفكار الأخريات اللواتي مررن بتجارب مشابهة. وإلى جانب النجاة الشخصية، تسعى النساء إلى تحقيق النجاة الجماعية عن طريق فضح المعتدي ووصمه وكسر سلطته الاجتماعية التي تمكّنه من الاستمرار في إيذاء أخريات.
هل يعني هذا أن كلّ روايةٍ عن التعرض للعنف الجنسي صادقةٌ بالضرورة؟ بالطبع لا، فمبدأ تصديق الناجيات/الضحايا لا يلغي احتمال وجود شهاداتٍ غير صادقة، لكنه يفاضل من جهةٍ بين الأضرار المحتملة لنشر شهادةٍ غير صحيحةٍ (وهو أمرٌ ثبت حتى الآن أنه نادر الحدوث) مع ترك المجال للمُدّعى عليه لإقناع الجمهور العام ببراءته إن كان بريئًا، أو الامتناع عن نشر آلاف الشهادات الصادقة لانعدام إمكانية تقديم الدليل القاطع على صحّتها من جهةٍ أخرى. والطريف في الأمر، وإن لم يكن محض صدفة، هو أن الشهادة المنشورة الوحيدة التي ثبت بالدليل القاطع أنها مُلفّقة، كانت من تدبير رجلٍ متهمٍ بالاعتداء الجنسي هو الصحافي الذي لا يمكننا ذكر اسمه لأنه هدّد بمقاضاة من يفعل ذلك.3 فهو حاول تبرئة نفسه عبر التشكيك في آلية نشر الشهادات المجهّلة، بعد أن نُشر ضده أكثر من عشر شهاداتٍ لم يستطع إثبات عدم صحّة أيّ منها حتى تاريخ كتابة هذه السطور.
في ظلّ موازين القوى الحالية، يجب رفع عبء إثبات الادعاء عن النساء، وإتاحة مساحةٍ حرةٍ وداعمةٍ لهنّ لسرد رواياتهنّ كما يرغبن
إذًا، ينحاز مبدأ تصديق الناجيات/الضحايا إلى روايات النساء حتى يثبت العكس، رافضًا استمرار هيمنة الرجال والمجتمع والدولة على روايات العنف الجنسي. ففي ظلّ موازين القوى الحالية، يجب رفع عبء إثبات الادعاء عن النساء، وإتاحة مساحةٍ حرةٍ وداعمةٍ لهنّ لسرد رواياتهنّ كما يرغبن لأنهن بالفعل الطرف الأقلّ قوةً في المعادلة، إذ يقف في وجه تعافيهنّ من آثار العنف العديدُ من العراقيل القانونية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي تجعل من الصمت الخيار الأكثر شيوعًا. بالتالي، يولي هذا المبدأ الأولوية لكسر الصمت الذي دفعت النساء أثمانه لعقودٍ طويلةٍ وما زلن. أما تحقيق العدالة بمعناها التقليدي، أي السعي إلى معاقبة المعتدي وفقًا لقوانين الدولة، والذي يحتاج للتدقيق والفحص والتحقق، فلَيس من مسؤوليات النساء الناجيات/الضحايا، بل هو مسؤوليةٌ مشتركةٌ تتحملها الدولة مع المجتمع بأطرافهما كافة، إذا ما توفّرت رغبةٌ حقيقيةٌ بالخروج من كابوس العنف الجنسي في مصر.
أين نحن الآن؟ وإلى أين نتجه؟
خفتت موجة نشر الشهادات بعد قضية الفيرمونت، وهي واقعة اغتصاب جماعي تعود أحداثها لسنة 2014، إذ مثّلت هذه القضية ضربةً قاصمةً للحراك الناشئ، أرسلت عبرها الدولة المصرية رسالة تحذيرٍ واضحةٍ للناجيات/الضحايا الراغبات في استخدام تلك الآلية الجديدة، كما إلى المتضامنات معهنّ. فقد قررت النيابة العامة حبس الشاهدة الرئيسة في هذه الواقعة، إلى جانب عددٍ من الشهود الآخرين، ووجّهت إليهن/م تهم "تعاطي المخدرات والتحريض على الفسق والفجور، والتحريض على ممارسة اللواط والسحاقية، وإقامة حفلات جنسٍ جماعي، وإثارة مشكلاتٍ وهميةٍ تخصّ قضية العنف ضد المرأة ونشرها على السوشيال ميديا". وفي الوقت عينه، جرى تسريب صورٍ وفيديوهاتٍ خاصةٍ لشاهدات وشهود القضية، ما أشعل حملةً شرسةً لتشويه سمعتهنّ ووصمهنّ والتحريض ضدهنّ على صفحات الإنترنت وفي وسائل الإعلام. كما حذّرت النيابة العامة في بيانٍ من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر شهاداتٍ عن التحرش الجنسي، مطالبةً الناجيات/الضحايا بتقديم بلاغاتٍ رسميةٍ لدى الجهات المختصة. مثّل ردّ فعل الدولة هذا وما صاحبه من تشجيعٍ مجتمعي محاولةً لاستعادة الهيمنة على الرواية، وكسر موجة الشهادات التي تدرك الدولة على الأرجح أنها جاءت لتواجه الآليات التقليدية في التعامل مع جرائم العنف الجنسي والتي فشلت حتى الآن في إنصاف النساء. بالفعل، انكمشت موجة نشر الشهادات، وتراجعت معها حملة التضامن مع الشهادات القليلة التي نُشرت بعد القبض على شهود الفيرمونت.
ما زال من المبكر الحكم ما إذا كانت الدولة نجحت في القضاء على الموجة، أم أنها دخلَت في فترة كمونٍ مؤقتٍ لاستعادة الأنفاس. لكن من المؤكد أن هذه الموجة فرضَت على أجندة المعنيّات والمعنيّين بقضايا العنف الجنسي في مصر مجموعةً من الأسئلة والقضايا التي تناولنا بعضًا منها في هذا المقال، فيما يبقى الجزء الأكبر بحاجةٍ إلى جهدٍ إضافي في المستقبل للتأمل والتفكّر فيه، والتفاعل معه وتطويره واستقطاب المزيد من المهتمّات والمهتمّين بمعالجته. في الوقت ذاته، نجحت الموجة فعليًا في فرض أدواتٍ جديدةٍ وخطابٍ أكثر جذرية، منتزعةً مساحاتٍ أكثر رحابةً للحركة، ومتحديةً ما سبقها من قواعد كان يظنها البعض راسخةً في التعامل مع قضايا التحرش والاغتصاب.
ما تزال تبِعات هذه الموجة قيد التشكل، ليس فقط في مصر، بل في غيرها من الدول العربية أيضًا. كما ما تزال مكتسباتها وإخفاقاتها بحاجةٍ إلى المراجعة والتقييم. لكن ما يبدو جليًّا هو أن هذه الموجة - كسابقاتها - نبّهتنا إلى أن التغيير، مهما كان ثمنه باهظًا، يحدث بالفعل. كما ذكّرتنا بوجود عددٍ كبيرٍ من النساء اللواتي - على تنوع خلفياتهنّ وأدواتهنّ - يدركن جيدًا أن النجاة حقٌ لن يتحقق إلا باستمرار خوض معارك وتطوير خطابٍ وآلياتٍ وأدواتٍ جديدةٍ للمواجهة. وأخيرًا، ذكّرتنا تلك الموجة أيضًا أنّ السعي إلى النجاة الجماعية وتعزيز التضامن بيننا كنساء - سواء كنّا مستعداتٍ للبوح أم لا - هما السبيل لفرض روايتنا وتحقيق تعافينا.
- 1يختار المقال استخدام تعبير الناجيات/الضحايا بدلًا من اعتماد أحد الوصفَين حصرًا، انطلاقًا من قناعة الكاتبة بأن إطلاق لفظ ناجية أو ضحية يمثّل حكمًا على تجربة المرأة التي وقع عليها العنف وتصنيفًا لها في ضوء تصوّراتٍ خاطئةٍ عن النجاة في مقابل المعاناة. فالمنظور النسوي الحديث لا يؤمن بوجود معايير موضوعية للحكم مَن مِن النساء نجَت ومَن منهنّ ما زالت ضحيةً تعاني تبِعات العنف وآثاره. والأهم من ذلك هو أن هذا المنظور يرفض في الأساس ثنائية النجاة مقابل المعاناة، إذ هناك مروحةٌ من المشاعر نتحرك عبرها كنساءٍ بشكلٍ دائم، فنقترب أحيانًا من الإحساس بالتعافي، لكن قد نعاود الاقتراب مرةً أخرى من الإحساس بكوننا ضحايا. لذلك، لا يحقّ لأحدٍ إطلاق أيٍّ من اللفظين (الناجية والضحية) سوى صاحبة التجربة نفسها بحسب ما تشعر به في اللحظة الراهنة، وهو إحساسٌ قد يتبدّل وفقًا لظروفٍ سياقيةٍ خارجيةٍ أو نفسيةٍ وذهنيةٍ داخلية.
- 2تتراوح عقوبة هتك العرض في القانون المصري بين السجن 3 و7 سنوات إذا ارتُكبت الجريمة ضد فتاةٍ يقلّ عمرها عن 18 عامًا. وإذا كان التوصيف القانوني للجريمة يرتبط بعقوبةٍ مدتها السجن 3 سنوات، يسقط حقّ الناجية/الضحية في الإبلاغ بعد انقضاء المدة ذاتها على وقوع الجريمة.
- 3اتفق الصحافي الذي لا يمكننا ذكر اسمه لأنه هدّد بمقاضاة من يفعل ذلك مع صحافيتين إحداهما مصرية والأخرى سورية للتواصل مع مدونة دفتر حكايات التي كانت تنشر الشهادات، وإرسال "شهادتَين" مفبركتَين ترويان فيهما وقائع اعتدائه المفترض عليهما، ثم تسجيل المكالمة سرًّا مع القائمات على المدونة. بالفعل، نشرَت المدونةُ شهادةَ الصحافية السورية، ثم حذفَتها بعد أن نشر هذا الصحافي فيديو يعترف فيه بفبركة الشهادة من أجل التشكيك في مصداقية المدونة. وقام هذا الصحافي بعد ذلك بحذف الفيديو قبل أن يغلق حساباته على موقع الفيسبوك.
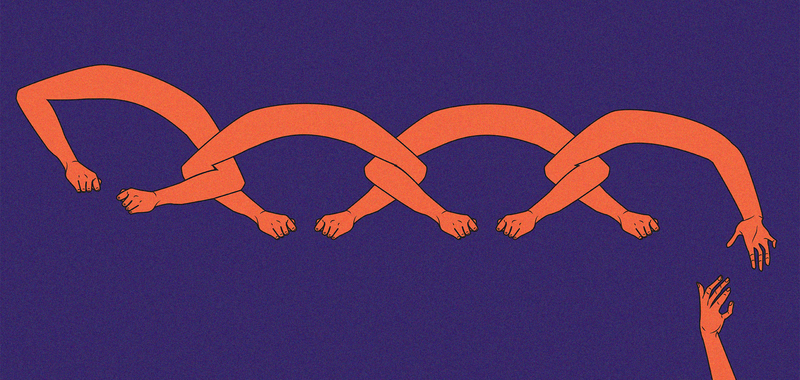
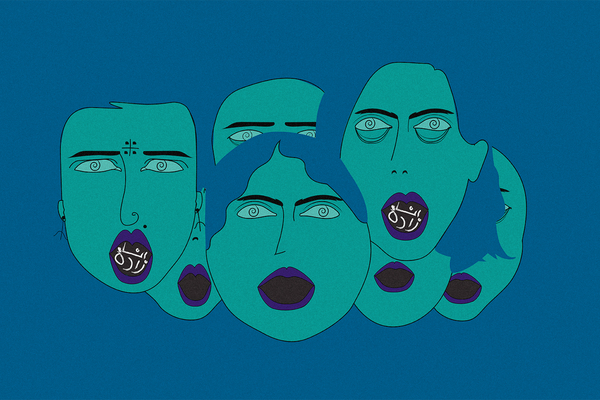

إضافة تعليق جديد