لطالما كنتُ مختلفةً عن باقي فتيات الحارة والعائلة. كنتُ أكره الأعياد والمناسبات، فأنا أحبّ ركوب الدراجة واللعب مع الأولاد، بينما تريدُني أمي أن ألزم المنزل أو ألعب مع الفتيات، وأن أرتدي الفساتين في الأعياد، أنا التي لم أرغب يومًا في ارتدائها. دائمًا ما كان أحدُهم يردّد على مسامعي عبارة "حسَن صبي".1 حاولَت أمي مرارًا أن تقنعني بأن عليّ أن "أكبر" وأغيّر تصرّفاتي، قائلةً: "إنتي بنت، ماما. والبنات ما بيتصرّفوا هيك. مشّطي شعرك، ماما. ولما تقعدي، سكّري رجليكي. هيك، متلي أنا، ماما. عيب تفتحي رجليكي متل الشباب".
اختلافي عن باقي الفتيات لم يختفِ في مدرسة البنات التي قضيتُ فيها أكثر من ستّ سنواتٍ بدءًا من سنّ الثانية عشرة. هناك، نلتُ نصيبي من الإهانات والتنمّر والمضايقات اليومية لكَوني مختلفةً عن زميلاتي. هنّ يفضّلن ارتداء الملابس الضيقة، وتسريح شعورهنّ عند الكوافير ووضع الماسكارا، بينما أفضّل أنا ارتداء الملابس الرياضية، وربط شعري إلى الخلف ووضع اللاشيء على وجهي. هنّ يستمِعن إلى أغنيات وائل كفوري وبرنامج "ciel" الإذاعي، ويناقِشنه كل يومٍ ويتحدّثن لساعاتٍ عن إعجابهنّ بمقدّم البرنامج، بينما أسمع أنا الرّاب والهيب الهوب. هنّ يتكلّمن عن الحبّ والفتيان والعضو الذكري، وأنا أودّ أن أتبخّر من المكان. وإن لم تكن تلك التفاصيل وحدها كافيةً لأدرك مقدار اختلافي عنهنّ، كانت زميلاتي يبتكرن الطرق لتأكيد الأمر، مثل تكرار قولهنّ لي: "إنتي شو عم تعملي هون؟ غلطانة بالمدرسة. مدرسة الصبيان البناية يلّي جنبنا".
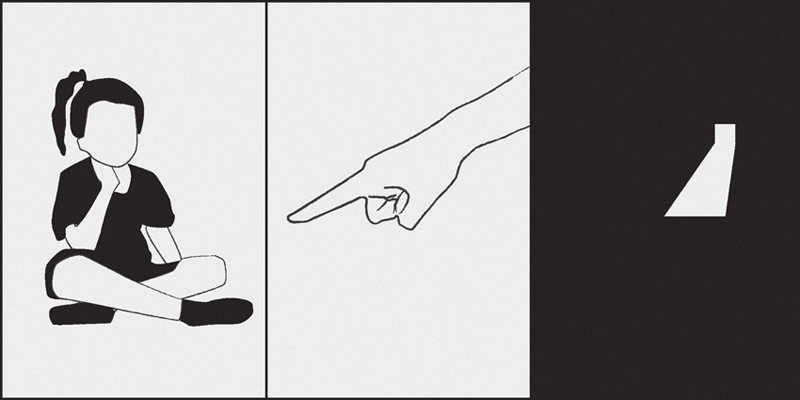
في تلك المرحلة، المكان الوحيد الذي منحني شعورًا بالأمان والسعادة، وحتى بالانتماء، كان نادي كرة السلة في الحيّ على مقربةٍ من بيتنا. كان النادي ملاذًا لفتياتٍ كثيراتٍ مثلي ولأولادٍ فضّل أهلهم تسجيلهم فيه على تركهم يتسكّعون في الشوارع. كنتُ في الثانية عشرة من العمر عندما انضممتُ إلى فريق كرة السلة للفتيات. كان الفارق بين فتيات مدرستي وزميلاتي في الفريق أنهنّ لم يُعِرن اهتمامًا لطريقة كلامي، لباسي، شكلي وحركة جسمي. كنّ الوحيدات اللواتي قبِلنَني كما أنا، وقبلتهنّ أنا كما هنّ. كانت تلك المرة الأولى التي أشعر فيها بأنّي أشبه بعضَ من حولي وبأنّي "طبيعية"، إذ كانت تجمعُنا صفاتٌ واهتماماتٌ كثيرة، بعكس ما كان يفرّقني عن زميلاتي في المدرسة.
هذا المكان الذي قضيتُ فيه سنواتٍ أطول من سنوات المدرسة، وبنيتُ فيه صداقاتٍ عديدةً بعضها ما زال قائمًا، أصبح بيتي الثاني ومهربي من واقع المدرسة الثقيل وفتيات المدرسة بشعورهنّ المسبّلة وبرنامجهنّ الإذاعي. في النادي، كان المدرّب يشجعنا على الركض وممارسة التمارين الصعبة والتحلّي بالشراسة والتنافس، عكس السلوكيات التي يحاول المجتمع فرضها على الفتيات ليكنّ صامتاتٍ وراضخاتٍ للسلطة الأبويّة. هناك، كنتُ أشعر بالتحرّر والاقتراب من شخصيتي الحقيقية التي كنتُ أقمعها خارج النادي عبر محاولتي عدم لفت الأنظار إليّ والتماهي مع محيطي.

في أحد الأعوام، انتقلَت إلى مدرستي اثنتان من زميلاتي في فريق كرة السلة. ومع أننا لم نكن يومًا في الصّف ذاته، غمرني وجودهما في مبنى المدرسة بنوعٍ من الحماية، بل والقوة. كنا نتسكّع معًا دومًا في باحة المدرسة، فلم يعُد بمستطاع الفتيات الأخريات في المدرسة التنمّر علينا، أصبحنا مجموعةً يحمي أفرادها بعضهنّ البعض بلا أدنى شكّ. وأحيانًا، عندما كنا نلعب كرة السلة في باحة المدرسة، كنتُ أشعر بأنّ باقي الفتيات يتهيّبن قوّتنا الجسدية والمعنوية، حتى أن البعض منهنّ بتنَ معجباتٍ ومهتماتٍ بنا، وأخذن ينظرن إلينا بطريقةٍ تشي بنوعٍ من الغزل؛ أمرٌ لم أفهمه سوى مؤخرًا.
اليوم، بعد سنواتٍ عديدة، أشكر جميع الآلهة على ضمّي إلى فريق كرة السلة ذاك، وأشعر بامتنانٍ دائمٍ لفريقي الذي بقي متضامنًا داخل النادي وخارجه. لا استطيع استعادة تلك المرحلة من دون الشعور بالحقد على مجتمعٍ يسعى إلى تعليب الأفراد وفرض الأدوار عليهم/ن، لكني أعتقد أنّها دفعتني أيضًا إلى اعتبار اختلافي مصدرًا لقوّتي، وعلّمَتني معنى الانتماء والتضامن والتعاضد بصرف النظر عن الاختلاف، ومدّتني بحبٍّ استطعتُ من خلاله تقبّل ذاتي كما هي بعد أن كنتُ أحاول تغييرها. كان اختلافُنا أساس الرابط المتين الذي بنيناه في ما بيننا وحمَينا بعضنا البعض من خلاله، فارضاتٍ وجودنا على ما حَولنا.
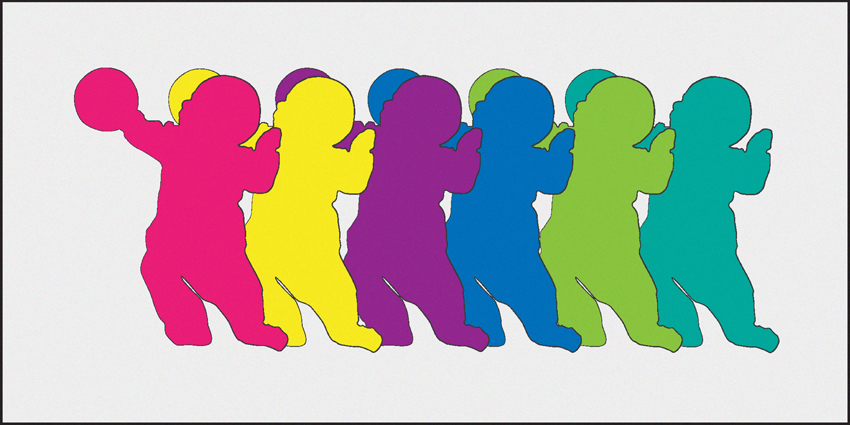
منذ بضعة أشهر، رُزق أخي بنتًا ستكبر يومًا ما. قد تذهب إلى المدرسة نفسها، وقد تهتم بممارسة كرة السلة أو أيّ نشاطٍ آخر. لا أستطيع سوى أن أتمنى لها أن تجدَ دومًا فريقًا أو مكانًا يشجع اختلافها ويُحيي ذاتها كما هي، لتكون فوق أيّ معيارٍ أو صورةٍ نمطيةٍ رُسِمت لها مسبقًا.
الرسومات لمنى
- 1عبارةٌ تنتشر في بلاد الشام وتُوجّه للفتيات ذوات السلوكيات "الصبيانية" أو الهويات الجندرية غير النمطية بقصد التنمّر والإساءة.



إضافة تعليق جديد